مثل هذا لا يَخرج ولا يُخرج
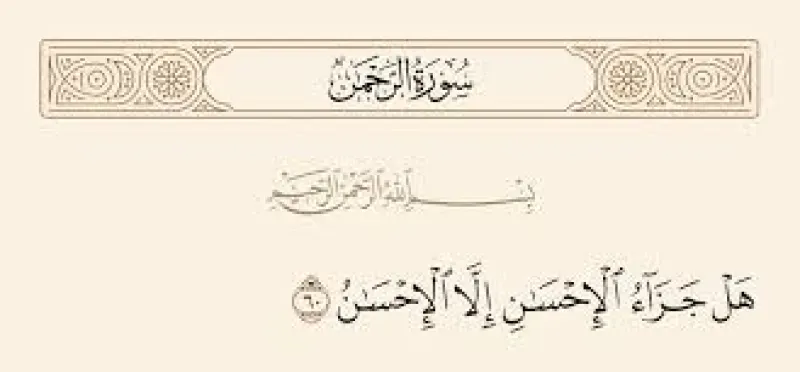
من السنن الكونية أن من يصنع الخير ويغرس البر، يحصد الخير، ومن ينشر الشر يحصد مثله، فالأعمال كالبذور، وما تزرعه اليوم تحصده غدًا، قال تعالى: {هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانُ} [الرحمن: 60].
ومن نشر السلام وصنع الخير؛ فإنما يزرع بذور الطمأنينة في القلوب، فيجد أثرها عاجلًا في صورة محبة الناس له، وتوفيق من الله، وراحة نفسية، وأمان اجتماعي، فضلًا عن الأجر العظيم في الآخرة.
حتى في قوانين الاجتماع البشري؛ من يزرع الثقة والحب يجني استقرارًا، ومن يزرع الشر يحصد خوفًا وبغضًا..
فالكون يسير وفق سنن ثابتة لا تتخلف ولا تتبدل، وضعها الخالق الحكيم لتكون ميزانًا يضبط حركة الحياة، ومن أعظم هذه السنن: أن الجزاء من جنس العمل، فهي سنة ماضية، لا يخرقها سلطان ولا قوة، ولا ينجو منها أحد؛ لأنها من مقتضيات العدل الإلهي الذي قامت عليه السماوات والأرض.
من يغرس بذور الخير في القلوب، ويسعى بين الناس بالبر والإحسان، فإنما يغرسها في أرض خصبة، وسيرى ثمارها عاجلًا أو آجلًا، قال تعالى: {إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: 7].
فالمحسن أول من يذوق ثمار إحسانه، فيجد السكينة في قلبه، والطمأنينة في حياته، وتفيض عليه البركات من حيث لا يحتسب.
وليس الخير قاصرًا على المال أو العطاء المادي، بل يشمل كل عمل يقرّب بين القلوب، ويشيع الأمن والسلام؛ من كلمة طيبة، أو ابتسامة صادقة، أو عفو عن زلة، أو ستر لعورة؛ فهذه الأعمال الصغيرة في نظر الناس، عظيمة عند الله، تجري في حياة صاحبها أنهارًا من السعادة والرضا.
وكما أن الخير يثمر خيرًا، فإن الشر لا بد أن يعود على صاحبه بالوبال؛ لأن الله جعل الأعمال كالبذور، فكما لا يمكن أن تزرع شوكًا وتحصد عنبًا، كذلك لا يمكن أن تزرع حقدًا وتقطف حبًا، أو تزرع فسادًا وتنتظر صلاحًا، قال الله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)} [الزلزلة: 7- 8].
فالكون قائم على التوازن، والعدل أصل في نظامه، فلا تستقيم الحياة إذا استوى المحسن والمسيء، ولا يمكن أن يثمر الشر سلامًا، ولا أن يثمر الفساد عمرانًا، فاقتضت حكمة الله أن يجعل للخير عواقب حميدة، وللشر عواقب وخيمة، ليكون في ذلك أعظم الدوافع للبر، وأقوى الزواجر عن الفساد.
انظر إلى تاريخ الأمم، تجد أن الظلم كان دائمًا بداية النهاية، وأن الطغيان لا يعيش طويلًا، بل يهوي بأهله إلى القاع، بينما تبقى آثار العدل والإحسان راسخة في ضمير الزمن، تشهد لأهلها بالفضل والذكر الجميل.
ومن أعظم الشواهد على هذه السنة ما شهدت به خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه الوحي أول مرة، فعن عائشة: قالت خديجة لزوجها صلى الله عليه وسلم: «كلا، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدًا، فوالله إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق» (1).
إنها شهادة صادقة من امرأة صالحة تدرك أن الله لا يخذل من جعل حياته كلها للخير، ومن بذر المعروف في كل درب، وهي زوجته ورفيقة دربه، وتعرف عنه ما لا يعرفه غيرها.
ومن أروع ما سجله التاريخ من شواهد هذه السنة ما قاله ابن الدغنة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه حين همّ بالهجرة من مكة: فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرًا قبل الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة، وهو سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي، فأنا أريد أن أسيح في الأرض، فأعبد ربي.
قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يَخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتُعين على نوائب الحق، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادك، فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر، فطاف في أشراف كفار قريش، فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلًا يكسب المعدوم، ويصل الرحم، ويحمل الكلَّ، ويقري الضيف، ويعين على نوائب الحق؟
فأنفذت قريش جوار ابن الدّغنة، وأمنوا أبا بكر، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصل، وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك، ولا يستعلن به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا (2).
إنها شهادة من مشرك بحق مؤمن، بأن مكارم الأخلاق حصن حصين، تحمي صاحبها حتى في زمن الفتن، وتجعل له مكانة ومنعة حتى بين خصومه، أليست هذه قمة العدل في سنن الله؟ أن يجعل الخير جنة واقية، وسياجًا منيعًا؟
وهذا يدل أن هذه القاعدة من السنن الكونية المتفق عليها بين الناس من زمن الجاهلية، وقد نظم المعنى الشاعر بقوله:
من يفعل الخير لا يعدم جوازِية لا يذهب العرف بين الله والناس
ومما يدل عليها في كتاب الله: قوله سبحانه وتعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77]، ويقول تعالى مادحًا أنبياءه: {إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ} [الأنبياء: 90].
وقال صلى الله عليه وسلم: «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مؤمن كربة؛ فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة» (3).
فمن سعى في قضاء حاجات الناس، سعى الله في قضاء حاجته، ومن فرّج عن غيره، فرّج الله عنه، وهذا عين سنة الله في المكافأة بالعدل والإحسان.
ومن أبلغ ما ورد في السنة النبوية في هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا؛ نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر؛ يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» (4).
فكل معروف تصنعه لغيرك، يرده الله إليك مضاعفًا، في أشد المواقف حاجتك فيها إلى الرحمة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
فالتيسير على الناس باب من أعظم أبواب البركة، ومفتاح للراحة في الدنيا والنجاة في الآخرة. فإذا وجدت أخاك في ضائقة، فكن له عونًا، يكن الله لك في كل أمر، وتذوق ثمرات هذه السنة الربانية: الجزاء من جنس العمل.
ويقول صلى الله عليه وسلم: «صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر» (5).
فأي فضل أعظم من أن تكون صنائعك اليوم سياجًا لك غدًا؟ وأعمالك الطيبة درعًا يقيك السوء؟ إنها سنن الله التي لا تتخلف، فمن يغرس البر، يحصد البر، ومن يزرع المعروف، يحصده في الدنيا قبل الآخرة.
قال علي رضي الله عنه: لا يزهدك في المعروف كفر من كفر، فقد يشكره الشاكر أضعاف جحود الكافر.
قال الماوردي: فينبغي لمن قدر على ابتداء المعروف أن يعجله حذرًا من قوته، ويبادر به خيفة عجزه، ويعتقد أنه من فرص زمانه، وغنائم إمكانه ولا يمهله ثقة بالقدرة عليه، فكم من واثق بقدرة فاتت فأعقبت ندمًا، ومعول على مكنة زالت فأورثت خجلًا، ولو فطن لنوائب دهره، وتحفظ من عواقب فكره، لكانت مغارمه مدحورة ومغانمه محبورة، وقيل: من أضاع الفرصة عن وقتها فليكن على ثقة من فوتها (6).
والمعروف هو ما يسديه العبد لأخيه من خير، فيقيه مصارع السوء أي يحفظ منها، وقد ينقطع الثناء على فاعل ذلك، لكنه لا ينقطع بينه وبين ربه، فصانع المعروف يختم له بخاتمة حسنة، ومن يختم له بذلك يكون عند موته بأحسن حال.
تقرح وجه أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك قريبًا من سنة، فسأل أهل الخير الدعاء له فأكثروا من ذلك، ثم تصدق على المسلمين بوضع سقاية بنيت على باب داره وصب فيها الماء فشرب منها الناس، فما مر عليه أسبوع إلا وظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه إلى أحسن ما كان (7).
وهذا السمت الصادق من الداعية يؤثِّر في سمته وهديه، فيرى عليه الناسُ دلائلَ الصدق والإخلاص قبل أن يتحدَّث أو يعظ أو يدعو لما يدعو إليه، ويُقَال فيه ما قاله عبد الله بن سلام- وكان من أحبار اليهود- يصف انطباعَه الأول عن الرسول القدوة حين رآه فيقول: عرفتُ أنَّ وجهه ليس بوجه كذاب (8).
ومن أخطر الاتهامات التي يوجِّهها المكذِّبون والمناوئون لدعوة الله، ويشهرونها في وجه الدعاة، ويشيعونها بين الناس لصدهم عن الدعوة والدعاة أن هؤلاء الدعاة يريدون من وراء هذه الدعوة تحقيقَ أغراضٍ ومصالح ومطامع، وليسوا مخلصين أو متجردين لها كما يزعمون: {بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ} [القمر: 25]: أي ليس كما يدعيه، وإنما يريد أن يتعاظم ويلتمس التكبر علينا من غير استحقاق.. {مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ} [المؤمنون: 24]، أي يسودكم ويشرف عليكم بأن يكون متبوعًا ونحن له تبع.
ومن كان يلاحظ تصرفات الرسول القدوة صلى الله عليه وسلم يستخلص منها أنه نبي صادقٌ، لا يبغي مُلْكًا ولا سلطانًا، فهذا عدي بن حاتم يقول: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق بي إلى بيته، فوالله إنه لعامد بي إليه إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته، فوقف لها طويلًا تُكلمه في حاجتها، قلت في نفسي: والله ما هذا بملك، ثم مضى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل بيته تناول وسادةً من أُدم محشوةً ليفًا فقذفها إليَّ فقال: «اجلس على هذه»، قلتُ: بل أنت فاجلس عليها، قال: «بل أنت» فجلست، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض، قلتُ في نفسي: والله ما هذا بأمر ملك (9).
وكانت التربية النبوية شديدة الاهتمام بتأكيد هذا الجانب لدى الصحابة الكرام حتى في دقائق الأمور وصغائرها:
عن سهل بن سعد قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملتُهُ أحبني الله، وأحبني الناس قال: «ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس» (10).
قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لما رأى عثمان بن مظعون رضي الله عنه ما فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء، وهو يغدو ويروح في أمان من الوليد بن المغيرة، قال: والله إن غدوي ورواحي آمناً بجوار رجل من أهل الشرك، وأصحابي وأهل ديني يَلْقون من الأذى والبلاء ما لا يصيبني لنقص كبير في نفسي، فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له: يا أبا عبد شمس وَفَتْ ذمّتك، وقد رددت إليك جوارك، قال: لم يا ابن أخي؟ لعله آذاك أحد من قومي، قال: لا ولكني أرضى بجوار الله عز وجل، ولا أريد أن أستجير بغيره، قال: فانطلق إلى المسجد فاردُد عليّ جواري علانية، كما أجرتك علانية، قال: فانطلقا ثم خرجا حتى أتيا المسجد، فقال لهم الوليد: هذا عثمان قد جاء يرد عليّ جواري، قال لهم: قد صدق، قد وجدته وفـيّـًا، كريم الجوار، ولكني قد أحببت ألا أستجبر بغير الله، فقد رددتُ عليه جواره، ثم انصرف عثمان، ولبيد بن ربيعة في المجلس من قريش ينشدهم، فجلس معهم عثمان، فقال لبيد: وهو ينشدهم:
ألا كل شيء ما خلا الله باطل
فقال عثمان: صدقت.
فقال: وكل نعيم لا محالة زائل.
فقال عثمان: كذبت، نعيم أهل الجنة لا يزول.
قال لبيد بن ربيعة: يا معشر قريش، والله ما كان يؤذى جليسكم، فمتى حدث فيكم هذا؟
فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه في سفهاء معه! قد فارقوا ديننا، فلا تجدن في نفسك من قوله.
فَرَدّ عليه عثمان حتى سرى- أي عظم- أمرهما، فقام إليه ذلك الرجل، فلطم عينه فخضّرها، والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان، فقال: أما والله يا ابن أخي إن كانت عينك عما أصابها لغنية، فقد كنت في ذمة مَنِيعة، فقال عثمان: بلى، والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله، وإني لفي جوار من هو أعزّ منك وأقدر يا أبا عبد شمس (11).
وهكذا كان فهم صحابته الأجلاء، وسلوكهم حتى مع إخوانهم وأحبائهم:
ومن طبائع الناس احترام ومحبة مَن يعفُّ عمَّا في أيديهم، ولا يتطلع لشيء مما لديهم، وازدراء والاستخفاف بمن يعيش عبئًا عليهم، ومَن لهم عليه فضلٌ ومنَّةٌ.
يقول الحسن البصري: لا تزال كريمًا على الناس ما لم تُعطَ ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك (12).
ويقول الماوردي: الاسترسال في الاستعانة تثقيل، ومن ثقَّل على الناس هان، ولا قدرَ عندهم لمهان.
وهذا نموذجٌ رائعٌ للداعية المتعفف، يضربه لنا الرجل الصالح عبد الله بن محيريز: دخل حانوتًا يريد أن يشتري ثوبًا، فقال رجلٌ لصاحب الحانوت: هذا ابن محيريز فأحسن بيعه.. فغضب وخرج وقال: إنما نشتري بأموالنا.. لسنا نشتري بديننا (13).
ترى هل يتعلم الدعاة من هذا النموذج، ولا يتساهلون في طلبِ الحوائج وقضاء المصالح من الناس، ويترفعون عن قبول الخدمات والهبات والهدايا، وحضور الولائم وإجابة الدعوات صيانةً لنفوسهم ومروءتهم، وحفظًا لسمعتهم مما يلصقه بها المستهترون والمناوئون؟
يجب أن يرى الناس أثرًا إيجابيًّا للدعوة والدعاة في حياتهم، أما السلبية والانطوائية وعزلة الدعاة عن الناس فلا يلقونهم إلا من خلال درس علمٍ أو محاضرة أو مقال في مجلة أو كتاب، فهيهاتَ أن تُبنَى ثقةٌ أو تُغرَس محبةٌ.
عن رافع بن أبي رافع الطائي: لما كانت غزوة ذات السلاسل قلت لأختارنَّ لنفسي رفيقًا صالحًا، فوفِّق لي أبو بكر، فكان ينيمني على فراشه ويلبسني كساءً له من أكسية فَدَك (14).
***
---------------
(1) أخرجه البخاري (4953)، ومسلم (160).
(2) أخرجه البخاري (2297).
(3) أخرجه مسلم (2442).
(4) أخرجه مسلم (2699).
(5) أخرجه الطبراني (8014).
(6) فيض القدير (4/ 206).
(7) الزواجر، لابن حجر الهيتمي (1/ 321- 322).
(8) أخرجه الترمذي (2485).
(9) سيرة ابن هشام (2/ 580).
(10) أخرجه ابن ماجة (4102).
(11) سيرة ابن هشام (1/ 370).
(12) حلية الأولياء (3/ 20).
(13) حلية الأولياء (5/ 138).
(14) الإصابة في تمييز الصحابة (2/ 367).
وكانت النتيجة الطبيعية لذلك هي الثقة الكاملة في هذا الداعي الموفَّق، والمسارعة للتلقي عنه، يقول رافع مكملاً حديثه: "فقلت له: علمني شيئًا ينفعني، قال: "اعبد الله ولا تشرك به شيئًا وأقم الصلاةَ وتصدَّق إن كان لك مالٌ، وهاجر دار الكفر، ولا تأمِّر على رجلين".
ولا تظن أن كونك داعيةً للناس ومعلمًا لهم أنَّ لك حقًّا عليهم أن تستريح وتستخدمهم؛ بل منزلتك هذه- لو أنصفت- تفرض عليك أن تتعب وتخدمهم، وهكذا كان الصالحون: قال أبو علي الرباطي: صحبت عبد الله الرازي وكان يدخل البادية، فقال: على أن تكون أنت الأميرَ أو أنا، فقلت بل أنت، فقال وعليك الطاعة، فقلتُ نعم، فأخذ مخلاةً ووضع فيها الزادَ وحملها على ظهره، فإذا قلتُ له أعطني، قال ألستَ قلتَ أنت الأمير؟ فعليك الطاعة، فأخذنا المطرُ ليلةً فوقفَ على رأسي إلى الصباح، وعليه كساء وأنا جالس يمنع عني المطر، فكنتُ أقول مع نفسي: ليتني مت ولم أقل أنت الأمير"
