صور من ظلم الدعوة
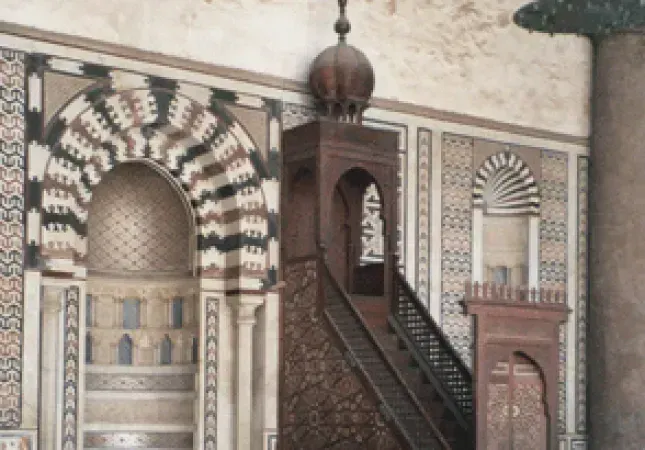
لقد عم الظلم وطغى وانتشر حتى أصاب الدعوة إلى الله تعالى، فعندما انتسب إليها من ليس من أهلها، وتجرأ عليها أدعياء وليسوا بأصفياء، لقطاء وليسوا من أصلابها، فظهرت صور كثيرة لظلم الدعوة وهضم حقها، ولعلنا نقف على بعض من هذه الصور والتي منها:
الصورة الأولى: تصدير الجهلة والسطحيين:
العلماء هم أولو الأمر في الأمة، يتعلم الناس منهم أمور دينهم، ويرجعون إليهم في الملمات والنوازل، ويصدرون عن رأيهم، ويقتدون بحسن سيرتهم وسلوكهم، فوجودهم من أسباب الخير والبركة، وموتهم من أسباب الشر والفتنة، فإذا ذهبوا ذهب العلم وأقبل الجهل، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله: «إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويُبثُّ الجهل، وتشرب الخمر، ويظهر الزنا» (1).
وكيف يكون رفع العلم ونسيانه، إنه يكون بموت أهل العلم وغربة أهله، كما بيَّن ذلك النبي فقال: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبق عالمًا اتخذ الناس رؤساء جهّالًا، فسُئِلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا» (2).
ولا شكَّ أن قلة العلماء، وانتشار الجهل بأمر الدين، وتصدُّر الجهال للدعوة والإفتاء أمر مشاهد ظاهر في هذا العصر، خاصة بعد انتشار وتيسر وسائل الدعاية والاتصال.
إن مما ابتلي المسلمون به في هذا الزمان تصدر أقوام للفتوى ممن قصر في العلم باعهم، يخوضون في نوازل عامة، وقضايا هامة، بلا علم ولا روية، فيخبطون خبط عشواء، ويأتون بما يضاد الشريعة الغراء، من الإفتاء والقول الله بغير علم، وتتبع الأقوال الشاذة التي لا يخفى على من له أدنى بصيرة مفاسدها الكبيرة على الدين.
رؤوس جهال، ضلوا وأضلوا، وزاد شررهم وعظم خطرهم في مواقع التواصل الاجتماعي ومنصاتها؛ وقنوات وفضائيات مشبوهة تفرح بباطلهم للإساءة للإسلام والمسلمين.
رؤوس جهال يأتون بزخرف قول يقلب الحرام حلالًا أو الحلال حرامًا، فأحلوا الربا الذي حاربه الله، وأحلوا بعض أنواع الخمر الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل ومنهم من أنكر السنة النبوية وأنكر ثوابت الدين.
فتاوى تُحل ما علم تحريمه من الدين بالضرورة، من دون حجة ولا برهان، بل مجاراة الواقع، ومداهنة وإرضاءً للخلق، وحظوظ النفس.
يقول ابن القيم: ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد على العِلم بما يبلغ، والصدق فيه، لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق؛ فيكون عالمًا بما يبلغ صادقًا فيه، ويكون مع ذلك حسن الطريقة، مرضي السيرة، عدلًا في أقواله وأفعاله، متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله، وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله، ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السَّنِيَّات، فكيف بمنصب التَّوقيع عن رب الأرض والسماوات؟!
فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به؛ فإن الله ناصره وهاديه، وكيف هو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب؛ فقال تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ} [النساء: 127]، وكفى بما تولاه الله تعالى بنفسه شرفًا وجلالة؛ إذ يقول في كتابه: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176]، وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه، وليوقن أنه مسؤول غدًا، وموقوف بين يدي الله (3).
ومما يدل على خطورة القول على الله تعالى بغير علم ولا أهلية لذلك قول الله تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [الأنعام: 144]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإِذا لم يُبِق عالمًا اتخذ الناس رؤساء جُهَّالًا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» (4).
ذكر أبو عمر بن عبد البر عن مالك قال: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة فوجده يبكي، فقال: ما يبكيك؟ أمصيبة دخلت عليك؟، وارتاع لبكائه، فقال: لا، ولكن اسُتفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم، قال ربيعة: ولَبعض من يفتي ها هنا أحق بالحبس من السُرَّاق (5).
قال الإمام ابن حزم رحمه الله: لا آفة على العلوم وأهلها أضرّ من الدُخَلاء فيها، وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون، ويظنون أنهم يعلمون، ويُفسدون، ويقدرون أنهم يُصلحون (6).
وقال الخطيب البغدادي: ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين، فمن صلح للفتيا أقرَّه، ومن لا يصلح منعه، ونهاه أن يعود، وتواعده بالعقوبة إن عاد (7).
قال ابن القيم: وكان شيخنا رضي الله عنه شديد الإنكار على هؤلاء، فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء: أجعلت محتسبًا على الفتوى؟ فقلت له: يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب؟ (8).
فينبغي لمن تصدى للتعليم والإفتاء أن يكون أهلًا لذلك، وإلا فهو خائن للأمانة، ينطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذا ضيِّعت الأمانة، فانتظر الساعة»، قيل: كيف إضاعتها؟ قال: «إِذا أُسند الأمر إِلى غير أهله فانتظر الساعة» (9).
قال ابن الحاج رحمه الله في كتابه "المدخل" بعد أن حكى من حال بعض المنتسبين إلى العلم ما لا يليق بهم: ولهذا المعنى كان سيدي أبو محمد -ابن أبي جمرة -رحمه الله إذا ذُكِر له واحد من علماء وقته ممن يُنسَب إلى طرف مما ذكر، ويُثْنَى عليه إذ ذاك بفضيلة العلم، يقول: ناقل، ناقل خوفًا منه رحمه الله على منصب العلم أن يُنسب إلى غير أهله، وخوفًا من أن يكون ذلك كذبا أيضًا، لأن الناقل ليس بعالم في الحقيقة، وإنما هو صانع من الصناع، كالخياط والحداد والقصار هذا إذا كان نقله على وجهه في الصحة والأمانة، وإلا كان دجالًا فيستعاذ بالله منه؛ لأن العلم ليس هو النقل ليس إلا، وإنما العلم ما قاله مالك رحمه الله ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم نور يقذفه الله تعالى في القلوب (10).
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفَّه الصغير الكبير (11).
المقصود أن من تصدر للدعوة وتحمل مسؤولية التعليم والتوجيه لا بدَّ أن يكون لديه أساس قوي من العلم الصحيح، وذلك بأن يكون طَلَب العلم على أيدي العلماء، وصارت لديه حصيلة ومعرفة جيدة، ورشَّحه أهل العلم للقيام بالدعوة والتصدر للخطابة والتدريس، أما أن يأتي من لم يطلب العلم على أيدي العلماء وطلبة العلم، بل من لم يطلب العلم أصلاً؛ يأتي الجاهل فيتصدر للدعوة وتوجيه الشباب والكلام في وسائل الإعلام، فلا شك أن هذه مصيبة كبرى، وهو من علامات الساعة، وسبب لأن يضل هذا الشخص في نفسه، ويكون سببًا لضلال غيره كما أخبر رسول الله: «فسُئِلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا».
قال أبو الحسن المؤدب:
تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس
فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس
لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس (12).
ونختم بكلام الإمام الشافعي رحمه الله حيث يقول: لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله، إلا رجلًا عارفًا بكتاب الله، بناسخه ومنسوخه، وبمحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، وما أريد به، وفيم أنزل، ثم يكون بعد ذلك بصيرًا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث ما عرف من القرآن، ويكون بصيرًا باللغة بصيرًا بالشعر، وما يحتاج إليه للسنة والقرآن، ويستعمل -مع هذا- الإنصات وقلة الكلام، ويكون بعد هذا مشرفًا على اختلاف أهل الأفكار، وتكون له قريحة (أي ملكة وموهبة) بعد هذا، فإن كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي (13).
الصورة الثانية: تجريدها من العلم وأخذها بعفوية:
لا يمكن أن تكون هناك دعوة إلا بعلم وأدلة الكتاب والسنة متضافرة في بيان ذلك، قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل واستدل بقوله تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ} [محمد: 19]، قال فبدأ بالعلم.
ومن الركائز الدعوية الهامة؛ البعد عن الشعارات الجوفاء: بإدراك الداعية أن التمكين للمشروع الدعوي الذي يحمله وضمان القبول للدعوة من طرف الآخرين، لا يكون بالهتاف الهائج ولا باللسان السليط ولا بالعواطف الطاغية ولا بالشعار المخدر؛ لأن من غذى نفسه وأتباعه بالشعارات حصد الأزمات، إنما يكون التمكين بالخبرة والقدرة والتفوق والاستبصار والحكمة والعمل النافع الجاد والوفاء الثابت والتضحية العزيزة، وهذا لا يستطيعه أصحاب الأماني الزائفة والخيالات الكاذبة؛ فالدعوة ليست طلقة فارغة تحدث دويًا ولا تصيب هدفًا، إنها نور في الفكر وزيادة في الخير وأصالة في العلم وهداية للحيارى ومحبة للآخرين وحرص وشفقة عليهم وكمال في النفس ونظافة في الجسم وسماحة في المعاملة ودماثة في الأخلاق، وإشعاع للجمال وإبداع في الإنجاز وصلاح في العمل ونظام يرفض الفوضى ونشاط يحارب الكسل وحياة وجد وجهاد في كل ميدان، وقبل ذلك ومعه وبعده إرضاء لله وحرص في ثوابه ورغبة صادقة في جنته.
- تراجعها تطويريًا وتجديديًا:
مع ضرورة مراعاة الثوابت والمتغيرات في الدين، فهناك أمور لها قابلية التطور في الإسلام، وأمور لا تتطور؛ بل تتحلى بالثبات، مثل: العقائد لأنها تقوم على اعتقاد الشيء حقًا أو باطلًا، وهذا لا تطور فيه، وكالأخلاق الأساسية للمجتمع، فالفضائل الأساسية لا يعيش مجتمع كريم بدونها مهما تطورت الحياة وتقدم العلم، والآداب الاجتماعية المرتبطة بالنظام العام للشريعة كنظام الأسرة ونظام الجنايات ونظام الحرب والسلم، فهذه كلها لها مبادئ عامة ثابتة في الإسلام مهما تغير الزمان والمكان، ومهما تبدلت الأوضاع والعادات.
وينبغي أن تكون أساليب الداعية ووسائلها متجددة، لأن مرونة الدين الإسلامي وصلاحيته لكل الأزمان تقتضي الدعوة بأسلوب العصر ولغته، وبمختلف الوسائل المشروعة التي تضمن نقل الإسلام وعرضه على الناس بأفضل طريقة وأوضح صورة، كما أن المتأمل في القرآن والسنة يجد فيهما الحث على استخدام كل ما يعين الإنسان على أداء رسالته في هذه الحياة، والداعية إلى الله أولى الناس بذلك.
والأصل في مشروعية التجديد قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» (14).
وتجديد دينها يضمن لها الثلاثة المحاور التي اصطلح عليها علماء الشريعة:
- فإما أن يكون التجديد في محور إزالة تراكمات الانحرافات التي وقعت على تعاليم الإسلام بفعل سلوكيات المسلمين.
- أو أن يكون التجديد بإزالة البدع والخرافات التي ابتدعت في هذا الدين وخيمت عليه بسبب سوء الفهم مثلًا.
- أو أن يكون التجديد في نشر محاسن الإسلام في باب العقائد وباب الأحكام وباب الأخلاق وباب المعاملات، وفي سائر جوانب الشريعة، ودعوة الناس للعمل به وامتثاله (15).
فتوى تحريم الطباعة:
هي فتوى تٌنسب إلى الدولة العثمانية في عدد من المراجع التاريخية؛ تجرم وتحرم الطباعة وخاصة الكتب الإسلامية وتسمح بها لغير المسلمين، بشرط عدم استخدام الحرف العربي.
فيما اتسعت في الأستانة المطبعة العربية، متخطيةً ما عوقت به من الحكومة ورجال الدين؛ إذ أفتى العلماء بأنها رجس من عمل الشيطان، ولكن فريقًا منهم عاون الصدر الأعظم في الحصول على إذن من السلطان، موقع عليه بالخط الشريف سنة 1712م بإنشاء المطبعة، وطبع جميع الكتب إلّا كتب التفسير والحديث والفقه والكلام منعًا للتحريف، ثم سُمح بعد ذلك بطباعة الكتب الدينية تحت إشراف مجموعة من العلماء.
وكذلك الأزهر الشريف قام بتحريم طباعة الكتب الشرعية؛ فقد أفتى بعض علماء الأزهر الشريف بتحريم طباعة الكتب الشرعية، قالوا: اطبعوا تاريخ، أدب، لغة، أما الكتب الشرعية لا تجوز طباعتها، هذا شفقة على العلم.
ولقد انطلق الإبداع الإسلامي في عصوره المزدهرة؛ لفتح العالم كله وتغييره؛ ليكون عالمًا إيجابيًا متحررًا من كافة أشكال الظلم، والعدوان، والضياع، والهوان. ولقد تنوعت الخطابات الدعوية في بداية عهد الإسلام، فكانت مضامين الخطاب الدعوي تتنوع لتناسب كل بيئة وعصر، فهناك تطورات طبيعية فطرية في الخطابات الدعوية، تلائم واقع كل بيئة، وواقع كل ما يجتمع بما يصلحه ويهذبه ويطوره.
وكما أن هناك علاقة واسعة تربط الدعوة بالإبداع؛ فالدعوة إلى الله ليست كلمات، أو شعارات، أو خطبًا، أو مؤلفات، وندوات تقال هنا وهناك، بل هي رسالة إصلاح شامل، يوظف الدين والدنيا وثورات الحياة وتقلباتها في العمل للآخرة؛ كي يحظى الإنسان بالخلود في النعيم الأبدي، ويسعد في الدنيا والآخرة، فالسعادة الأخروية تهون كل مصاعب الحياة لمن عاشوا في الدنيا غرباء.
إن الهزيمة الحقيقية التي تحدث بداخلنا وتقتل ذواتنا، عندما يغدو مبلغ طموحنا هو تقليد الآخرين وتبني أفكارهم، بحيث نحلق حول شخوصهم، ونبرع في تلقي الأفكار دون صناعتها، وفي استهلاكها دون القدرة على توليد أفكارنا الخاصة؛ فتتعطل حواسنا عن العمل، ويُقتل في ذواتنا القدرة على المبادرة والتجديد (16).
الصورة الثالثة: الامتنان بنشاط محدود:
إن بذل الإنسان الجهد والمال والوقت لقضاء حاجات الآخرين يعد نعمة كبيرة يهبها الله إياه، لا يفسدها سوى "المنّ" والشعور بالاستعلاء على المحتاجين، فالله الذي يعطي كل شيء من المال والقدرة والجاه، ولولا عطاء الله للإنسان لما استطاع أن يعطي أحدًا مثقال ذرة، وبذلك وجب عليه شكر الله لأنه سبحانه وفقه لتبوأ مكانة المعطين، بخلاف الكثيرين الذي رزقهم الله من فضله لكنهم استسلموا لسيطرة الشح والبخل على نفوسهم.
من هنا إذا رأى الفرد نفسه وقد تسامت على هذا الشح وأعطت مما أعطاها الله فتلك نعمة تستحق الشكر.
غير أن ما يجري في بعض الأحيان أن يصاب المرء المعطي بآفة الشعور بالاستعلاء وإشعار الآخرين بالحاجة، وذلك انطلاقًا من شعوره بأنه أعلى منهم وأن له فضلًا عليهم، إلى درجة يشعرهم بالذل و"المنّ" والفضل عليهم.
إن على المرء أن يراقب نفسه ويتوقى الوقوع في حالة "المنّ"، لأنها يمكن أن تمتد حتى إلى علاقته بالله تعالى، فآفة المن يمكن أن تدفع المرء للجرأة على رب العالمين، بحيث يمنّ على الله بأعماله وعباداته من حج وصلاة وصوم، وقليل من التفكر للإنسان يدرك به أنه لو جمع كل صنيع الخير فلن يوازي ذلك واحدة من أنعم الله عليه، ولذلك يتحدث القرآن الكريم عن أولئك الذين كانوا يمنون على رسول الله إسلامهم بالقول {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ} [الحجرات:17]، من هنا على المؤمن أن يتعود دائمًا على الشكر حينما يتوفق لعبادة سيما الصلاة، أن سجدة الشكر ليست جزءًا من الصلاة، ولا هي واجبة، ولكن يستحسن التعود عليها حتى يتعود على شكر الله تعالى على توفيقه له لأداء هذه الفريضة، وهكذا الأمر بإزاء كل عبادة وكما ورد في ما حكاه الله تعالى على لسان عباده المؤمنين: {وَقَالُوا الْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللهُ} [الأعراف: 43].
قال أبو حامد الغزالي: ورجل ثالث استحوذ عليه الشيطان؛ فاتخذ علمه ذريعة إلى التكاثر بالمال، والتفاخر بالجاه، والتعزز بكثرة الأتباع، يدخل بعلمه كل مدخل رجاء أن يقضى من الدنيا وطرهن وهو مع ذلك يضمر في نفسه أنه عند الله بمكانة، لاتسامه بسمة العلماء، وترسمه برسومهم في الزي والمنطق، مع تكالبه على الدنيا ظاهرًا وباطنًا.. فهذا من الهالكين، ومن الحمقى المغرورين؛ إذ الرجاء منقطع عن توبته لظنه أنه من المحسنين، وهو غافل عن قوله تعالى: {يَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوْا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ} [الصف: 2] (17).
الصورة الرابعة: العطاء الجزئي لها:
«تجدون الناس كإبل مائة، لا يجد الرجل فيها راحلة» (18)، بهذه الكلمات الموجزة البليغة، وصف النبي صلى الله عليه وسلم حال ركب الدعاة في كل عصر، وإن كانت كلماته صلى الله عليه وسلم تلك تنصرف على الناس في كل أحوالهم ومجالات حياتهم، إلا أنها بحال الدعوة ألصق، وبمجال العمل في سبيل الله عز وجل أوثق.
يقول اللغويون في تعريفهم للراحلة: هي البعير النجيب المختار، كامل الأوصاف، الحسن المنظر، القوي على الأحمال والأسفار، وإذا كان في إبل عرف، لقلته وندرته.
والرواحل من الدعاة تجدهم كذلك فعلًا، فهم نجباء مصطفون، يقتربون من الكمال، حَسُنت ظواهرهم التي تشي بحسن باطنهم، تجد منهم –وإن كان في بدنهم ضعف– القوة والجلد على حمل أعباء الدعوة، والقيام بها على أفضل ما يكون، لا يعرفون تعللًا ولا اعتذارًا، وليس في قاموسهم القعود ولا النكوص، يُعرفون في جموع الدعاة ويبرزون كعلامات وشامات، دون إعلان عن أنفسهم، يشقون للدعوة، ويمدونها بعصارة نفوسهم.
وليت هؤلاء الرواحل من الدعاة يحملون أنفسهم وأحمالهم هم فقط، ويؤدون واجباتهم هم فقط، وإنما الواقع أنهم في الأغلب الأعم – لتخاذل البعض وتكاسله وتوانيه – ينوءون أيضًا بحمل غيرهم وأثقالهم، وأداء واجبات هؤلاء الأغيار من الغثاء المحمول.
وليت هؤلاء المحمولين اكتفوا بإلقاء أحمالهم وساروا على أرجلهم، فكفوا الرواحل أنفسهم، ولكن هذا الصنف يأبى إلا أن يركب ويتصدر، دون أن يكلف نفسه جهدًا، ولا نفقة من وقت أو مال، مطلقين ألسنتهم الحداد بالسوء من القول في حق من يحملونهم، إن توجع هؤلاء الرواحل أو صدر عنهم الأنين من ثقل ما يحملون.
هذا صنف، وهناك صنف آخر من المحمولين، لا يقل خطرهم عمن ذكرنا أولًا، وهم لا شك يمثلون عقبة في طريق الرسالة، وثقلًا فوق ظهور الرواحل، إنهم صنف قبع خلف أسوار نفسه، واستراح في ظلال الدنيا، تجدهم يحملون ألقاب الدعاة، مكتفين بشرف الانتساب، ولا يملون من التغني ليل نهار بهذا الشرف، ولسانهم لا يمل من الثناء على المثل العليا من الدعاة والمصلحين في الماضي والحاضر، وحكاية ما يبذلون ويقدمون، دون أن يؤدوا ما يفرضه عليهم هذا الانتساب الشريف من تبعات، باذلين الأعذار الواهية، والحجج المائعة، متواكلين على أن هناك غيرهم من الدعاة من يقومون بالمهمة دونهم، فهناك من يفكر عنهم، ويقرر عنهم، بل وينفذ عنهم، عطلوا عقولهم، وأنكروا قلوبهم، وشلوا جوارحهم، وأخرسوا ألسنتهم إلا عن مهاجمة من يريد تحريك ساكنهم، وإحياء مواتهم، وتنبيه حواسهم، متهمين إياه بالاندفاع تارة، وبضعف ثقته بالقيادة والمنهج تارة أخرى (19).
ولا شك أن ظاهرة «المحمولين» تؤثر تأثيرًا بالغًا وخطيرًا على سير العمل الدعوي، وعلى إنتاجه، وعلى أفراده أيضًا، ومعرفة بعض هذه الآثار قد يدفعنا للسعي الحثيث لتجنبها بعلاج هذه الآفة في الحق الدعوي، ومن أهم هذه الآثار:
1- إعاقة إخوانهم من الدعاة الرواحل، وعرقلة جهودهم، وإبطاء سيرهم، والحد من قدرتهم على الاستمرار بأحمالهم الزائدة.
2- إشاعة العدوى بين الدعاة، فقد ينقل هؤلاء المحمولون آفتهم إلى إخوانهم من الدعاة المخالطين، ممن ضعفت مناعتهم، وفترت هممهم، فيصيرون قدوة للكسالى وفاتري الهمم.
3- تضييع الأوقات واستهلاك الطاقات في حل ما يثيره هؤلاء الأفراد من مشكلات، مما لو أنفق بعضه في الدعوة لحققت إنجازات قيمة ونجاحات طيبة.
أسباب هذا الخذلان:
1- الوهن القلبي، بحب الدنيا، والغفلة عن الموت والاستعداد له.
2- فساد النية عند المنتسب للدعوة، باتخاذها إما كوظيفة ينال عن طريقها المال، أو كوسيلة للظهور والشهرة، أو لاكتساب وجاهة اجتماعية، فأمثاله يريدون الدعوة أن تخدمهم، لا أن يخدموها هم، ويعيشون عليها لا لها، مثلهم كمثل الطفيليات التي تتغذى على غيرها، فهم في الدعوة وليسوا منها، والدعوة عندهم – كما يقول الدكتور فتحي يكن: كالزهرة يضعونها في عروة ردائهم، مصدرًا للجمال، يلفتون بها الأنظار، وينتزعون بها الإعجاب، فإذا ذبلت رموها، وبحثوا عن وردة جديدة أو دعوة جديدة، هم الذين يحرصون على أن يُنتخَبوا في كل مجلس إدارة، وأن يمثلوا في كل وفد، وأن يحضروا كل اجتماع.
3- تشوش الرؤية، وافتقاد الوجهة، والجهل بطبيعة طريق الدعوة، ومتطلبات السير فيه، والتضحيات الواجبة على سالكه.
4- انشغال الفرد بأعماله الدنيوية انشغالًا مبالغًا فيه، والنهم في جمع المال، والغرق في تلبية ملذاته وشهواته، وانتقال هذا بتأثير متبادل إلى أهله وذريته {إنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ} [التغابن: 15].
5- تأثير البيئة التي ينحدر منها الداعية، وطبيعة النشأة الأسرية والمجتمعية، وما تؤصل فيه من طباع سلبية، كل هذا قد يترك أثرًا في الداعية حتى بعد انتسابه للدعوة، ويأخذ وقتًا طويلًا وجهدًا جهيدًا لعلاجه منها.
6- استعجال المربين في الحكم على المبتدئ، من خلال مواقف ومعايشات سطحية، واختبارات تمثيلية غير حقيقية، مما يؤدي إلى الزج به في أعمال ومسئوليات هي أكبر منه، قبل إنضاجه جيدا، وإكمال تربيته.
ولا شك أن هذه الأسباب كلها منشؤها واحد، وهو ضعف التربية الأولية التي يتلقاها الداعية في بداية ارتباطه بهذه الدعوة، وإهمالها لصالح الأعمال والإداريات، وعدم توفر المربي الكفء الذي يربي الدعاة على نهج سليم، فيقوم بالمهمة أناس إما أدعياء، وإما مساقون مضطرون، أو اضطرت الدعوة إليهم، فألقت بهم لاحتلال مواقع المربين، وهم للتربية أحوج، فيؤصلون في الأفراد قيما فاسدة، ويعطون من أنفسهم قدوات معيبة (20).
أعراض ومظاهر:
فإذا توفرت هذه الأسباب أو البعض منها، تبدأ الأعراض في البروز، وهي مؤشرات ينبغي أن يلتفت إليها المربون ليتعاملوا معها مبكرًا قبل استفحالها وتمكنها من الداعية، ومن هذه الأعراض:
1- خفة الهمّ الدعوي، وعدم استشعار عظمة ما يحمل من رسالة، فالدعوة وشئونها لا تحتل مكانا في قلب (المحمول) ولا في عقله، فلا نجده يتأثر إيجابًا بنجاح تحققه، أو بفتح قامت به، ولا سلبًا بإخفاق تتعرض له أو بمحنة تبتلى بها.
2- عدم اتقان واجباته الدعوية، هذا إن قام بها أصلًا، فضلًا عن إهماله وتخليه عن الكثير منها بالكلية.
3- الاتكالية والسلبية، وافتقاد الذاتية، فهو لا يتحرك إلا بتكليف، ولا يعمل إلا حرجًا من المحاسبة.
4- إعطاء الدعوة فضول الأوقات، وفضول الطاقة، وفضول المال، والدعوة لا تقتات أبدا بالفضلات، وتأبى إلا أن تطعم بالمكارم والنفائس {لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92].
5- كثرة الأعذار الواهية والحجج الباطلة في التخلف عن أداء تكاليف الدعوة، يسوقونها بينهم وبين أنفسهم، أو يتعللون بها للناس تخلصا من المعاتبة والمحاسبة.
6- كثرة النقد بحق وبدون حق، والتنظير الدائم دون عمل، وتلمس العيوب والأخطاء والمثالب، وتضخيمها، دون اقتراح حلول أو بدائل.
7- رفض النصيحة، والغضب من التذكير، وضيق الصدر من العتاب.
8- الاستشراف للقيادة، وحرصه عليها، وطلبه إياها دون امتلاكه لمقوماتها، والقعود والإهمال إن تولاها غيره.
9- الجزع عند الابتلاءات، والانهيار السريع أمام الفتن والمحن، {ومِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ولَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ العَالَمِينَ} [العنكبوت: 10].
10- المن على إخوانه الدعاة وعلى دعوته بالقليل الذي قد يقدمه، وتضخيم أعماله وإن كانت هينة، وهي في أغلبها هينة (21).
يقول صلى الله عليه وسلم: «بلغوا عني ولو آية» (22)، لم يدع فرصة لكسول ولا لخامل ولا لتنبل ولا لبطال: «بلغوا عني ولو آية» ألا فليكن الوجود للإسلام، والرسالة الإسلام، والهوية الإسلام، له نحيا وبه نحيا وعليه نموت، حزننا لله وغضبنا لله ورضانا لله حياتنا لله ومماتنا لله، لسان حال الواحد منا:
قد اختارنا الله في دعوته وإنا سنمضي على سنته
فمنا الذين قضوا نحبهم ومنا الحفيظ على ذمته
ها هو صلى الله عليه وسلم يحمل هم هذا الدين ويثقل الهم به حتى يواسيه ربه سبحانه وتعالى بقوله: {فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ} [فاطر: ٨].
الصورة الخامسة: تفعيلها في إطار حزبي، أو مذهبي أو فكري، وحرمان الكفاءات من المشاركة:
لا شكَّ أنَّ تفرق المسلمين وتقطعهم فرقًا وأحزابًا مما يُطمع عدوَّهم فيهم، ومما يُضعف كيانهم وكلمتهم، ومما يُسبب خذلناهم عند اللِّقاء، قال الله سبحانه: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} [آل عمران: 103]، وقال: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} [الأنعام: 159]، وقال تعالى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ} [آل عمران: 105]، في آياتٍ كثيرة يحثّ فيها سبحانه على الاجتماع والتَّعاون والتَّرابط، ويُحذّر من الاختلاف والتَّفرق، ويقول سبحانه: {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} [الأنفال:46].
فالمسلمون إذا اجتمعوا على كلمةٍ واحدةٍ، وتعاونوا على البرِّ والتَّقوى، وتناصحوا؛ صار ذلك أعظم سببٍ لنصرهم وحمايتهم من مكايد عدوهم، وصار أعظم سببٍ لهيبة عدوهم منهم، وعدم الإقدام على ما يُسبب قيامهم عليهم، وثورتهم ضدهم، كالحبال إذا اجتمعت والعصي إذا اجتمعت لم يستطع قطعها ولا كسرها وهي مُجتمعة، فإذا تفرَّقت عصًا عصًا، وحبلًا حبلًا؛ سهل قطعها وكسرها.
وهذه الجماعات والأحزاب يصعب القضاء عليها، لكن يجب أن تنقاد لأمر الله، ويجب أن تُؤثر طاعة الله، وأن تُعين كلُّ واحدةٍ الطائفة الأخرى على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هدفهم واحدًا، وهو الاستقامة على دين الله، وتنفيذ أحكامه، وترك ما خالف شرعه، فإذا اتَّحدت كلمتهم على هذا وتعاونوا على هذا لم يضرّهم تنوع الجمعيات، أو تنوع الأسماء، إذا اتَّحدت الأهدافُ، وتضافرت الجهود، وصار هدفُهم واحدًا، ومقصودهم وحدًا، وهو تحقيق طاعة الله ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله (23).
وتتوالد عن ظاهرة التعددية آفات كثيرة وخطيرة أبرزها آفة التعصب للتنظيم أو الحزب أو الجماعة أو الحركة، وقد تتفاقم هذه الآفة فتعمي وتصم، وبدلًا أن يكون التعصب للحق والنزول عند حكم الشرع هو الأساس، يحل محله التعصب للتنظيم ولأشخاص التنظيم ولسياسة التنظيم، وبدل أن تكون الدعوة للإسلام تصبح الدعوة إلى التنظيم ولو من غير إسلام وبدون التزام، إن ظاهرة التعصب لهذه الفئة أو تلك بدعة خطيرة وانحراف مريع في التفكير والتصور والسلوك والتربية، إن هذا لا يعني رفض الانتماء للتنظيمات والحركات– حسب زعمه– إنما المطلوب أن يكون الانتماء للإسلام قبل التنظيمات، وأن يكون الولاء لله قبل الأشخاص، وأن يكون الالتزام بشرع الله قبل الانتظام بالنظم والدساتير الإدارية.
إن من واجب العاملين للإسلام أن يكونوا مسلمين أولًا، أما إن سبق هذا ذاك، وطغى الحس الفئوي على الحس الإسلامي، وقوي الشعور الحزبي؛ وضعف الشعور الإيماني، وقع الخلل وتقطعت أوصال المسلمين، وتحقق فيهم قول الله تعالى: {وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32)} [الروم: 31- 32].
والعصبية نقيض الوحدة؛ لأنها تمزق الساحة الإسلامية، وتقيم السدود بين المسلمين، فهل يتفق هذا مع قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا} [آل عمران: 103].
الصورة السادسة: الاعتناء بالكم على حساب الكيف والنوعية:
من الأولويات المهمة شرعًا: تقديم الكيف والنوع على الكم والحجم، فليست العبرة بالكثرة في العدد، ولا بالضخامة في الحجم: إنما المدار على النوعية والكيفية.
إننا مولعون بالكم وبالكثرة في كل شيء، وإبراز الأرقام بالألوف والملايين، ولا يعنينا كثيرًا ما وراء هذه الكثرة، ولا ماذا تحمل هذه الأرقام.
والقرآن ذكر لنا كيف انتصر جنود طالوت، وهم قلة على جنود جالون وهم كثرة: {فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاقُوا اللهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} [البقرة: 249]، إلى أن قال: {فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللهِ} [البقرة: 251].
وذكر لنا القرآن كيف انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بدر، وهم قلة على المشركين وهم كثرة كما قال تعالى: {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [آل عمران: 123]، {وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ} [الأنفال: 26].
على حين كاد المسلمون يخسرون في حنين، إذ نظروا إلى الكم لا الكيف وغرتهم الكثرة، وأهملوا القوة الروحية، والحيطة العسكرية، فدارت الدائرة عليهم أولا، حتى يتعلموا وينتبهوا أو يتوبوا، ثم فتح الله عليهم وأيدهم بجنود لم يروها.
يقول الله تعالى: {لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ (25) ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ (26)} [التوبة: 25- 26].
ولقد بين القرآن أن الإنسان إذا اجتمع له الإيمان وقوة الإرادة المعبر عنها بالصبر، يمكن أن تتضاعف طاقته إلى عشرة أضعاف أعدائه ممن لا يملك إيمانه وإرادته: يقول تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ} [الأنفال: 65].
الصورة السابعة: أداؤها في شكل مؤسسي فوضوي، أو مترهل، لا يراعي أولوياتها وفقهها الرفيع:
إن المتأمل في هذا الكون الفسيح يرى جليًا كيف أن الخالق سبحانه وتعالى أبدعه وسيره في نظام دقيق مذهل لا مكان فيه لفوضى أو اضطراب، قال تعالى: {وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا} [الفرقان: ٢]، ولقد أعطى الله سبحانه وتعالى للإنسان الحرية في أن يتصرف في حياته كما يشاء، ابتلاءً واختبارًا له، فمن الناس من يوفق لتنظيم شأنه وتحقيق أهدافه، فيكون بذلك موافقًا لنظام هذا الكون، ومنهم -وهم الأكثر- من يعيش في فوضى عارمة مخالفًا بذلك ناموس الكون، فوضى مصيرها الفشل والضياع والاضطراب وقلة الإنتاج وضآلة العطاء، وربما الغرق في بحور اليأس والإحباط والتوتر والقلق حين يرى الفوضوي الناجحين من حوله وقد تقدموا نحو أهدافهم بينما ما زال هو لم يراوح مكانه.
الفوضوية اضطراب سلوكي مدمر، فلا هدف محدد، ولا عمل متقن، بل أعمال ارتجالية، يبدأ الفوضوي في العمل ثم يتركه، ويشرع في غيره ولا يتمه ثم في آخر ولا يستسيغه، وهكذا، فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى.
ومن أشهر مظاهر الفوضوية في حياتنا: غياب المنهجية في التصرفات، والاهتمام بالفروع دون الأصول، والانشغال بالمهم عن الأهم، وإعطاء العمل البسيط فوق ما يستحق من الجهد والوقت، تضيع الساعات الطوال دون عمل نافع ومثمر، قتل الوقت بأمور تافهة، تراكم أكثر من عمل في وقت واحد، الفوضوية حتى في الصحبة وسائر العلاقات الاجتماعية.
وجماع هذا الأمر هو تشوش الذهن، واضطراب التفكير والتخطيط، مع غبش الرؤية المستقبلية، فما نستحسنه اليوم قد لا يروق لنا الغد، وما نراه الآن صوابًا ربما نراه بعد لحظات خطأ، إن الفوضوية الفكرية لا تعني ترك أمر كنا استحسناه ثم اكتشفنا سلبياته لاحقًا، فهذا سلوك لا غبار عليه، لكن الفوضوية التي نعني هي: تغيير المواقف دون وجود أسباب واضحة لذلك، وإنما هي المزاجية المتقلبة لا أكثر ولا أقل.
أضرار الفوضى وأخطارها:
- إضاعة وتبديد الأوقات: والوقت يُسأل عنه الإنسان، يُسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، الفوضوي لا يشعر بمرور الزمن، فما إن يهم بأمر إلا وتراه ينقلب إلى غيره، وهكذا حتى يذهب عمره وهو لم يحصل شيئًا، فهو يعيش عقوقًا لوقته، كما قال أحد الحكماء: من أمضى يومًا من عمره في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد أثله، أو حمد حصله، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه، فقد عق يومه وظلم نفسه.
- انعدام أو قلة الإنجازات: الفوضوي قلما ينجز عملًا، يقرأ كتابًا ويقف، يحضِّر درسًا وينقطع، يشرع في الحفظ ويمل، لا يعرف الإنجاز ولا الثمرة، وحتى إذا أثمرت أفعاله أحيانًا فإنها تكون ثمرات قليلة أو ضعيفة، لذلك فمن أسوأ الآثار وأخطر الأضرار للفوضى غياب الإنجازات.
- الإحباط والفشل: الفوضوي لا يرى ثمارًا تشجعه على مواصلة الطريق، ومن ثم تكون نهايته الفتور والانقطاع، حيث ينظر إلى سنوات عمره التي قضاها في عشوائية، فيشعر أن العمر قد ضاع، والمستقبل -كما يقولون-: أصبح في خبر كان، فينتابه الخوف والإحباط، والشعور بالفشل، والاتهام للنفس، والنقد الشديد لذاته، فهو مزعزع الثقة في نفسه، قد سُدت في وجهه أبواب الأمل، وانقطع لديه الطموح إلى المستقبل.
- العجز والكسل: نتيجة للإحباط يشعر الفوضوي أنه عاجز رغم توفر طاقاته وإمكانياته، يميل إلى الكسل ما دام قد مرت هذه السنوات ولم ينجز في عمله، لم ينجز في تربية أبنائه، لم ينجز في تحقيق آماله، لم ينجز في سياسته الاقتصادية.
- فقدان المواهب والملكات: لأن الذي يبدأ في شيء يحسنه ثم يتركه إلى غيره، يختلط عليه الأمر، وشيئًا فشيئًا تضمر مواهبه، فالموهبة تتطور وتنمو بالممارسة وبتغذيتها علميًا وعمليًا، أما الفوضوي فإنه تدريجيًا –ودون أن يشعر- تتلاشى مواهبه، وتضيع منه ملكاته، ويخسر هذه النعم التي ربما كانت فيه أمرًا فطريًا وجبليًا.
- ضياع الأهداف والغايات: الفوضوي ليس عنده هدف ولا غاية؛ لأنه: متردد، متحير، متغير، متنقل، وبالتالي لا يكون عنده وضوح في الأهداف والغايات.
- ضعف الثقة وسوء السمعة: ضعف ثقة الفوضوي بنفسه، تكسبه سمعة سيئة بين الناس، فإذا جاء أحد ليتعاون معه قيل له: لا تتعاون معه؛ فإنه فوضوي، لا تعتمد عليه؛ فإنه اتكالي، لا تعوّل عليه؛ فإنه ارتجالي، إلى آخر هذه الأمور.
في صور أخرى كثيرة لا تنقضي، والمهم هنا أن الدعوة نحتاج إليها، وليس هي من تحتاج إلينا، لأنها نعمة الله علينا، ونوره وهدايته، كما قال تعالى: {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ} [محمد: 17]، وقال: {بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [الحجرات: 17]، وكما قال رجل للإمام أحمد رحمه الله: جزاك الله عن الإسلام خيرًا، فقال: بل جزى الله الإسلام عني خيرًا (24).
والدعوة كمفازة وسيعةِ لا حد لها، إذا سار فيها المرء بلا دليل أو برهان، ضل وزادت حيرته، واشتدت متاعبه، والوالج للدعوة بلا علم ونور، لا يبرح يزيد تخبطه، وتتعاظم أخطاؤه، ومن ثم يقع في ظلمها.
ولذلك كان العلم الشرعي المتين كالنور الوضاء في الدياجي الملتبسة، والأحوال المختلطة، والحائل دون الوقيعة في الأخطاء الدعوية، التي هي تجسيد لصور الظلم الدعوي، فعلمك ووعيك يجعلك بعينين بصيرتين، تميز وتعي وتتقي.
وإلا فما قيمة العلم حينئذ؟! وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلمُ!!
العلم المستنير، والمستقى من مصادر سليمة، وعلى أيدي أشياخ معتبرين، ضمان الحراك الدعوي الصحيح، الذي يوقر الدعوة، ويحفظ لها مساراتها وممارساتها، فلا ضيق أو تخلف أو تحزب؛ بل وعي وإدراك وتجديد.
تنتهي إلى ديمومة دعوية واصلاحية، لا تزال تسمو وترتقي، وتأبى كل صور التخلف والرجوع والسخف.
لأن الدعوة يصدق عليها كممارسة جمالية لآداب الاسلام، وأي إساءة أو تشويه وتسطيح، من شأنه أن يصد عن سبيل الله، ويعكس صورة لا يرتضيها جميع العقلاء.
والمتعين تعلمه هنا؛ أن الدعوة علم عتيق أصيل، مثله مثل التفسير والحديث واللغة، يجب تعلمه والسهر عليه، وليس كلأ مباحًا يطرقه كل الناس كما هو شائع للأسف الشديد، فلا بد له من كليات ومراجع ودورات للتأهيل والتدريب، تفعل للتعليم والتزكية، وليس للترويح والاستمتاع (25).
----------
(1) أخرجه البخاري (80)، ومسلم (2671).
(2) أخرجه البخاري (100)، ومسلم (2673).
(3) إعلام الموقعين (1/ 9).
(4) أخرجه البخاري (100)، ومسلم (2673).
(5) بدائع الفوائد (3/ 277).
(6) رسائل ابن حزم (1/ 345).
(7) المجموع شرح المهذب (1/ 41).
(8) إعلام الموقعين (4/ 167).
(9) أخرجه البخاري (6496).
(10) المدخل لابن الحاج (1/ 17).
(11) جامع بيان العلم وفضله (1/ 617).
(12) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (16/ 10).
(13) تعظيم الفتيا لابن الجوزي (ص: 70).
(14) أخرجه أبو داود (4291).
(15) التجديد مفهومه وضوابطه/ إسلام ويب.
(16) الدعاة وصناعة الإبداع/ صيد الفوائد.
(17) بداية الهداية (ص: 27).
(18) أخرجه مسلم (2547).
(19) المحمولون على طريق الدعوة/ منتديات رواحل.
(20) المصدر السابق.
(21) المحمولون على طريق الدعوة/ رواحل.
(22) أخرجه البخاري (3461).
(23) واجب العلماء تجاه الحزبيات والتَّعصبات/ موقع ابن باز.
(24) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5/ 331).
(25) صور ظلم الدعوة/ صيد الفوائد.
