بين العلم الشرعي والثقافة العامة
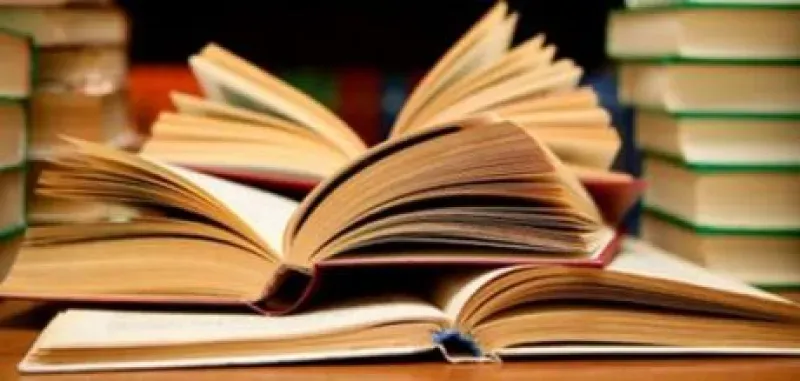
للعلم الشرعي أهمية كبرى في الإصلاح، وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالعلم، وحث عليه، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليه، وكان سلف الأمة يتميز بالاهتمام بالعلم، والاشتغال به، والعناية بتحصيله، ونحن أحوج ما نكون إلى العلم الشرعي، لا سيَّما في مثل هذه الأوقات، وفي مثل هذه الأزمان، التي انتشر فيها الفساد العقائدي والأخلاقي إلى درجة كبيرة، فالعناية بالعلم أمر مهم جدًا بالنسبة للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى.
فالدعوة إلى الله عز وجل تسير في طريقين: طريق العلم أو التأصيل العلمي، وطريق الوعظ، والوعظ يلزم عامة الناس، وأما العلم فيلزم خاصة الناس، وعلى أية حال التأصيل العلمي هو الذي يربي الشخصية العلمية المسلمة الواعية الفاهمة.
وأما الوعظ فسرعان ما يزول أثره من القلوب؛ بل ربما في مجلس الوعظ نفسه يزول الأثر، فكثير من الناس يسمع درس الوعظ أو الخطبة أو غير ذلك، ثم على باب المسجد ينفض ثوبه كأنه يقول: هذه بضاعتكم ردت إليكم، وقد جربنا مرارًا أن كثيرًا من المستمعين أو الحاضرين يسمع الخطبة أو الدرس أو غير ذلك ثم يخرج، فإذا سألته عما سمع كأنه لا يعرف شيئًا، غير أنه تأثر من هذا الدرس؛ حتى إن هذا الدرس أبكاه، لكن لو سألته: كيف بكيت؟ ولمَ بكيت؟ فإنه لا يدري.
يقول الله سبحانه وتعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ} [محمد:19]، ويقول سبحانه وتعالى: {شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [آل عمران:18]، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»(1).
فالفقه في الدين علامة على إرادة الله سبحانه وتعالى لصاحب العلم الخير، فهو يعلم الإنسان صحة عقيدته وصحة عمله، ويعلمه الأخلاق والآداب الفاضلة، وكذلك يعلمه كيفية تصحيح عقائد الناس، وكيفية تصحيح أعمالهم وأخلاقهم وأهدافهم، والدعوة إذا خلت من العلم فهي دعوة فاشلة وباطلة؛ لأنها ستكون من البدع، وسيدعو صاحبها إلى البدع والضلالات والانحرافات، وكما وقع في تاريخ المسلمين من أشخاص ينتسبون إلى الدعوة، ويشتغلون بها، فلما اشتغلوا بها على غير بصيرة وعلى غير علم شرعي وقعوا في البدع وفي الضلالات.
إن أول شِرك وقع فيه الإنسان كان بسبب نسيان العلم، وظهور الجهل، فوقع الشرك في أول أمة شركية، وهم قوم نوح، ثم بعد ذلك جاء التوحيد على يد نوح عليه السلام، ثم بعد ذلك وقع الشرك وهكذا، حتى جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأظهر التوحيد والتزمت به هذه الأمة.
فالعلم الشرعي له أهمية كبرى في الإصلاح وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبين الدعوة وبين العلم ارتباط كبير جدًا، وقد عني السلف الصالح رضوان الله عليهم بعلم العقيدة بالذات؛ وسبب ذلك أن علم العقيدة هو الذي يُبنى عليه صحة دين الإنسان، يعني كونه مسلمًا أو غير مسلم، وكونه من أهل الجنة الخالدين فيها، أو من أهل النار الخالدين فيها، وهذا مبني على العقيدة؛ ولهذا اعتنوا بها اعتناءً كبيرًا، وشرحوها ووضحوها في واقعهم العملي وفي مصنفاتهم التي كتبوها للناس(2).
فالعلم بالشرع وبأحكام الدين والتعلم هما الوسيلة الناجحة للخروج والخلوص من هذه المزالق الوعرة، ومن هذه التيارات والأفكار والمناهج التي تهدد عقيدة الإنسان وفكره ومنهجه في الحياة.
ومن هنا كان للاهتمام بالعلم وبدراسته أهمية كبرى، ومكانة عظمى في إنقاذ الإنسان لنفسه ولغيره من الناس عندما يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد، إذًا، من دراسة العلم دراسة تفصيلية، يتفقه الإنسان من خلالها في أحكام دينه، ويتعلم فيها العقيدة الصحيحة، ومناهج الاستدلال الصحيحة، بعيدًا عن الآراء الضالة والمناهج المنحرفة، وهي خطيرة كل الخطر، تمتلك أدوات قوية جدًا لنقل أفكارها ومناهجها، ومن هنا كان طلب العلم مُهمًا جدًا في إنقاذ الإنسان لنفسه.
ومن هنا كانت المنهجية في طلب العلم مهمة جدًا لطالب العلم حتى يصل إلى نتيجة صحيحة بإذن الله تعالى.
ومن معالم هذا المنهج الذي نحن بحاجة إليه؛ أن يدرس الإنسان صغار كتب العلم قبل كباره، وأن يتدرج الإنسان في طلبه للعلم، وأن يبدأ أول ما يبدأ بالعلم في العقيدة والأحكام، فيتعلم العقيدة الصحيحة، ويعلم الأحكام الفقهية التي يصح بها عمله، وكذلك ينبغي على طالب العلم، أثناء دراسته لذلك، أن يهتم بالمنهج الصحيح في الاستدلال، وينبغي أن يعرف قواعد أهل العلم في الاستدلال الصحيح، فليس كل استدلال يكون صحيحًا؛ عندما يأتي إنسان مثلًا ويبني عقيدة أو فكرة أو رأيًا على قصة أو رؤيا أو قول من أقوال أهل العلم السابقين، ويترك النصوص الشرعية الواردة في ذات الموضوع، فلا شك أنه مخالف للمنهج الصحيح في الاستدلال والوصول إلى الرأي الحق والمنهج الصحيح.
إذًا، لا بد أن يتعلم الإنسان قواعد الاستدلال، فأول ما يستدل ينبغي أن يستدل بالقرآن وبالسنة الصحيحة الثابتة، ثم بالإجماع، ثم بالقياس الصحيح المنضبط، الذي تتحقق فيه شروط القياس، وتنتفي عنه موانعه عند عدم وجود الأدلة السابقة، وليس الكلام على مناهج الاستدلال وقواعده مرادنا، وإنما المراد الإشارة إلى أهمية الاستدلال وضرورته لطالب العلم(3).
إن الأمة التي ترضى بالجهل وتتقاعس عن العلم تدفع الثمن غاليًا، والضريبة مضاعفة، ومن آثار الجهل التي شهدت بها السنن الكونية، وسطرها التاريخ على مستوى الفرد أو المجتمع انتشار البدع والضلالات في العقائد والعبادات والمعاملات، وضعف الإيمان، وقلة التقوى، وازدياد المعاصي، وضعف الهيبة أمام الأعداء، وتقييد الأمة بأغلال التخلف في جميع المجالات، وكثرة المشكلات الأسرية، والخمول والكسل، وضعف الهمم، والقصور عن إدراك المعالي، وهي نتائج حتمية للجهل.
وشتان بين هذه وبين ما جعله الله جزاءً حسنًا عاجلًا في الدنيا لمن يتعلمون العلم ويعملون به، الذين يحصِّلون الإيمان بالله تعالى، ومعرفته حق المعرفة، فتقل فيهم المنكرات، ويحصل القيام بحقوق كل ذي حق، وتُحكّم شريعة الله، وبذلك تُجتلب السعادة.
إن ضعف التأصيل العلمي ظاهرة قد برزت في هذه الأعصر، وهو ظاهرة خطيرة، نرى نتاج ثمرها بارزًا، ومظاهر انتشارها أصبحت لا تخفى على المُطالع، ومن هذه المظاهر الفتاوى الشاذة الغريبة.
وعدم إحسان الفهم لكلام أهل العلم على الوجه الذي كان ميسورًا لصغار الطلبة.
ومن مظاهرها قلة الأدب مع أهل العلم، والتعجل في الفتوى، ومصادرة قول المخالف، والفهم المعوج، والتذبذب في الأقوال، والتناقض في الأفعال.
ومن أعظم مظاهرها أن طالب العلم غير المؤصل أصبح كالورقة في الريح الهادرة، تتقاذفه الأهواء، وتتجاذبه الآراء.
والعجيب أنا رأينا كلما قل التأصيل وضعف التحصيل زادت الجراءة على أهل العلم، وزاد التسرع والتعجل في الفتوى واعتماد الفهم.
ولعل من أهم أسباب هذا الضعف العلمي العام، وضعف التأصيل خاصة، أمورًا، منها:
- اندثار الطريقة الإسلامية في التعلم، منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى القرون الأخيرة، وهي طريقة حلق العلم وما يتبعها من مشامة الشيخ ومشافهته، ومجالسة أهل العلم والتعود على البذل والصبر.
وكما قيل: مفاتيح العلم أربعة: عقل رجاح، وشيخ فتاح، وكتب صحاح، ومداومة وإلحاح (الفوائد المكية).
وجلها، إن لم تكن كلها، لا تتوافر، إلا ما رحم ربي، في جامعات المسلمين المعاصرة.
- ومن هذه الأسباب انتشار مواقع الغثاء ووسائل الاتصال الحديثة، فبرز من لو كان قبل عقد أو اثنين في سنه لكان غايته جمع المحابر الضائعة، وتللين الكواغد اليابسة، وبري الأقلام الداثرة.
وانظر مثلًا إلى طالب العلم المؤصل في علم الاعتقاد وطالب العلم غير المؤصل؛ كيف يقف الأول في الفتن شامخًا ثابتًا، لا يتضعضع ولا يتقلب، بينما الثاني يضطرب فهمًا وعملًا، ويتقلب يمينًا وشمالًا.
فالأول تعرض له الشبهة فيستعمل ما عنده من قواعد الاعتقاد على مذهب أهل السنة والجماعة، فينظر أولًا إلى الكتاب والسنة، ثم ينظر إلى فعل السلف واعتقادهم، فما وافقه أخذ به، وما خالفه قذفه غير آبه بصراخ مبتدع ولا تشنيع مضل.
وشباب الدعوة أقسام ثلاثة:
قسم منهم يدعو ويبذل وليس عنده وقت للتحصيل فأجاد يوم وصل، وقصر يوم ما حصل.
وقسم عكف على التحصيل وأهمل نشر العلم والدعوة، فأحسن في تحصيله وقصر في توصيله.
وقسم كُمَّل، أهل فطنة وفقه، وهم أهل التحصيل وأهل النشر والنفع والدعوة، وهم صفوة الطوائف الثلاث.
كم من طلاب العلم من يجثون بركبهم في حلقات، لكنهم سرعان ما يفرون منها، ويصبح حالهم كشخصين:
الشخص الأول: يحضر الحلقة للبركة، فيجلس ويبحث عن سارية ليسند ظهره إليها، ثم ما يبدأ الشيخ إلا وقد غاب في غيبوبة كاملة، وبعضهم يجلس نصفها والنصف الآخر يتقدم في روضة المسجد، وربما توسد كتبه فأخذ يغط في نوم عميق، وتسأله قال: الحمد لله، نحن من طلاب الشيخ، وقد حضرنا، وأفتانا شيخنا، وقد علقنا عند شيخنا، واستفدنا منه، ولازمناه سنوات، وقد درس على السارية وعلى روضة المسجد أكثر مما تعلم من الشيخ وعلمه.
الشخص الثاني: خرج قادحًا للعلم ولأهل العلم، وهذه سلبية كبيرة جدًا، وأقول للأحبة: كم نجد من الأحبة، وربما بعض طلاب العلم، ينفرون من حلقات علمائنا الكبار، فيقولون: هذه الحلقات إمرار كتب، وليس فيها نفع كبير، وليست إلا قضاءً للوقت، وليست مؤصلة للعلم، ولا تُخرج طالب علم، ولا تصلح إلا لطلاب العلم الكبار، وخذ من الشبه التي تسمعها، ثم بعد ذلك يصبح عند الطالب قناعة داخلية أن هذه الحلقات إنما تفرج عليها وحضر إليها من باب البركة فقط، هؤلاء طلاب البركات يحضرون «هم القوم لا يشقى بهم جليسهم»(4)، لكنهم هل يؤصلون، يتابعون ويقيدون من الفوائد؟! يحضر يومًا وبقية الأيام لا يحضر، ولست أقول: لا يحضر إلى تلك الحلقة، لو حضر يومًا واحدًا ففيه خير كثير(5).
الإنسان تجد عنده مجموعة معلومات، لكن معلومات مفرقة، والروابط بين هذه المعلومات ومعرفة جذور هذه المعلومات ليست بجيدة، وليست على مستوىً تؤهل هذا الإنسان للفقه في الدين الذي، حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»، يعني: يفهمه هذه الأحكام، والتفهم يقتضي أن يتريث الإنسان، وأن يتأنى، وأن يقرأ العلم قراءةً متأنيةً هادئةً، ويحفظه ويضبطه، وهكذا كانت طريقة العلماء من زمن الصحابة رضوان الله عليهم إلى اليوم، فإنك عندما تقارن بين عالم من العلماء يفتي في باب العقيدة وفي باب الفقه، وفي كل الأبواب تجد أنه لم يتوصل إلى هذا المستوى إلا بعد هذا التدرج الذي ذكرناه.
وتجد أشخاصًا مثقفين لديهم معلومات متنوعة، لكن هذه المعلومات المتنوعة لا تؤهله للإفتاء، وإذا أفتى أو تكلم في علم من العلوم خلط، وأصبح ينقض بعض الأصول التي دلت عليها عشرات الأدلة الشرعية والعقلية ونحو ذلك؛ ولهذا كان الحافظ ابن حجر رحمه الله عندما يذكر بعض المصنفين الذين يخبطون خبط عشواء يقول رحمه الله تعليقًا على ذلك: «من تكلم في غير فنه يأتي بالعجائب»، فالإنسان الذي يتكلم في علم من العلوم وهو لا يتقن هذا العلم فإنه سيأتي بالغرائب والعجائب فيه(6).
بعض الناس تأخذه مجاراة الثقافة العامة عند الناس، فيذهب وكأنه يريد أن يبسط للناس المفاهيم، فيسمي الزكاة ضريبة، أو يسمي الحج القصد أو نحو ذلك، فهذا خروج بالأصول الشرعية عن لوازمها؛ لأن من لوازم المعاني الشرعية أن يلتزم ألفاظها، وكذا بقية الأمور التي تنبني عليها العقيدة أو ثوابت الأحكام؛ مثل: الحلال القطعي والحرام القطعي، وأصول الأخلاق، ونحوها، فنسمي الصدق باسمه، ونسمي الربا باسمه، وكذلك ألفاظ العقيدة خاصة التي تتعلق بالله عز وجل، وهو أعظم ما يجب أن يعناه المسلم.
فنحن ندرس ما يتعلق بالله في ذاته وأسمائه وصفاته لنعظم الله، ولنغرس في قلوبنا محبة الله وخوفه ورجاءه، وهذا لا يؤدي دوره على المعنى الكامل إلا بالتزام الألفاظ الشرعية في أسماء الله وصفاته؛ ولذلك قال السلف: «أسماء الله توقيفية بألفاظها»، بمعنى: أن نقف على ألفاظها الشرعية، فلا نأتِ بألفاظ أدبية أو فلسفية أو معانٍ عامة فضفاضة متميعة فنعبر بها عن حق الله عز وجل، كما يعبر بعض الفلاسفة عن الله بأنه مجرد قوة؟! والله سبحانه وصف نفسه بالقوي أو بالقدير العليم الغني(7).
فالفرق بين العلم الشرعي المؤصل، وبين الثقافة العامة؛ هو أن العلم الشرعي المؤصل يعتمد على الإتقان والضبط؛ ولهذا اجتهد أهل العلم في تأليف المختصرات المنضبطة التي تحتوي على أهم المسائل والقضايا المتعلقة بهذا العلم، بحيث إن الإنسان إذا ضبط هذا المختصر فقد ضبط الأصول والقواعد التي ينبغي للإنسان أن يدركها في هذا الفن، ثم ينتقل إلى كتاب أعلى منه بقليل، ثم أعلى من الثاني بقليل، وهكذا حتى يتقن؛ لأن البناء، كما تعلمون، لا يتم إلا إذا وجدت هناك قواعد يبني الإنسان عليها، فإن البناء سيكون قويًا بقدر ما تكون القواعد التي بني عليها قوية أيضًا(8).
الثقافة العامة:
تعتمد الثقافة العامة للخطيب على شخصيته العلمية، وسعة اطلاعه، وحبه للقراءة، وكذلك على مخالطته للناس، وانخراطه في الحياة الاجتماعية، وعلى أسفاره وتجاربه الخاصة.
والثقافة العامة المقصودة هنا تتناول جوانب عديدة:
1- الاطلاع على وقائع الأمة وحاضر العالم الإسلامي، من النواحي العامة، والاقتصادية، والأخلاقية، والسياسية، وما يحاك له من مؤامرات، وأبعاد الكيد والعداوة للإسلام والمسلمين، وجوانب الغزو الفكري والثقافي والعلمي، وما يدبر للمرأة المسلمة، وللشاب المسلم، وللطفل المسلم، من مكايد ودسائس، وليس مطلوبًا من الخطيب الإحاطة الكلية بما يجري في العالم الإسلامي، ولكن أن يكون على اطلاع بأهم أمراضه، وهمومه، وعلاج أدوائه.
2- الاطلاع على واقع المخاطبين في مسجده، وحيه، وفي مجتمعه، فإذا تكلم محذرًا من بدعة من البدع مثلًا فينبغي أن يكون عالمًا بتعريف البدعة، وأقسامها ومخاطرها على الأمة، مستشهدا بالأدلة من الكتاب والسنة، وبأقوال السلف الصالحين، مع الالتزام بأدب النصح، فإن المؤمن يستر ويعظ وينصح، والفاجر يهتك ويعير ويفشي ويفضح(9).
3 -الاطلاع على واقع الدعوة والدعاة في العالم الإسلامي، وواقع الحركات الإسلامية ودورها في إيقاف المد الثقافي الغربي، وما ينقصها من وعي وتخطيط وتآزر وتعاون وتناصح، مع الالتزام بالأدب واللطف، وسعة الصدر، والحرص الشديد على اتفاق القلوب على الحق، وعدم اختلافها وتنازعها، فإنه لا يسع الخطيب جهل ساحة العمل الإسلامي، وجهل العاملين في هذه الساحة.
4- فقه الحدث، أي ما يطرأ من أحداث، وكيفية التعامل معها وفق الضوابط الشرعية، فعلى الخطيب أن يحسن التعامل مع هذا الحدث؛ لئلا يكون مزلقًا من المزالق التي تسقط الثقة به، وحتى لا يكون لطريقة معالجته الخاطئة آثار نفسية أو عقدية تنعكس على العامة، وعلى الخطيب ألا ينساق وراء التحليلات الصحفية، أو الشائعات الشعبية في الحكم على هذا الحدث، والأحداث منها ما يكون من الكوارث الطبيعية، من زلازل وبراكين، أو أمراض فتاكة ونحو ذلك.
فلا يغفل الخطيب عن ربط ذلك بالسنن الإلهية، وعن التذكير بانتقام الله تعالى، وبآثار الذنوب والمعاصي على تغير الأحوال، ومن الأحداث ما يكون حدثًا علميًا تدوي أصداؤه في أرجاء العالم، مثل حدث الصعود على القمر، أو حدث الاستنساخ الجيني, أو التلاعب في الخصائص الوراثية، فعلى الخطيب أن يكون حذرًا في طرح مثل هذه الموضوعات؛ إذ لا يحسن به أن يتغافلها كليًا، ولا يحسن به المسارعة إلى طرحها دون الإلمام بجوانبها، ولا المسارعة إلى الفتوى بشأنها قبل صدور فتوى شرعية من مصدر معتمد من مصادر الفتوى؛ مثل المجامع الفقهية ونحوها من الهيئات العلمية، التي تصدر الفتاوى في النوازل بعد دراسة وتمحيص من عدد من العلماء والفقهاء.
ومن الأحداث ما يكون من قبيل الفتن التي يجب أن يكون الخطيب شديد الحذر والاحتراس في الكلام بشأنها، فإن الفتنة تقبل بشبهة، وتدبر ببيان، وليكن فيها، كما قال حذيفة رضي الله عنه، كابن اللبون؛ لا ظهر فيركب، ولا در فيحلب(10).
والمقصود أن يحترس من الفتوى فيها، أو التحريض، أو الكلام إلا في الدعوة إلى خير أو إصلاح بين الناس، فرُبَّ قول أنفذ من صول؛ بل رب حرف قاد إلى حتف، وجر إلى بلاء، وليحذر كل الحذر أن يكون من خطباء الفتنة، وليقل خيرًا أو ليصمت(11).
وتحصيل العلوم الشرعية على غير أصولها الصحيحة، وتحصيل الثقافة الشرعية العامة بغير وسائلها الحقيقية كل ذلك لا يبني الشخصية المسلمة؛ بل في الغالب يوجد الغرور والتعالي، ويوجد العلم الذي لا تنظمه قاعدة ولا ينظمه أصل، علم بلا قدوة، علم بلا أصول؛ لذلك نجد أغلب الذين يأخذون دينهم أو علومهم الشرعية أو تحصيلهم للعلوم الشرعية عن طريق الوسائل، دون أن يكون لهم قدوة، ودون أن يأخذوا بالأصول الشرعية نجد أغلبهم يخلطون في الأمور؛ في الأحكام، في العقائد، فيكون عندهم شطحات ومواقف شاذة تجاه الأحداث والمواقف والأشخاص.
وسبب ذلك أنهم ظنوا أنهم علموا حينما قرءوا بعض الكتب، وسمعوا بعض الأشرطة، وحضروا بعض المحاضرات، وتلقفوا بعض المعلومات المشتتة عبر الأجهزة المسموعة والمرئية، فظنوا أنهم بذلك صاروا علماء أو مثقفين، ويستغنون عن العلماء، وهذا مع الأسف كثير بين المثقفين والمفكرين، أو من يسمون بالمثقفين والمفكرين.
والتفقه في الدين لا بد أن يكون على يد عالم قدوة، أو طالب علم متمكن، ولو لم يكن عالمًا تتوافر فيه جميع شروط العلم؛ لكن ينبغي أن يكون طالب علم متمكنًا موثوقًا بقدوته وأسوته، ومتمكنًا في علمه الذي يعلمه، هذا شرط.
الشرط الآخر: أن يكون متحررًا من الغايات والأهداف الأخرى، فتحصيل العلم الشرعي ينبغي أن يكون من خلال الدروس وحلق الذكر والعلم، وقراءة الكتب بمشورة العلماء وطلاب العلم الذين لهم الخبرة، ومن أخذ علمًا يجب أن يأخذه بتدرج على طلاب العلم الفاهمين، الذين يعطون العلوم بتدرجها، فلا يأتي إنسان صغير ويأخذ أصعب الكتب في علم العقيدة أو في أصول الفقه مثلًا؛ لأن هذا يؤدي إلى أحد أمرين:
إما أن يتعثر وينغلق عن هذا العلم، أو يفهمه على غير وجهه، فيبدأ يخبط في الأحكام وفي أمور المسلمين، وكل ذلك خطأ، وهذا لا يعني أننا لا نستفيد من الوسائل، لا، فأخذ العلم الشرعي عبر الشريط والإذاعة والندوة والمحاضرة والكتاب والمدرسة والجامعة هذا أمر طيب؛ بل هو وسيلة يجب أن نستفيد منها ونعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، لكن الاقتصار عليه في التفقه في الدين هذا خطأ، وفرق بين من يريد أن يحصل بعض الأمور البدائية، التي تحصن دينه، وبين من يريد أن يسلك طريقًا للعلم الشرعي، الذي يتفقه به ويتخصص وينفع الأمة، فرق بين هذا وذاك.
فطالب العلم الذي يريد أن يحقق للأمة حاجتها من الفقه في الدين، في تخصص أو أكثر من العلوم الشرعية، لا بد أن يسلك الطريق السليمة، أما من عداه من عامة المسلمين فعليه أن يسدد ويقارب، ويحاول قدر إمكانه أن يحضر دروس المشايخ وطلاب العلم، فإذا لم يتمكن فأخذه المعلومات الشرعية عن طريق الوسائل هذه نعمة، ويجب أن يستفيد منها كل مسلم، لكن الدعاة والموجهون للأمة يجب أن يتفقهوا في الدين بأساليب التفقه الصحيحة الشرعية(12).
_______________
(1) أخرجه البخاري (71).
(2) شرح القواعد المثلى (1/ 2).
(3) شرح العقيدة الواسطية، ص2- 3.
(4) أخرجه البخاري (6408).
(5) شرح لامية ابن تيمية (19/ 18) موسوعة الشاملة.
(6) دراسة موضوعية للحائية ولمعة الاعتقاد والواسطية (11/ 2).
(7) مجمل أصول أهل السنة (2/ 8).
(8) دراسة موضوعية للحائية ولمعة الاعتقاد والواسطية (11/ 2).
(9) حلية الأولياء، ص190.
(10) أخرجه نعيم بن حماد في كتاب: الفتن (1/ 140) من كلام حذيفة وابن مسعود رضي الله عنهما.
(11) خطبة الجمعة ودورها في تربية الأمة، ص112.
(12) توجيهات في مسار الصحوة الإسلامية، ناصر العقل.
