المنهج الدعوي للتعامل مع المخالف
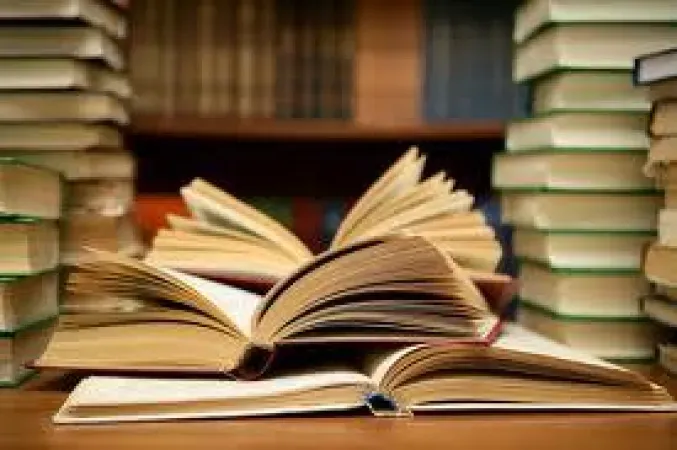
والمخالف هو كل من خالفك في أي شيء؛ فهو الوثني والملحد والكتابي والمرتد والمنافق والمبتدع بدعة اعتقادية والمبتدع بدعة عملية، وهو المنازع في المسائل الفقهية القطعية والظنية، وكذلك في المناهج المختلفة، سواء كانت دعوية أو سياسية أو عملية أو في أي صعيد، فكل من لا يرى رأيك أو عملك فهو لك مخالف.
وباستقراء أحوال الرسل مع أقوامهم يمكن القول بأن المخاطبين بالدعوة على ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى: مخاطبة عموم الناس، وهذه تكون بالحكمة والموعظة الحسنة.
الحالة الثانية: مخاطبة المجاهر بالمعصية المظهر لها، وهذه تكون بالحكمة أولًا، فإن لم تنفع الحكمة معهم فلتكن بالإغلاظ والتغيير.
الحالة الثالثة: مخاطبة من حارب الدعوة وأظهر العداء لها بما يكتبه ويلفظه، رغم سابق بيان الحق له ثم صده عنه, والتعامل مع هذا النوع هو من الجهاد بالبيان؛ لأن المجال هنا ليس مجالَ دعوة؛ بل هو مجال انتصار للثوابت وردع للمخالف، وعلى مثل هذا يفهم قول ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير الآية حيث قال: {جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ} باليد، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب، فإن لم يستطع فليكفهر في وجهه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف، والمنافقين باللسان، وأذهب الرفق عنهم(1).
ويدل على أن المخاطبين ليسوا على صورة واحدة في نوع الخطاب قول الله تعالى: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ} [العنكبوت:46]، فليسوا سواء.
ولذلك تنوَّعت المناهج التي اتَّبعها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والتي منها:
أولًا: استفراغ الوسع والجهد في دعوته:
لقد سلك الرسول صلى الله عليه وسلم طريقًا وسطًا؛ بحيث يحافظ على نقاء الدعوة وتوصيل الحق كاملًا غير منقوص، في الوقت الذي لا يغالب فيه الواقع الذي هو فوق الطاقة المحدودة للفرد، فقد لجأ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الدعوة الفردية السرية، فبدأ بدعوة من يأنس فيهم الرشد ورجاحة العقل في إدراك الحق، فحافظ بذلك على نقاء الدعوة مع أمنه من مضايقات المشركين ومغالبتهم له في أول الأمر.
وما أن وجد الرسول صلى الله عليه وسلم أعوانًا على الدعوة حتى بادر إلى الأسلوب الآخر؛ أسلوب الإعلان والبوح، وإظهار الدعوة والجهر بها بين الناس؛ إذ هذا الأسلوب هو الكفيل بنشر الدعوة وبلوغها للناس على نطاق واسع، في زمن قليل جدًا إذا قورن بزمن الأسلوب الأول، لكن ما إن جهر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة حتى عاداه المشركون وصدوا الناس عن دعوته.
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما اطمأن على الدعوة ظل سائرًا في طريقه، لم يثنه عن ذلك ما ظهر من معارضة المشركين؛ لأن هذه المعارضة من طبيعة التناقض التام بين دعوة الحق ودعوة الباطل.
فلم يكن همُّ الرسول صلى الله عليه وسلم محصورًا في مجرد إقامة الحجة عليهم؛ بل كان همه الأكبر هو في قيادهم إلى الإيمان، وقد كان صلى الله عليه وسلم يسلك في ذلك كل طريق من شأنه أن يحقق مراده، وهذه عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تخبرنا أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟، قال: «لقد لقيتُ من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة؛ إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد، فقال ذلك فيما شئت؛ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين»، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا»(2).
لقد عانى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أشد المعاناة من إيذاء المشركين له في مكة المكرمة، حتى قاطعوه هو وعشيرته، وحاصروهم في الشعب حتى لم يجدوا ما يأكلونه، وضيقوا عليه كل التضييق، وحاصروه أشد المحاصرة، حتى يحولوا بينه وبين لقاء الوفود ودعوتهم إلى الله، فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان صلى الله عليه وسلم يسعى في مقابلة الحجيج وعمار بيت الله وزواره، وكان يجتهد في المحافظة على سرية هذه اللقاءات حتى لا يسعى المشركون في إفسادها، ولم يستسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك؛ بل حاول في اتجاه آخر؛ وهو الخروج بالدعوة من الحصار الذي فرض عليها، فقام برحلته المشهورة إلى الطائف على رجليه، والتي تبعد عن مكة قرابة ثمانين كيلو متر، كل ذلك في سبيل أن يكسر الطوق المضروب حول الدعوة.
ولما بلغ الطغيان بالمشركين مبلغًا عظيمًا، يفوق قدرة بعض المسلمين، أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، وبقي هو ومن يمكنه البقاء من المسلمين في مكة يواصلون مهمة الدعوة إلى الله.
ظل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في مكة ثلاث عشرة سنة، ولم يترك مكة مع أول صدود أهلها، أو مع تأخرهم وإبطائهم في الاستجابة، ما يبين أن من السياسة الشرعية في الدعوة ألا يستعجل الداعية إيمان الناس واهتدائهم؛ بل عليه أن يبذل وأن يقدم ما دام هناك تقبل واستجابة، ولو كان ذلك بطيئًا أو ضعيفًا.
ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ظل مثابرًا على المقام في مكة، وهو يواصل الدعوة بكل ما أمكنه من سبيل، ولم يخرج منها إلا مكرهًا، كما بين ذلك بقوله عن مكة حرسها الباري: «والله، إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أُخرجت منك ما خرجت»(3).
ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على الدعوة أنه كان يخطب المسلمين، وبينما هو على تلك الحالة إذ جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، قال: فأقبل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدًا، قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها، فلما أخبر الرجل بأنه لا يدري ما دينه كان أولى ما يشتغل به الرسول صلى الله عليه وسلم هو تعليم الرجل دينه، ولذلك ترك الخطبة وأقبل عليه يعلمه، ولم يؤخر ذلك حتى ينتهي من الخطبة(4).
ثانيًا: الصفح والتسامح وكف اليد:
{فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ} [الحجر:85]، وهو الصفح الذي لا أذية فيه؛ بل يقابل إساءة المسيء بالإحسان، وذنبه بالغفران، لتنال من ربك جزيل الأجر والثواب، فإن كل ما هو آتٍ فهو قريب.
والصفح الجميل أي: الحسن، الذي قد سلم من الحقد والأذية القولية والفعلية، دون الصفح الذي ليس بجميل، وهو الصفح في غير محله، فلا يصفح حيث اقتضى المقام العقوبة؛ كعقوبة المعتدين الظالمين الذين لا ينفع فيهم إلا العقوبة، وهذا هو المعنى(5).
ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النموذج الأسمى، والأسوة الطيبة، والقدوة الحسنة في التسامح والعفو والصفح، وحسبه عليه الصلاة والسلام أنه عندما عاد إلى مكة فاتحًا جمع قبائل قريش من المشركين، وهم الذين آذوه وحاربوه وأخرجوه من مكة مهاجرًا، فقال لهم: «يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟»، قالوا: خيرًا، أخ كريم وابن أخ كريم، قال: «لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء»، وعفا عنهم برغم ما كان منهم معه(6).
يجب ألا يفهم التسامح على أنه تنازل عن الحق، أو أنه الخوف، أو قبول الذل مخافة الأمور العظيمة التي لا يتحملها البعض، فيلجئون إلى التسامح، فليس التسامح هكذا، ولا يمكن أن ندعو الغير إلى قبول الذل أو التنازل عن الحق أو التبرير للمخطئ.
فالقصد بالتسامح هو أن يكون منهج حياة أو طريقة حياة وليس رد فعل لواقعة عابرة، إنك حين تتسامح مع المخطئ أو من يرتكب حماقة أمامك أو معك، فأنت لا تتنازل عن حقك؛ بل تتعالى وتترفع عن السقوط في الحماقة أو الخطأ الذي يحدث.
ثالثًا: محبة الخير والهداية له:
عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل، وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عم، قل: لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله»، فقال أبو جهل، وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك»، فأنزل الله عز وجل: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} [التوبة:113]، وأنزل الله تعالى في أبي طالب، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} [القصص:56](7).
ففي هذا النص بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه وإدخاله في الإسلام؛ حتى في آخر لحظات حياة عمه وفراقه للدنيا؛ فلم ييأس ولم يقنط من استجابته لدعوته؛ رغم ما يلقاه من صد عما جاء به من ربه.
وعن أبي هريرة قال: قدم الطفيل وأصحابه فقالوا: يا رسول الله، إن دوسًا قد كفرت وأبت، فادع الله عليها، فقيل: هلكت دوس، فقال: «اللهم اهد دوسًا وائت بهم»(8).
رابعًا: إقراره على ما هو عليه من خير:
فهذه قريش رغم ظلمها وطغيانها مع المسلمين إلا أنهم عقدوا فيما بينهم عقدًا لنصرة المظلوم، وكان ذلك قبل البعثة، وهو ما عرف بحلف الفضول، قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفًا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو ادعى به في الإسلام لأجبت»(9).
وقد تتواجد اليوم في بعض المجتمعات بعض التنظيمات أو المؤسسات التي تحاول القيام بشيء شبيه بما كان في حلف الفضول؛ فلا عيب على الداعية إذا حاول الاستفادة من ذلك، أما إذا ترتب على ذلك مساس بالدين فعلى الداعية أن يكون أبعد شيء من ذلك(10).
خامسًا: التمكُّن من مذاهب وأفكار ولغات المخالف:
كان اليهود إذا جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بعضهم بعضًا بلغتهم العبرية؛ حتى لا يفهم المسلمون ما يقولون، وكذلك كانوا إذا كتبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالةً أو عهدًا جعلوها بالعبرية، وهنا أراد النبي صلى الله عليْه وسلم أن يتعلم واحد من أصحابه هذه اللغة، فاختار الفتى الأنصاري زيد بن ثابت رضي الله عنه.
فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى ملوك العجم، أمر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم السريانية بأمر منه صلى الله عليه وسلم كما تعلم العبرية، وبذلك أصبح الفتى زيد بن ثابت رضي الله عنه ترجمان النبي صلى الله عليه وسلم.
سادسًا: عدم الالتفات إلى أساليب استهزائهم، والثبات على الحق:
فلو تصفحنا السيرة لوجدنا صنوف الاستهزاء والتهكم التي لقيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من قبيل: شاعر، كاهن، ساحر، وهلم جرًّا من الألقاب المشينة، ورغم ذلك لم يلتفت إلى ترَّهاتهم، قِسْ ذلك على أي صف إسلامي يشتغل بدين الله، تنزل عليه سهام متعددة من المصطلحات المشينة: الرجعية، والظلامية، والقرسطية، والنكوصية...
سابعًا: حمل كلامهم على ظاهره:
وعدم التعرض للنوايا والبواطن، وأصل هذه القاعدة عندما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أضرب عنقه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب النَّاس ولا أشق بطونَهم»(11)، فما في القلوب لا يعلمه إلا الله، وإنما نحن مأمورون بالأخذ بظاهر الإنسان وبظاهر كلامه، وإذا كان هذا المعمول به في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل، فمن باب أولى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، وقد أشار إلى ذلك عمر الفاروق رضي الله عنه، قال: إن أناسًا كانوا يُؤاخَذون بالوحي على عهد رسول الله، وإن الوحي قد انقطع، فمَن أظهر لنا خيرًا أمنَّاه وقرَّبْناه، وليس لنا من سريرته شيء، ومَن أظهر لنا سوءًا لم نَأْمنه ولم نُقَرِّبه، ولم نصدقه، وإن قال سريرته حسنة(12).
ثامنًا: أن يكون التعامل بعدل وإنصاف:
فإن العدل فضيلة مطلقة؛ لا تقييد في فضله؛ فهو ممدوح في كل زمان وكل مكان، وكل حال، ممدوح من كل أحد، مع كل أحد، بخلاف كثير من الأخلاق؛ فإنه يلحقها الاستثناء والتقييد.
ولهذا اتفقت على فضله الشرائع والفطر والعقول، وما من أمة أو أهل ملة إلا يرون للعدل مقامه.
وبالعدل تحصل العبودية لله وحده، وبه تُعطى الحقوق وتُرد المظالم، وبه تأتلف القلوب؛ لأن من أسباب الاختلاف الظلم والبغي والعدوان، وبه يُقبل القول، أو يعذر قائله، وبه تحصل الطمأنينة والاستقرار النفسي.
وكان العدل سببًا لإنزال الكتب وإرسال الرسل، قال الله تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ} [الحديد:25].
فهذا حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه فعل أمرًا عظيمًا بتسريب خبر توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لغزوها؛ فتأنى النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله عن الفعل أولًا بقوله: يا حاطب ما هذا؟، ثم سأله عن السبب؛ بقوله: «ما حملك على هذا؟» وهذا يدل أن للأسباب والدوافع تأثيرًا في الحكم، ثم أعفاه من العقوبة؛ حين وازن بين سيئاته وحسناته فقال: «وما أدراك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»(13).
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: «ومعلوم أننا إذا تكلمنا فيمن هو دون الصحابة؛ مثل الملوك المختلفين علي الملك، والعلماء والمشايخ المختلفين في العلم والدين، وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل، لا بظلم وجهل، وإن العدل واجب لكل أحد وعلى كل أحد في كل حال، والظلم محرم مطلقًا لا يباح بحال قط، قال تعالي: {وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة:8]، وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار، وهو بغضٌ مأمور به، فإن كان البغض الذي أمر الله به قد نهي صاحبه أن يظلم من أبغضه، فكيف في بغض مسلم بتأويل وشبهة أو بهوى نفس؟! فهو أحق أن لا يظلم؛ بل يعدل عليه(14).
تاسعًا: الهجر والترك:
{وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا} [المزمل:10]، لا عتاب معه ولا غضب، ولا هجر فيه ولا مشادة، وكانت هذه هي خطة الدعوة في مكة، وبخاصة في أوائلها، كانت مجرد خطاب للقلوب والضمائر، ومجرد بلاغ هادئ، ومجرد بيان منير(15).
ولا يُهجر ولا يُنفَّر من شخصه بقول أو فعل إلا بشرطين: الأول: أن تكون مخالفته فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد، والثاني: أن يكون الهجر نافعًا في قطع فساد مخالفته أو التقليل منه، أو زجر غيره عن مثل فعله، فإن لم يكن نافعًا وجب البقاء على هذا الأصل؛ لزوال السبب المبيح للخروج عنه.
أما قول المخالف وفعله، سواء كانا مبنيين على اجتهاد سائغ، أو تقليد جائز، أو على غير ذلك من المخالفة للقطعيات؛ فإن بيان دين الله وتعليم العلم والدعوة إليه من أعظم القرب وأحسن الأعمال؛ فكيف إذا كان هذا البيان دعوةً إلى أصل، أو توضيحًا لضروري؛ فإنه من أفضل الأعمال وأوجبها، وإنما قد يُراعى تأخير بيان بعض الأمور رعاية لمصلحة أعظم، أو مفسدة أشد؛ لمعنى في المخالف أو في غيره.
وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم؛ فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله؛ فإن كانت لمصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعًا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك؛ بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف، بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته، لم يشرع الهجر؛ بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر.
والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قومًا ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرًا من أكثر المؤلفة قلوبهم؛ لمَّا كان أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم؛ فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين، والمؤمنون سواهم كثير؛ فكان في هجرهم عز الدين، وتطهيرهم من ذنوبهم، وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة، والمهادنة تارة، وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح(16).
_________________
(1) تفسير ابن كثير (4/ 178).
(2)رواه البخاري (3231).
(3) أخرجه الترمذي (3925).
(4) سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، محمد بن شاكر الشريف، موقع: صيد الفوائد.
(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص434.
(6) سنن البيهقي (18275).
(7) رواه مسلم (24).
(8) رواه مسلم (2524).
(9) السيرة النبوية، لابن هشام (1/134).
(10) سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، محمد بن شاكر الشريف.
(11) أخرجه البخاري (4351)، ومسلم (1064).
(12) أخرجه البخاري (2641).
(13) أخرجه البخاري (3007).
(14) منهاج السنة النبوية، لابن تيمية (5/126- 127).
(15) في ظلال القرآن، سيد قطب (المزمل:10).
(16) قواعد فقه التعامل مع المخالفين، ملتقى أهل الحديث.
