بصائر رشيدة في تعليم العقيدة
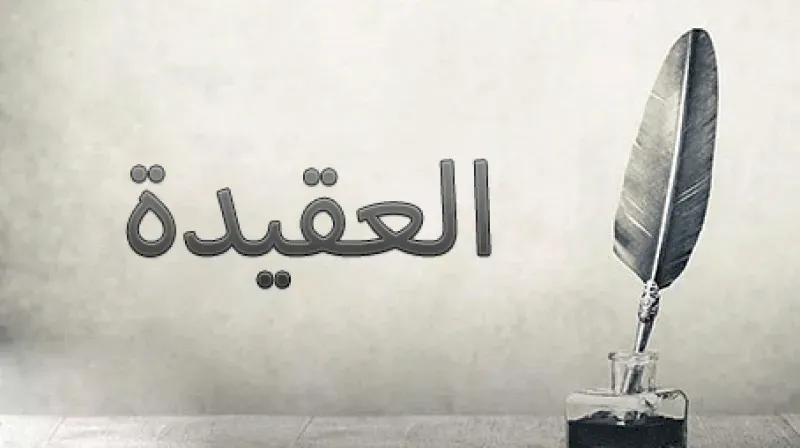
العقيدة هي أهم علوم الدين على الإطلاق، فالعقيدة أهم من الأخلاق، والعقيدة أهم من الآداب، والعقيدة أهم من العبادات، والعقيدة أهم من المعاملات؛ إذ هي أول واجب على المكلف، فعند دخول الشخص الإسلام يجب عليه معرفة التوحيد قبل تعلم العبادات.
وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى نحو أهل اليمن، قال له: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله، فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها، فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم» (1).
وقد دل الحديث على أهمية التوحيد، الذي هو أهم مبحث في العقيدة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالدعوة إلى تصحيح العقيدة قبل الدعوة إلى الأعمال، فقد قدَّم التوحيد على الأمر بالصلاة.
هذا الأصل الذي يبنى عليه جميع فروع الدين، وبدون شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله لا يصح شيء، وعلى هذا على الداعية والمعلم والموجه أن يبدأ أول ما يبدأ بالأصل، فإذا تقرر الأصل دعا إلى ما يليه الأهم فالأهم (2).
وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد بعثته ثلاث عشرة سنة، يدعو الناس إلى تصحيح العقيدة، وإلى التوحيد، ولم تنزل عليه الفرائض إلا في المدينة؛ مما يدل على أن أول أوليات الدعوة تعليم العقيدة، وأول ما تقوم الدعوة على تصحيح العقيدة، ولا يطالب الإنسان بالأعمال إلا بعد تصحيح العقيدة؛ لأجل أن تَنبني على العقيدة الصحيحة سائر الأعمال من العبادات والسلوك.
والعقيدة هي الأساس الذي تبنى عليه أعمال الإنسان، ويتوقف قبول الأعمال الصالحة على سلامة أصول العقيدة من الشرك والكفر، فمن يشوب عقيدته كفر أكبر أو شرك أصغر، يكون خاسرًا، وإن فعل الكثير من أعمال البر، فإذا كانت العقيدة غير صحيحة، بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال؛ كما قال تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر: 65].
وقال تعالى: {وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأنعام: 88]؛ أي: لبطلت أعمالهم، فدون تصحيح العقيدة لا فائدة من الأعمال.
وتعلم العقيدة الصحيحة يعصم الإنسان من الشرك، ونسيان العقيدة الصحيحة سبب للوقوع في الشرك، وخلو العقيدة من الشرك أو من اعتقاد مكفر فيصل حاسم بين خلود الإنسان في نار جهنم والنجاة منها؛ فقد قال تعالى: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا} [النساء: 48].
والعقيدة أشرف العلوم وأعظمها وأعلاها؛ لأن شرف العلم وعظمته بحسب المعلوم، ولا معلوم أكبر من ذات الله تعالى وصفاته، وهو ما يبحث فيه هذا العلم.
والعالم مليء بالمذاهب الباطلة الهدامة، والأفكار المنحلة، والمناهج الفاسدة، فلا بد للمسلم أمام هذه المذاهب والأفكار والمناهج، أن يكون لديه علم صحيح بالعقيدة، وأن يكون لديه فهم صحيح بها؛ حتى يميز الخبيث من الطيب، والضعيف من الصحيح، والباطل من الحق.
لماذا نتعلم العقيدة؟
ولتكن نيتنا عند تعلم العقيدة، وأهدافنا عند تعلم العقيدة، أو من فوائد تعلمنا العقيدة الصحيحة ما يلي:
1- الاقتداء بالرسل في تعليم الناس العقيدةَ قبل العمل؛ قال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} [النحل: 36]، وقال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء: 25].
2- تصفية عقيدتنا من شوائب البدع والشرك، وسلامة العبد من الكفر والشرك أصل النجاة من النار، لكن تمام النجاة يكون بالفقه الذي يصحح الأقوال والأعمال وَفْق مراد الله عز وجل، ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسلم العبادة من الابتداع.
3- ومن خلال تعلمنا أهمية العقيدة، يتبين بطلان الدعوى بأن الإيمان يكفي دون الاهتمام بالعقيدة؛ حيث إن الإيمان لا يكون إيمانًا إلا إذا صحت العقيدة، أما إذا لم تكن العقيدة صحيحة، فليس هناك إيمان ولا دين.
4- تعلم العقيدة ضرورة من ضرورات الإنسان التي لا غنى له عنها، فالإنسان بحسب فطرته يميل إلى اللجوء إلى رب يعتقد فيه القوة الخارقة، والسيطرة الكاملة عليه وعلى المخلوقات من حوله، وهذا الاعتقاد يحقق له الميل الفطري للتدين، ويشبع نزعته تلك، والعقيدة الإسلامية تقوم على الاعتقاد الصحيح الذي يوافق تلك الفطرة، ويحترم عقل الإنسان ومكانته في الكون.
5- لا حياة للقلب ولا طمأنينة ولا سعادة إلا بصحة العقيدة، فإذا انطبعت العقيدة الصحيحة في نفس العبد -من العلم بالله وتوحيده، ومحبته وخشيته، وتعظيم أمره ونهيه، والتصديق بوعده ووعيده- سعد في الدنيا والآخرة، وسعد مجتمعه به؛ ذلك أن صلاح سلوك الفرد تابع لصلاح عقيدته وسلامة أفكاره، وفساد سلوك الفرد تابع لفساد عقيدته وانحرافها.
6- العقيدة الصحيحة تخلص العبد من القلق والتوتر العصبي والاكتئاب، فصاحب المعتقد الصحيح يؤمن بقدر الله، وأن الله مدبر الأمر، وأن الله غفَّار الذنوب، فإن وقع في ضيق يدعو ربه، فيُفرِّج كربه، وإن أذنب استغفر فيغفر الله له، وإن حدث ما يحزنه حمد الله واسترجع؛ لأنه يعلم أن الله هو المقدر، فلا يقدر شيئًا إلا لحكمة؛ فلا يكتئب ولا يقنط.
وصاحب المعتقد الصحيح تجده مطمئن النفس، هادئ البال، قرير العين، ليس بالقلق ولا بالحيران، حتى كان يقول أحدهم: نحن في سعادة لو علِمها الملوك، لقاتلونا عليها، وقيل للعالم عبد الله بن المبارك: من الملوك؟ قال: الزهاد، قالوا: فمن السفلة؟ قال: الذين يأكلون بدينهم، قالوا: فمن سفلة السفلة؟ قال: الذين يصلحون دنيا غيرهم بتضييع دينهم (3).
ولا يمكن أن ينجو العبد في الآخرة إلا بصحة العقيدة؛ قال تعالى: {وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأنعام: 88].
لذلك الحاجة إلى العقيدة الصحيحة حاجة ملحة.
7- للعقيدة التي يَحملها الإنسان أثرًا في توجيه سلوكه وتصرفاته، وأن أي انحراف في هذه العقيدة، أو ضياع لهذه العقيدة، يظهر في حياة الإنسان العملية والخلقية، ومن ثم يؤثر ذلك بشكل ملموس في حياة المجتمع؛ لأننا لا نستطيع الفصل بين المجتمع وأفراده.
تعلم العقيدة:
وشأن العقيدة شأن الفقه، فمن العقيدة ما هو فرض عين، ومنها ما هو فرض كفاية كالفقه، فالقاعدة: العلم تابع للمعلوم، فالعلم الذي يتوصل به إلى إقامة الفرض يكون فرضًا، والعلم الذي يتوصل به إلى إقامة الواجب يكون واجبًا، والعلم الذي يتوصل به إلى إقامة السنة يكون سنة.
والعقيدة التي هي فرض عين، هي تعلم ما لا يصح الإيمان إلا به؛ كالإيمان بأركان الإيمان الستة على وجه مجمل، والعقيدة التي هي فرض كفاية، هي معرفة هذه الأركان الستة على التفصيل بأدلتها من الكتاب والسنة، ومعرفة شبه المخالفين والرد عليها (4).
لغة تعلم وتعليم العقيدة:
ونعني بها كيف نطرح المسائل الاعتقادية، وكيف نخاطب الناس بأمور العقيدة.
العقيدة بالأساس هي مادة لترقيق القلوب، حيث إن لب موضوعها: الحديث عن الله تعالى وعظمته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وما يجب له من أفعال العباد، وعن أمور الآخرة من الموت وخروج الروح، مرورًا بالقبر ونعيمه وعذابه والبعث والنشور وما يحدث من أمور عظيمة في أرض المحشر من ميزان وعرض، ثم المرور على الصراط إما إلى جنة أو نار.
وموضوعها كذلك الإيمان بالرسالة والرسل والملائكة والغيبيات ونحو ذلك، وكلها مسائل ترقق القلوب وتربطها بما عند الله، وتسمو بالنفوس عن أغلال الأرض.
غير أن المشاهد لواقع تدريس العقيدة وتعليمها الناس، لا يجد لدى الكثيرين من القائمين على ذلك بالتصنيف أو التلقين، سوى الأسلوب الجاف الذي يجعل من دراستها مادة مستثقلة يتمنى الطالب أن لو حفظ كتابها أو حديث معلمه عنها عن ظهر قلب في طرفة عين، كي يريح نفسه من عناء مطالعتها ومدارستها.
إننا نلتمس لدى المصنف أن يكون كتابه ومصنفه عن الله يربط الدارس بالله ويوصل قلبه بما عند الله، وأن يشعر خلال كل صفحة تقلبها أنامله بمزيد من محبة الله بعد التعرف إليه، ونرى أن التجارب في ذلك المضمار نادرة، لعل أجودها وأحسنها سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عمر سليمان الأشقر، حيث يشعر القارئ بأنه قد انفصل عن النمط التقليدي لكتب العقيدة، مع إجلالنا لأصحابها ومحتواها.
الأمر نفسه ينبغي أن يسلكه المعلم والمربي عندما يجلس إليه الطالب أو المدعو، حيث لا بد من صياغة حية لمسائل العقيدة تحقق المراد منها؛ من ربط القلب ووصله بخالقه وبارئه.
ولا بد أن نبتعد عن مسلك «رصّ المعلومات» في تدريس العقيدة، فالمراد هو تحريك القلوب بها، وهذا ما نلمسه بوضوح في المنهج النبوي.
فلينظر الداعية كيف يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر من صميم الاعتقاد؛ وهو نسبة المطر إلى المنعم به سبحانه وتعالى، ففي حديث زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب» (5).
فالنبي صلى الله عليه وسلم يستغل مناسبة قريبة؛ وهي نزول المطر حتى يشرع في تعليمهم أمور عقيدتهم، ثم تراه يحفز اهتمامهم بسؤال يأخذ بتلابيب القلوب: «أتدرون ماذا قال ربكم؟»، وأي من عباد الله بعد تلك العبارة لا تتوق نفسه لمعرفة ما قاله الرحمن جل في علاه؟! إن هذه التهيئة الحافزة ستصغى لها الآذان وتفتح لها القلوب، ليسكب فيها النبي صلى الله عليه وسلم من رحيق العقيدة الصافية.
فهذا هو المراد، أن يعيش الدارس والمتعلم مع مسائل العقيدة بكيانه ووجدانه لا عقله فحسب، حينها سيؤتي تدريس العقيدة الإسلامية ثماره المرجوة، وينطلق به المتعلم والدارس لتشييد صرح حضاري سامق على غرار ما فعل أسلافنا.
خطاب يتواكب مع الواقع:
العقيدة الإسلامية مستهدفة، وتشرئب الأفكار الباطلة المناهضة لها بكرة وعشيًا، الأمر الذي يتطلب أن يكون الخطاب العقدي مسايرًا للواقع.
فعلى سبيل المثال: المد الإلحادي وانتشار خبثه في حقبة ما يلزم أن يركز الدعاة والمربون والمعلمون خطابهم في العقيدة على إثبات وجود الله وتوحيد الربوبية وسوق الأدلة القرآنية والنبوية والبراهين العقلية على وجود الله وأفعاله في الكون.
وإذا حمي وطيس المعارك مع الشيعة في مكان ما، وبدأ خطرهم على العقيدة يزداد؛ يلزم حينها أن يكون التركيز في الخطاب العقدي على بيان بطلان عقائدهم، وبيان عقيدة أهل السنة في القرآن الكريم وحفظ الله له عن التحريف، وبيان اعتقادهم في الصحابة وعدالتهم ومنزلتهم، ونحو ذلك.
وفي الأماكن والحقب التي ينشط فيها المتصوفة، يكون التركيز في خطاب الداعية على المعجزة والكرامة، وبيان من هو الولي، والتركيز على توحيد الألوهية والتحذير من صرف أي عبادة إلا لله، وحكم الدعاء والاستغاثة بغير الله.
ويُستخلص ذلك العنصر من منهج القرآن في مسايرة الأحداث، والتركيز على ترسيخ معاني العقيدة بما يناسب المقام.
ففي الوقت الذي كان فيه المسلمون مستضعفين في مكة ويسامون سوء العذاب على أيدي صناديد الكفر، كان القرآن يركز على أمور الاعتقاد باليوم الآخر، وما عند الله من النعيم الذي أعده لأصفيائه وأوليائه الذين صبروا على أمره، يقول د. علي الصلابي: ركز القرآن المكي على اليوم الآخر غاية التركيز، فقل أن توجد سورة مكية لم يذكر فيها بعض أحوال يوم القيامة وأحوال المنعمين وأحوال المعذبين، وكيفية حشر الناس ومحاسبتهم، وحتى لكأن الإنسان ينظر إلى يوم القيامة رأي العين (6).
ولما تكونت الدولة الإسلامية الأولى في المدينة، وظهر المسلمون على عدوهم في بدر؛ نجم النفاق وتكوّن الطابور الخامس في المجتمع الإسلامي، فكان التركيز القرآني على النفاق الاعتقادي وعقائد المنافقين وسيماهم، وما أعده الله لهم من عذاب أليم يوم القيامة.
فترى في بدايات سورة البقرة –وهي مدنية- يتناول القرآن الكريم بعض ملامح إطارهم العقدي من إبطان الكفر وإظهار الإسلام، وعداوة ومخادعة أهل الإيمان، وما يعتمل في قلوبهم من ريبة، وعاقبتهم في الدنيا والآخرة، يقول الله تبارك وتعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ... أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16)} [البقرة: ٨- 16].
والمراد مما سبق عرضه أن يدرك المتصدر لتعليم الناس أمور عقيدتهم أهمية مسايرتها للواقع، بحيث يركز على ترسيخ المعاني العقدية التي يواجه الناس بها واقعهم.
العقيدة بين التهميش والاستغراق:
هناك طريقتان لدى أهل السنة في تقسيم أنواع التوحيد مؤداهما واحد، فالطريقة الأولى تقسم التوحيد إلى قسمين اثنين:
الأول: التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، المتضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل، وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل، وتنزيهه عن صفات النقص، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات.
والثاني: التوحيد الطلبي القصدي الإرادي؛ وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وتجريد محبته والإخلاص له، وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه، والرضا به ربًّا وإلهًا ووليًا، وأن لا يجعل له عدلًا في شيء من الأشياء، وهو توحيد الإلهية (7).
والطريقة الثانية؛ قال بها بعض العلماء هي: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات.
وذلك أن تناول هذا النوع من التوحيد يترنح في المحاضن العلمية بين تهميشه لدى طرف، والاستغراق فيه وجعل قضية إثبات وجود الله وربوبيته على خلقه هي غاية علم التوحيد لدى طرف ثان.
فتجد مثلًا في كتب المناهج الدراسية الأزهرية والمتأثرة بمذهب الأشاعرة في الاعتقاد، أن محتواها ينصب على الحديث عن إثبات وجود الله وربوبيته على خلقه، وعلى الإيمان بالأسماء والصفات على ما به من عوار في مسألة تأويل الصفات.
وأما توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة، فلا تجد له ذكرًا في كتب التوحيد هذه، مع أنه أصل دعوة الرسل، حيث أنه يواجه الانحراف الذي طرأ على الفطرة الشاهدة على وحدانية الله، فما نال ذلك الانحراف من عقيدة البشر كمثل ما نال من توحيد الألوهية، حيث صرف الناس عن مقتضى فطرتهم، وكما في الحديث القدسي: «وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا» (8).
فكل الأمم في جميع الأزمنة لم يكن لديها ما يقدح في توحيد الربوبية سوى قليل منها، كالدهرية والمجوس الثنوية قديمًا والشيوعية في عصرنا هذا، بل جلّ الشرك قد انصب على جانب الألوهية.. وكان الشرك لدى مشركي العرب يتمثل في اتخاذهم معبودات باطلة من دون الله مع اعتقادهم أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وهو ما يستفاد من قوله تعالى: {وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الْـحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ} [لقمان: 25].
وكانت نتيجة الاستغراق في جانب توحيد الربوبية أو التوحيد العلمي الخبري بصفة عامة وإهمال جانب توحيد العبادة (توحيد الألوهية)؛ أن صار هناك من حملة العلم وذوي الشهادات والدرجات العلمية الرفيعة من تلبّس بقوادح عقدية فادحة، كالاستغاثة ودعاء غير الله.
وفي المقابل نرى كثيرًا من كتب العقيدة لدى الاتجاه السلفي لا تعطي توحيد الربوبية حقه في التناول، مبررين ذلك بما بيّناه سالفًا من أن جميع البشر إلا القليل مقرين بتوحيد الربوبية، ومن ثم فالإسهاب في عرضه من الحشو غير المبرر.
ويعيب هذا المسلك أنه يبني بغير أساس قوي، فتوحيد الربوبية هو الأساس لجميع مفردات التوحيد الأخرى، فهو أساس لتوحيد الألوهية؛ لأن الفاعل المطلق في الكون ومدبره ومن بيده أمر الخلق، هو وحده الذي يستحق أن يتوجه العبد إليه بالعبادة، وهو التفسير الحق لمعنى (لا إله إلا الله)، أي: لا معبود بحق إلا الله.
ومن ناحية أخرى هو أساس لتوحيد الأسماء والصفات؛ لأن الرب الخالق المدبر مصرف شؤون عباده هو وحده الجدير بكل صفات الجلال والكمال والتنزه عن جميع النقائص والعيوب.
فالاقتصار على مجرد الإشارات المختصرة في تناول توحيد الربوبية يجعل البناء التعبدي ضعيفًا، فالعبد لا ينشط للعبادة ويؤديها بتمامها على الوجه المراد ويحافظ عليها إلا إذا عرف ربه تبارك وتعالى، وشاهد في شؤون خلقه دلائل عظمته وربوبيته.
والمراد مما سبق عرضه أنه ينبغي أن يكون هناك توازن في تناول توحيد الربوبية، ويعطى حقه دون إجحاف أو استغراق.
ربط العقيدة بالعمل:
وهذا أمر جدّ عظيم، فليست العقيدة الإسلامية مجموعة من المعلومات النظرية التي تختزنها ذاكرة العبد ولا تتجاوزها إلى الواقع؛ بل العقيدة التي ينتفع بها العبد وينجو بها يوم القيامة هي التي تترجم إلى واقع عملي، ويكون لها أثر ظاهر في الحياة.
ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص في تدريس العقيدة على ربطها بالعمل، فعن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم سترون ربكم عيانًا» (9)، وفي رواية: قال: كنا جلوسًا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا»، ثم قرأ {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا} [طه: 130] (10).
فلم يكتف رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعليمهم مسألة عقائدية مهمة؛ وهي إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة؛ وإنما وجه إلى العمل بمقتضى ذلك العلم، وحول الحديث إلى برنامج عملي وهو الصلاة.
ويأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله: متى الساعة يا رسول الله؟ فهذا رجل يطرح سؤالًا عقائديًا قد أجاب عنه القرآن بأن علمها مرده إلى الله، وكذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، ولم يزد النبي على أن قال: «ما أعددت لها؟» (11).
فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى التركيز على الجانب العملي في قضية وقت قيام الساعة، لا الانشغال بأمر علمه لله سبحانه وتعالى لم يُطلع عليه عباده وفق حكمته التي لا تنفك عنه سبحانه.
ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنه يدخل الجنة من أمته 70 ألفًا بغير حساب ولا عذاب، أرشدهم إلى ما ينال به ذلك المقام وتلك المكرمة من العمل والجد والاجتهاد، فقال: «هم الذين لا يرقون، ولا يسترقون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون» (12).
فيجدر بمن يتصدر لتعليم الناس أمور عقيدتهم أن يقرنها بالعمل؛ فعلى سبيل المثال عندما يتحدث عن توحيد الربوبية يوجههم إلى عبادة التفكر والتأمل في خلق الله، وإذا تحدث عن الأسماء والصفات أرشدهم إلى الدعاء بها والعمل بمقتضاها، وإذا تحدث عن الميزان مثلًا وجّههم إلى محاسبة النفس، وإذا تحدث عن الجنة أرشدهم إلى المحافظة على الفرائض واجتناب الذنوب... وهكذا.
استخدام الوسائل العملية في تدريس العقيدة:
فلا بد من التعاطي مع الواقع والاستفادة منه في مجال تدريس العقيدة، وتسخير آليات العصر وإمكانياته في ترسيخ معانيها.
فإذا أراد المعلم أن يتحدث عن دلائل عظمة الله مثلًا، فما المانع من أن يدعم حديثه بمقاطع مرئية (فيديو) عن الكون والمجرات وتكوّن الجنين والبراكين والمخلوقات متناهية الدقة... وهكذا؟!
ويصلح مع الأطفال إضافة إلى ذلك: الأناشيد ذات المعاني العقائدية، واللوحات الإرشادية التي ترسخ المعاني عن طريق النظر إليها.
كما يستشهد المعلم المتصدر لتدريس العقيدة بالأخبار والوقائع الحادثة التي تعضد تلك المعاني؛ فمثلًا: عندما يتناول قضايا الشرك بالله يعضد حديثه برصد واقع المزارات والأضرحة وولع كثير من الناس بها وما يحدث عندها من الأمور الشركية وصرف العبادة لغير الله.
وإذا تحدث عن أسماء الله المتضمنة القهر والجبروت والقوة، يستشهد بالزلازل والخسوف والبراكين والأعاصير التي تجتاح البلدان التي أوغلت في الكفر والرذائل قديمًا، كما حدث في قرية بومبي الإيطالية التي غطتها الحمم البركانية في عهد الإمبراطورية الرومانية، أو إعصار كاترينا بالولايات المتحدة، أو تسونامي، وغير ذلك مما يظن أنه انتقام من الله سبحانه وتعالى ومحض عقاب.
ومسألة تدريس العقيدة تحتاج من القائمين عليها إلى المراجعة الدورية؛ لأنها بصورتها الحقيقية طريق فلاح العبد، وسبيل التمكين لهذه الأمة، كما قال الله تبارك وتعالى: {وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِـحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا} [النور: ٥٥] (13).
محاذير في تعليم العقيدة:
- أن لا يبدأ من يريد تعليم العقيدة الصحيحة ونشرها بين الناس، بأسلوب رد الشبهات المثارة حولها، ومناقشة الخلافات الواردة فيها؛ بل يبدأ بتقرير العقيدة الصحيحة، وإبراز أهميتها، والأدلة عليها، ومحاسنها على وجه تتلاشى أمامه الشبهات القائمة أو المتوقعة تلقائيًا، وذلك حتى لا تتداخل الشبهات مع أصل العقيدة، فتعكر من صفائها، أو تعقّد من فهمها..
أولًا: وتوافقًا مع ملامح المنهج الرباني الذي يبدأ بتقرير العقيدة الصحيحة، وتثبيتها في النفوس البشرية وتحصينها، قبل أن يبدأ بإبطال العقائد الفاسدة السائدة، ومناقشة شبهاتها.
ثانيًا: وانسجامًا مع الفطرة البشرية السليمة التي تتقبل الحق وتقبل عليه، وترفض الباطل وتنفر منه.
- أن تُتجنب في تقرير العقيدة وتعليمها للناس الأساليب الكلامية، والمناهج الفلسفية التي صيغت بها كثير من كتب العقائد في عصور سابقة، وأن تقدم العقيدة إلى الناس من خلال النصوص القرآنية، والأحاديث النبوية التي عرضت بها في الصدر الأول
فكثيرًا ما يعود بعد الناس اليوم عن كتب العقيدة خاصة، وإعراضهم عنها، إلى أسلوب صياغتها واعتمادها على أساليب علم الكلام والمنطق، التي كانت سائدة في بعض العصور السابقة، ومقبولة سائغة من قبل أهل تلك العصور، حتى أصبحت مادة العقيدة الإسلامية عند كثير من الدارسين لها في المعاهد والجامعات من أصعب المواد التعليمية، وأعقد الدراسات الشرعية.
فلا بد من العمل على صياغة المسائل العقدية في كتب العقيدة، ولا سيما للمبتدئين بأسلوب سهل واضح يناسب لغة العصر، وفهم أهله، وأن تؤخذ الأمثلة الناطقة بها من واقع الناس ومشاهداتهم وأن تربط مسائل العقيدة اليوم، بواقع الناس وسلوكهم، بدلًا من أن يمثل لها بأمثلة تاريخية قديمة، ومواقف تاريخية سابقة.
ولا تعني التشطيب على الكتب العلمية القديمة، وتجاهل بعض المسائل العقدية الهامة، وإنما تترك للمتخصصين في علم العقيدة والباحثين فيها، الذين وضح لهم الحق من الضلال، وتميز لديهم الصحيح من الفاسد من جهة، والذين تجب عليهم الإفادة من تراث السابقين وأساليبهم في معالجة مشكلات عصرهم من جهة أخرى، فإن في مثل هذه الكتب من الفوائد ما لا يستغني عنه أمثال هؤلاء.
- لا تصاغ المسائل العقدية على شكل تصورات عقلية، أو محاكماتٍ فكرية مجردة، أو تكون عبارة عن لمسات عاطفية، ومشاعر وجدانية بعيدة عن العقل والتفكر، بل لا بد أن من أن تلامس هذه الكتابات والمقالات روح الإنسان كما تلامس عقله، وتخاطب الفكر كما تخاطب الوجدان، وأن يُتحدث عن خصائص العقيدة الإسلامية وآثارها في النفس البشرية بالتفصيل، كما تقرر أحكامها ومسائلها بالتفصيل، وإلا كانت عقيدة نظرية مجردة، أكثر منها عقيدة عملية مؤثرة.
فإنه بقدر المزج بين العقل والعاطفة في الكتابات العقدية من جهة، وبقدر الجمع بين الأحكام والآثار، وتوثيق ربطها بها من جهة أخرى، تفعل العقيدة الإسلامية فعلها في النفوس، وتتجلى آثارها العملية في حياة الناس، وبقدر الفصل والبعد في كتب العقيدة بين العقل والعاطفة، والحكم والأثر، تصبح العقيدة في النفوس البشرية مجرد مشاعر وجدانية، أو محاكمات فكرية جافة، أو نظريات مجردة بعيدة عن التطبيق.
- الابتعاد عن التشنيع والتسفيه، فينبغي أن يُغلب على أسلوبه في دعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة ونهيهم عن العقيدة الفاسدة، أسلوب الموعظة الحسنة على أسلوب المجادلة، وأسلوب الإشفاق والرحمة بالمدعوين على أسلوب الإنكار والتشنيع عليهم، فيختار لذلك الأسلوب المحبب، واللفظ المؤدب.
فلا ينادى الكافر عند دعوته إلى الإسلام بلقب الكافر، ولا يخاطب الضال والمبتدع بلقب الضال والمبتدع، وما إلى ذلك من ألقاب اعتاد بعض الناس أن يوزعها على المدعوين والمخالفين، فيقابلهم الناس بمثلها أو أسوأ منها، وإنما ينبغي عليه أن يخاطبهم -إن كان داعية بصيرًا- بروح الإخوة والمودة والمحبة، فيختار الألفاظ والألقاب المحببة إلى النفوس، والمؤثرة فيها، والجاذبة لها، وإلا كان منفرًا فتانًا قبل أن يكون ميسرًا مبشرًا، وهاديًا مهديًا (14).
----------
(1) أخرجه مسلم (19).
(2) شرح المحرر في الحديث/ عبد الكريم الخضير (51/ 8)، بترقيم الشاملة آليًا.
(3) سير أعلام النبلاء (8/ 353).
(4) مدخل إلى علم العقيدة/ المجلس العلمي.
(5) أخرجه البخاري (846)، ومسلم (71).
(6) السيرة النبوية للصلابي (ص: 104).
(7) معارج القبول (1/ 98).
(8) أخرجه مسلم (2865).
(9) أخرجه البخاري (7435).
(10) أخرجه البخاري (554)، ومسلم (633).
(11) أخرجه البخاري (6167).
(12) أخرجه مسلم (220).
(13) بصائر في تدريس العقيدة/ مجلة البيان (العدد: 324).
(14) القضايا الكلية للاعتقاد في الكتاب والسنة، بترقيم الشاملة آليًا.
