التدريب العملي على الأخلاق الحسنة
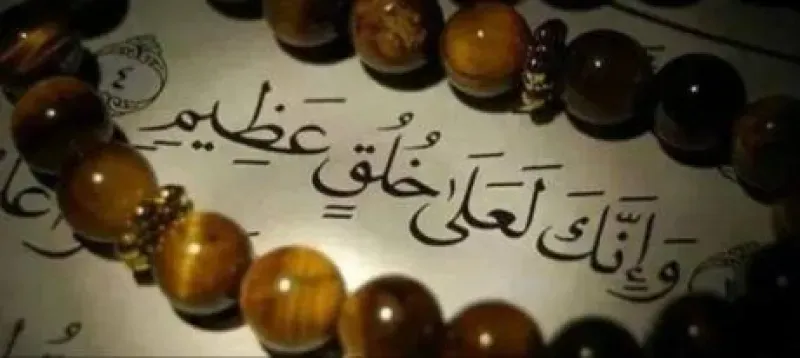
الخلق الحسن صفة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأفضل أعمال الصديقين، وهو على التحقيق شطر الدين وثمرة مجاهدة المتقين ورياضة المتعبدين.
والأخلاق السيئة هي السموم القاتلة، والمهلكات الدامغة، والمخازي الفاضحة، والرذائل الواضحة، والخبائث المبعدة عن جوار رب العالمين، المنخرطة بصاحبها في سلك الشياطين، وهي الأبواب المفتوحة إلى نار الله تعالى الموقدة التي تطلع على الأفئدة، كما أن الأخلاق الجميلة هي الأبواب المفتوحة من القلب إلى نعيم الجنان وجوار الرحمن، والأخلاق الخبيثة أمراض القلوب وأسقام النفوس، ولا يخلو قلب من القلوب عن أسقام، لو أهملت تراكمت وترادفت العلل وتظاهرت، فيحتاج العبد إلى تأنق في معرفة علمها وأسبابها، ثم إلى تشمير في علاجها وإصلاحها، فمعالجتها هو المراد بقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا} [الشمس: 9]، وإهمالها هو المراد بقوله: {وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} [الشمس: 10]، وغرضنا الآن النظر الكلي في تهذيب الأخلاق وتمهيد منهاجها (1).
لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لم يكن للمواعظ والوصايا معنى، وكيف ننكر تغيير الأخلاق ونحن نرى الصيد الوحشي يستأنس، والكلب يعلم ترك الأكل، والفرس تعلم حسن المشي وجودة الانقياد، إلا أن بعض الطباع سريعة القبول للصلاح، وبعضها مستصعبة، وإنما المطلوب من الرياضة رد الشهوة إلى الاعتدال الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط، وأما قمعها بالكلية فلا، كيف؛ والشهوة إنما خلقت لفائدة ضرورية في الجبلة، ولو انقطعت شهوة الطعام لهلك الإنسان، أو شهوة الوقاع لانقطع النسل، ولو انعدم الغضب بالكلية، لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يهلكه، وقد قال الله تعالى: {أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ} [الفتح: 29]، ولا تصدر الشدة إلا عن الغضب، ولو بطل الغضب لامتنع جهاد الكفار، وقال تعالى: {وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ} [آل عمران: 134]، ولم يقل: الفاقدين الغيظ (2).
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: «لا تغضب»، فردد مرارًا، قال: «لا تغضب» (3).
قال الخطابي معنى قوله: «لا تغضب» اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه، وأما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه؛ لأنه أمر طبيعي لا يزول من الجبلة.
وقال غيره: ما كان من قبيل الطبع الحيواني لا يمكن دفعه فلا يدخل في النهي؛ لأنه من تكليف المحال، وما كان من قبيل ما يكتسب بالرياضة فهو المراد.
وقيل: معناه لا تغضب لأن أعظم ما ينشأ عنه الغضب الكبر لكونه يقع عند مخالفة أمر يريده، فيحمله الكبر على الغضب، فالذي يتواضع حتى يذهب عنه عزة النفس يسلم من شر الغضب.
وقيل: معناه لا تفعل ما يأمرك به الغضب.
وقال ابن بطال: إن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو؛ لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الذي يملك نفسه عند الغضب أعظم الناس قوة.
وقال البيضاوي: لعله لما رأى أن جميع المفاسد التي تعرض للإنسان إنما هي من شهوته ومن غضبه، وكانت شهوة السائل مكسورة، فلما سأل عما يحترز به عن القبائح نهاه عن الغضب الذي هو أعظم ضررًا من غيره، وأنه إذا ملك نفسه عند حصوله كان قد قهر أقوى أعدائه.
ويترتب على الغضب تغير الظاهر والباطن؛ كتغير اللون والرعدة في الأطراف، وخروج الأفعال عن غير ترتيب واستحالة الخلقة حتى لو رأى الغضبان نفسه في حال غضبه لكان غضبه حياء من قبح صورته واستحالة خلقته، هذا كله في الظاهر، وأما الباطن فقبحه أشد من الظاهر؛ لأنه يولد الحقد في القلب والحسد، وإضمار السوء على اختلاف أنواعه؛ بل أولى شيء يقبح منه باطنه وتغير ظاهره ثمرة تغير باطنه، وهذا كله أثره في الجسد، وأما أثره في اللسان فانطلاقه بالشتم والفحش الذي يستحي منه العاقل، ويندم قائله عند سكون الغضب.
ويظهر أثر الغضب أيضًا في الفعل بالضرب أو القتل، وإن فات ذلك بهرب المغضوب عليه رجع إلى نفسه فيمزق ثوب نفسه ويلطم خده، وربما سقط صريعًا، وربما أغمي عليه، وربما كسر الآنية وضرب من ليس له في ذلك جريمة، ومن تأمل هذه المفاسد عرف مقدار ما اشتملت عليه هذه الكلمة اللطيفة من قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تغضب» (4).
فهذا الرجل ظن أنها وصية بأمر جزئي، وهو يريد أن يوصيه النبي صلّى الله عليه وسلم بكلام كلي، ولهذا ردد، فلما أعاد عليه النبي صلّى الله عليه وسلم عرف أن هذا كلام جامع، وهو كذلك؛ فإن قوله: «لا تغضب» يتضمن أمرين عظيمين:
أحدهما: الأمر بفعل الأسباب، والتمرن على حسن الخلق، والحلم والصبر، وتوطين النفس على ما يصيب الإنسان من الخلق، من الأذى القولي والفعلي، فإذا وفِّق لها العبد، وورد عليه وارد الغضب احتمله بحسن خلقه، وتلقاه بحلمه وصبره، ومعرفته بحسن عواقبه؛ فإن الأمر بالشيء أمر به، وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء أمر بضده، وأمر بفعل الأسباب التي تعين العبد على اجتناب المنهي عنه، وهذا منه.
الثاني: الأمر -بعد الغضب- أن لا ينفذ غضبه؛ فإن الغضب غالبًا لا يتمكن الإنسان من دفعه ورده، ولكنه يتمكن من عدم تنفيذه، فعليه إذا غضب أن يمنع نفسه من الأقوال والأفعال والمحرمة التي يقتضيها الغضب.
فمتى منع نفسه من فعل آثار الغضب الضارة، فكأنه في الحقيقة لم يغضب، وبهذا يكون العبد كامل القوة العقلية، والقوة القلبية.
فكمال قوة العبد: أن يمتنع من أن تؤثر فيه قوة الشهوة، وقوة الغضب الآثار السيئة، بل يصرف هاتين القوتين إلى تناول ما ينفع في الدين والدنيا، وإلى دفع ما يضر فيهما (5).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» (6).
فأراد عليه السلام أن الذي يقوى على ملك نفسه عند الغضب، ويردها عنه؛ هو القوي الشديد، والنهاية في الشدة، لغلبته هواه المردي الذي زينه له الشيطان المغوي، فدل هذا أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو؛ لأن النبي عليه السلام جعل للذي يملك نفسه عند الغضب من القوة والشدة ما ليس للذي يغلب الناس ويصرعهم (7).
أي: إنما القوي من كظم غيظه عند ثوران الغضب، وقاوم نفسه، وغلب عليها تحول المعنى فيه من القوة الظاهرة إلى القوة الباطنة، ومن ملك نفسه عنده فقد قهر أقوى أعدائه وشر خصومه لخبر أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، وهذا من قبيل المجاز وفصيح الكلام؛ لأن الغضبان لما كان بحال شديدة من الغيظ، وقد ثارت عليه ثورة الغضب وقهرها بحلمه وصرعها بثباته كان كمن يصرع الرجال ولا يصرعونه (8).
إن للإنسان إرادة وهدفًا وتصورًا خاصًا للحياة يقوم على أصولها الصحيحة، المتلقاة من الله خالق الحياة، فإذا فقد هذا كله فقد أهم خصائص الإنسان المميزة لجنسه، وأهم المزايا التي من أجلها كرمه الله (9).
ولذلك جاء في الحديث: عن سهل بن معاذ، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كظم غيظًا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله عز وجل على رءوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء» (10).
قال الطيبي: وإنما حمد الكظم؛ لأنه قهر للنفس الأمارة بالسوء، ولذلك مدحهم الله تعالى بقوله: {وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ} [آل عمران: 134] (11).
فالغيظ انفعال بشري، تصاحبه أو تلاحقه فورة في الدم فهو إحدى دفعات التكوين البشري، وإحدى ضروراته، وما يغلبه الإنسان إلا بتلك الشفافية اللطيفة المنبعثة من إشراق التقوى وإلا بتلك القوة الروحية المنبثقة من التطلع إلى أفق أعلى وأوسع من آفاق الذات والضرورات.
وكظم الغيظ هو المرحلة الأولى، وهي وحدها لا تكفي، فقد يكظم الإنسان غيظه ليحقد ويضطغن فيتحول الغيظ الفائر إلى إحنة غائرة ويتحول الغضب الظاهر إلى حقد دفين.. وإن الغيظ والغضب لأنظف وأطهر من الحقد والضغن.. لذلك يستمر النص ليقرر النهاية الطليقة لذلك الغيظ الكظيم في نفوس المتقين.. إنها العفو والسماحة والانطلاق..
إن الغيظ وقر على النفس حين تكظمه وشواظ يلفح القلب ودخان يغشى الضمير.. فأما حين تصفح النفس ويعفو القلب، فهو الانطلاق من ذلك الوقر، والرفرفة في آفاق النور، والبرد في القلب، والسلام في الضمير (12).
إن التدريب العملي والممارسة التطبيقية ولو مع التكلف في أول الأمر، وقصر النفس على غير ما تهوى، من الأمور التي تكسب النفس الإنسانية العادة السلوكية، طال الزمن أو قصر.
والعادة لها تغلغل في النفس يجعلها أمرًا محببًا، وحين تتمكن في النفس تكون بمثابة الخلق الفطري، وحين تصل العادة إلى هذه المرحلة تكون خلقًا مكتسبًا، ولو لم تكن في الأصل الفطري أمرًا موجودًا.
وقد عرفنا أنَّ في النفس الإنسانية استعدادًا فطريًّا لاكتساب مقدار ما من كلِّ فضيلة خلقية، وبمقدار ما لدى الإنسان من هذا الاستعداد تكون مسؤوليته، ولو لم يكن لدى النفوس الإنسانية هذا الاستعداد لكان من العبث اتخاذ أية محاولة لتقويم أخلاق الناس.
والقواعد التربوية المستمدة من الواقع التجريبي تثبت وجود هذا الاستعداد، واعتمادًا عليه يعمل المربون على تهذيب أخلاق الأجيال التي يشرفون على تربيتها، وقد ورد في الأثر: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحر الخير يعطه، ومن يتوق الشر يوق (13).
وثبت أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «ومن يستعفف يعفَّه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله» (14).
هذا الحديث اشتمل على أربع جمل جامعة نافعة:
إحداها قوله: «ومن يستعفف يعفه الله»، والثانية قوله: «ومن يستغن يغنه الله».
وهاتان الجملتان متلازمتان، فإن كمال العبد في إخلاصه لله رغبة ورهبة وتعلقًا به دون المخلوقين، فعليه أن يسعى لتحقيق هذا الكمال، ويعمل كل سبب يوصله إلى ذلك، حتى يكون عبدًا لله حقًا حُرًّا من رق المخلوقين.
وذلك بأن يجاهد نفسه عن أمرين: انصرافها عن التعلق بالمخلوقين بالاستعفاف عما في أيديهم، فلا يطلبه بمقاله ولا بلسان حاله، ولهذا قال صلّى الله عليه وسلم لعمر: «ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسَك» (15)، فقطع الإشراف في القلب والسؤال باللسان، تعففًا وترفعًا عن مِنن الخلق، وعن تعلق القلب بهم، سبب قوي لحصول العفة.
وتمام ذلك: أن يجاهد نفسه على الأمر الثاني: وهو الاستغناء بالله، والثقة بكفايته، فإنه من يتوكل على الله فهو حسبه، وهذا هو المقصود، والأول وسيلة إلى هذا؛ فإن من استعف عما في أيدي الناس وعما يناله منهم: أوجب له ذلك أن يقوى تعلقه بالله، ورجاؤه وطمعه في فضل الله وإحسانه، ويحسن ظنه وثقته بربه، والله تعالى عند حسن ظن عبده به إن ظن خيرًا فله: وإن ظن غيره فله، وكل واحد من الأمرين يمد الآخر فيقويه، فكلما قوي تعلقه بالله ضعف تعلقه بالمخلوقين وبالعكس (16).
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاهم، ثم سألوه، فأعطاهم، ثم سألوه، فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال: «ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر» (17).
وضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلًا دلَّ فيه على أنَّ التدريب العملي ولو مع التكلف يكسب العادة الخلقية، حتى يصير الإنسان معطاء غير بخيل، ولو لم يكن كذلك أول الأمر.
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده، حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئًا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع» (18).
فدلَّ هذا الحديث على أن المنفق والبخيل كانا في أول الأمر متساويين في مقدار الدرعين.
أما المنفق فقد ربت درعه بالإنفاق حتى غطت جسمه كلِّه، بخلاف البخيل الذي لم يدرب نفسه على الإنفاق، فإن نفسه تكز، والله يضيق عليه من وراء ذلك، فيكون البخل خلقًا متمكنًا من نفسه مسيطرًا عليها.
ومن ذلك نفهم أمرين: فطرية الخلق، وقابليته للتعديل بالممارسة والتدريب العملي، إنَّ المنفق كان أول الأمر كالبخيل يشبهان لابسي درعين من حديد متساويين ويبدو أن الدرع مثال لما يضغط على الصدر عند إرادة النفقة، فمن يتدرب على البذل تنفتح نفسه كما يتسع الدرع فلا يكون له ضغط، وأما من يعتاد الإمساك فيشتد ضاغط البخل على صدره، فهو يحس بالضيق الشديد كلما أراد البذل، ومع مرور الزمن يتصلب هذا الضاغط.
واعتمادًا على وجود الاستعداد الفطري لاكتساب الخلق، وردت الأوامر الدينية بفضائل الأخلاق، ووردت النواهي الدينية عن رذائل الأخلاق.
ولكن من الملاحظ أنه قد يبدأ التخلق بخلق ما عملًا شاقًّا على النفس، إذا لم يكن في أصل طبيعتها الفطرية، ولكنه بتدريب النفس عليه، وبالتمرس والمران، يصبح سجية ثابتة، يندفع الإنسان إلى ممارسة ظواهرها اندفاعًا ذاتيًّا، دون أن يجد أية مشقة أو معارضة أو عقبة من داخل نفسه، ولئن وجد شيئًا من ذلك فإنَّ دافع الخلق المكتسب يظلُّ هو الدافع الأغلب، بشرط أن يكون التخلق قد تحول فعلًا إلى خلق مكتسب.
وليس التدريب النفسي ببعيد الشبه عن التدريب الجسدي، الذي يكتسب به المهارات العملية الجسدية (19).
وابن آدم مطبوع على سبعة، وهي الغفلة، والشك، والشرك، والرغبة، والرهبة، والشهوة، والغضب، فهذه سبعة أخلاق، فإذا جاءه نور الهداية حتى عرف ربه عز وجل ووحده، ذهبت الغفلة، وذهب الشك والشرك؛ فهو يعلم ربه يقينًا، وينفى عنه الشرك، وزوال الشك عنه، ثم لما جاءت الشهوة، فأظلم الصدر بدخانها وفورانها، ذهب بضوء علمه واستنارته، وتحير في أمر ربه عز وجل كالشاك، وظهر شرك الأسباب، فكلما ازداد العبد معرفة وعلمًا بربه عز وجل، استنار قلبه وصدره، وانتقص من الغفلة، ومن هذه الخصال السبع كلها، حتى يمتلئ صدره من عظمة الله عز وجل وجلاله، فعندها كشف الغطاء، وصار يقينًا، وزايله شرك الأسباب، وماتت الشهوة، وذهب الغضب، وذهبت الرغبة والرهبة، فلا يرغب إلا إلى الله عز وجل، ولا يرهب إلا منه، ولا يغضب إلا في ذات الله عز وجل ولله، ولا يشتغل بشهوة إلا بذكر الله عز وجل (20).
مع مراعاة المخالفات الشرعية في تهذيب النفس وتدريبها على حسن الخلق، فقد يقع المرء فيما لا يقبل شرعًا ولا وضعًا، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا إسرائيل قائمًا في الشمس، فقال: «ما له قائم في الشمس؟» قالوا: نذر أن يصوم، وأن لا يجلس ولا يستظل قال: «مروه فليجلس، وليستظل، وليصم» فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالصوم الذي هو طاعة، وترك القيام في الشمس، إذ لا طاعة في القيام في الشمس، وإن كان القيام في الشمس ليس بمعصية، إلا أن يكون فيه تعذيب، فيكون حينئذ معصية (21).
وعن ابن عباس، قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مره فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه» (22).
نذر هذا الصحابي ترك الكلام والطعام والشراب وأن يقف في الشمس ولا يستظل؛ وهذا فيه تعذيب للنفس ومشقة عليها، وهذا نذر محرم، لهذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن أمره أن يتم صومه لأنه عبادة مشروعة، وعليه من نذر عبادة مشروعة لزمه فعلها ومن نذر عبادة غير مشروعة فإنه لا يلزمه فعلها.
الأجـر يكون على قـدر المشقة إذا كانت المشقة لازمة للتكاليف الشرعية، وأما إذا كانت المشقة غير لازمة لها فلا يصح للمكلف أن يجلبها على نفسه ظانًا أن ذلك طريقة للأجر والثواب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خذوا من الأعمال ما تطيقون» (23).
عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: «ما هذا الحبل؟» قالوا: هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا حلوه ليصل أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد» (24).
----------
(1) موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين (ص: 175).
(2) أرشيف منتدى الألوكة/ الموسوعة الشاملة.
(3) أخرجه البخاري (6116).
(4) فتح الباري لابن حجر (10/ 520).
(5) بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار (ص: 163).
(6) أخرجه البخاري (6114)، ومسلم (2609).
(7) شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ 296).
(8) فيض القدير (5/ 358).
(9) في ظلال القرآن (6/ 3290).
(10) أخرجه أبو داود (4777).
(11) عون المعبود وحاشية ابن القيم (13/ 95).
(12) في ظلال القرآن (1/ 475).
(13) تفسير القرطبي (6/ 60).
(14) أخرجه البخاري (1469)، ومسلم (1053).
(15) أخرجه البخاري (1473)، ومسلم (1045).
(16) بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار (ص: 88).
(17) أخرجه البخاري (1469)، ومسلم (1053).
(18) أخرجه البخاري (1443).
(19) مقدمات في الأخلاق الإسلامية/ موقع الدرر السنية.
(20) رياضة النفس (ص: 74).
(21) أخرجه ابن خزيمة (2242).
(22) أخرجه البخاري (6704).
(23) أخرجه البخاري (5861)، ومسلم (782).
(24) أخرجه البخاري (1150)، ومسلم (784).
