التأصيل العلمي للعمل الدعوي
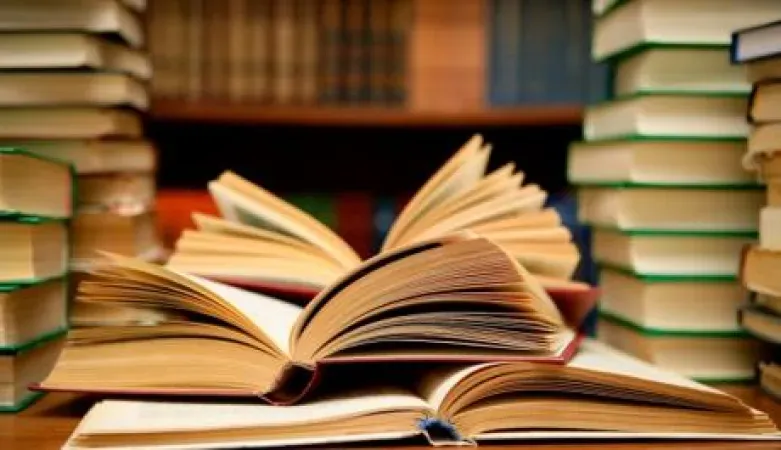
للدعاة إلى الله في عصر التقنية والثورة المعلوماتية جهد مشكور، وفاعلية حقيقية، فها نحن اليوم نعيش عصرًا ينجم عنه كثير من الأفكار الدعوية العملاقة رغم العقبات والأشواك التي تواجه الدعوة ورجالاتها ومؤسساتها، وقد كتب الله تعالى الهداية والاستقامة لفئام من الناس بسبب الجهود الدعوية المضنية، وآتت الدعوة أُكُلَها في كثير من أقطار الأرض.
حتى إن الدعوة الإسلامية لم تكتف بواقع المسلمين، بل شهدناها دخلت البلاد غير الإسلامية، فنلحظ فيها يوميًا إسلام المئات في تلك البلاد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن دولة الإسلام ليست قائمة، وحماة الدين من أهل العلم أقلية، ومؤسسات الدعوة إلى الله قليلة ونادرة، وحملات التشويه والتشكيك بالإسلام أكثر من أن تحصر، وأوضاع المسلمين الكارثية، وكثرة الحروب والقلاقل في بلادهم، وهم يعيشون في بلادهم بأمنٍ ورخاء، ولديهم كافة منتجات الحضارة العمرانية، وأدوات النهضة الصناعية والاقتصادية، ويتراجع عمران المعابد الكنسية من العقائد الباطلة، ومع ذلك كله يزداد الإقبال على الدين الإسلامي، ويزداد المرتادون للمساجد، ويكثر الطلب على المصاحف، وكتب الحديث الشريف، والفضل لله تعالى وحده.
غير أن من يجني الثمار في الحقل الدعوي وساحة العمل الإسلامي سيقع لا محالة في بعض التقصير أو القصور، فهو عرضة للخطأ والزلل أثناء الممارسة الدعوية، وهذا يستدعي وجود مكاشفة ذات شفافية لصقل المرآة الدعوية، وتفعيل مبدأ النصح من لوازم البقاء والنقاء والارتقاء.
فالانطلاق في أمور الدعوة ومناهجها وأساليبها دون الرجوع إلى أصول الشريعة وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، ودون الاهتمام بالمستند الشرعي والدليل العلمي لمنطلقات الدعوة ومناهجها، والاكتفاء بآراء الرجال، والتقليد الأعمى دون تمحيص هذه الآراء، وهل هي توافق مقاصد الشريعة وأصول السيرة النبوية الطاهرة أم لا؟!
إن تربية النشء على قدسية أقوال فلان من الناس، وأنها الحق الذي لا مرية فيه نهج خاطئ منحرف، ومثال واضح لضعف التأصيل أو انعدامه.
كما أن ربط الصحة والخطأ في أمور الدعوة بالعقل والذوق ورغبات الناس هي الأخرى مثال لضعف التأصيل.
والمقصود أن ضعف التأصيل ظاهرة خطيرة، تُرى دائمًا وتظهر في أزمنة الجهل بالشريعة، وضعف العلم الشرعي، وترك الأخذ بالدليل الصحيح، والاستعاضة عن ذلك بآراء الرجال وعقولهم وأهوائهم.
ولتوضيح هذه المسألة أضرب الأمثلة الآتية:
تسويغ كتمان الحق:
هناك من يسوغ كتم الحق بالخوف على النفس من الفتنة، أو بالخوف على الناس من تبعات قول الحق وما يجر عليهم من المفاسد والفتن.
فإن كان من يقول هذا القول قد عرف عنه التقوى والإخلاص والعلم بمقاصد الشريعة؛ فإنه والحالة هذه مسؤول عما يقول؛ وهو إن شاء الله تعالى مأجور على اجتهاده، وليس هو ممن يلبس الحق بالباطل، أو ممن يؤصّل ضعفه ويسوغه بمسوغات شرعية.
أما إن كان صاحب هذا القول ممن عرف عنه قلة الدين واللهث وراء الدنيا، وعرف عنه كتم الحق خوفًا على دنيا فانية، أو طمعًا في متاع زائل؛ فإن موقفه والحالة هذه يعد صورة من صور تأصيل الضعف، ولبس الحق بالباطل، حيث أظهر طمعه وخوفه في صورة الحرص على مقاصد الشريعة ومراعاة المصالح والمفاسد، والله سبحانه هو المطلع على ما في القلوب وهو علام الغيوب.
السكوت عن المنكر:
من المعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الشريعة لا تقوم إلا به، ولكن قد يتركه بعض الناس في بعض الظروف: إما لمسوغ شرعي كتخلف بعض شروطه، أو لضعف وتخاذل مع بقاء هذه الشعيرة على أصلها في النفوس.
أما لو تحول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع مرور الوقت وكثرة المنكرات وضعف الإيمان إلى أن يصبح السكوت وترك الأمر والنهي هو الأصل الذي يبحث له عن المسوغات الشرعية كدرء الفتنة ونحوها، ثم يتحول الأمر والنهي إلى حالة استثنائية لا يقام به إلا عند توفر الشروط التي تضخم لتصبح أقرب إلى التعجيز منها إلى الإمكان.
إذا آل الأمر إلى هذه الحالة فإنه عين اللبْس، وهو تأصيل الضعف، حيث انعكس الأمر؛ فأصبح السكوت والضعف عن هذه الشعيرة العظيمة هو الأصل، وما خالفه من الأمر والنهي هو المستثنى، ونعوذ بالله من الخذلان.
مداراة المشركين:
من المعلوم أن البراءة من المشركين والكفار أصل عظيم من أصول العقيدة، لا يصح إيمان العبد إلا بها، وقد يمر بالمسلم وقت لا يستطيع أن يجاهر بعدائه للكفار، وقد يداريهم في الظاهر؛ لكن قلبه ممتلئ ببغضهم والبراءة منهم.
لكن الخطير في هذا الأمر أن يستمرئ الناس مداراة الكفار في كل حين حتى يتحول الأمر إلى مداهنة وموالاة، وحتى يؤول في النهاية إلى أن تؤصل المداهنة الناشئة عن ضعف الإيمان وحب الدنيا ووهن العزيمة، وتصبح هي الأصل، وما خالفها طارئ وجزئي لا تعارض به، كمن يؤصّل اليوم التسامح الديني وتقارب الأديان بحجة المصلحة الشرعية ونبذ التعصب.
ومثله ما يراد للأمة الإسلامية في السنوات الأخيرة من استسلام مهين مع شرذمة الخليقة وأعداء الرسل اليهود الغاصبين؛ حيث تحوّل الجهاد في سبيل الله تعالى، ووبغض اليهود والنصارى إلى أمر مستغرب، بل ومستنكر أحيانًا، وأصبح التنازل عن هذا كله هو الأصل الذي لا يجوز خَرمه.
لقد أصبح التعايش السلمي واحترام حدود العدو الصهيوني، والسلام الدائم معه، واحترام الشرعية الدولية المدعاة هي الأصول التي لا يسمح بالتنازل عنها والخروج عليها.
وقد أدى هذا الأمر إلى أن يوجد في بعض بلاد المسلمين من يحشد الأدلة والشبهات لتأصيل هذا الخنوع، وإضفاء الشرعية للسلام الدائم مع اليهود (1).
الارتباط بين الدعوة والعلم:
لقد جنى على ساحة الدعوة بعض الدعاة ممن يرزق الواحد منهم قدرة على التأثير الشبابي، ولربّما كان مثلهم في طريقة تفكيرهم وحياتهم العامة قبل الهداية، ولكن ينقصه الكثير من أساليب الدعوة، وهو بذاته لم يدخل أجواء صناعة الداعية الفعلية؛ إذ لم يمتلك الزاد العلمي بالتأصيل العلمي الذي يمكنه من ضبط ألفاظه ومصطلحاته وإجاباته واستشاراته، ولم يعش أجواء الدعوة قبل تأهله للدعوة إلى الله، ولعل من أبرز ذلك شهادة أشياخه وأهل العلم له بذلك، ودوام تواصله معهم.
قد يبدأ بعض الدعاة الشباب بالتأثير على التجمعات الدعوية من خلال مخيمات أو مراكز أو نوادي وغيرها، ويكون لهم حظ ونصيب من حفظ قرآن، ودراسة متن علمي على بعض العلماء، ثم يرون تعلق بعض الشباب بهم، وتجمعهم عليهم، وازدحامهم بعد الانتهاء من محاضراتهم وملتقياتهم، ويَعْظُم في قلب الواحد منهم كثرة متابعيه وجمهوره، فيقلل الزاد في الأخذ عن العلماء، ويستغني عن الرجوع إليهم، وسؤالهم في أعمالهم الدعوية واستشارتهم فيها، فتحصل الجفوة والفجوة المفتعلة من أولئك الدعاة ويبتعدون رويدًا عن أهل العلم.
إن حالة الانتقاص العلمي وما يقابلها من الازدياد الدعوي، مؤثرة للغاية على كثرة وجود الأخطاء في مسيرة الدعوة؛ فعلى الداعية أن يعلم عمق الارتباط والصلة بين الدعوة والعلم، وهي منهجية لا تحتمل المجاملة، وقد قام أهل العلم بالتنبيه عليها، ومنهم الإمام ابن القيم إذ يقول: وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها؛ فهي لا تحصـل إلا بالعلـم الذي يدعو بـه وإليه، بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلـم إلى حد يصل إليه السعي (2).
قال تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [يوسف:108]، فالمسلمون أفرادًا وجماعات، عليهم أن يقوموا بالدعوة إلى الله، وأن تكون دعوتهم على بينة وحجة وإيمان ويقين، وأن تكون دعوتهم وفقًا لدعوته، وتبعًا لها (3).
البصيرة: العلم والبيان والحجة النيرة؛ أي هذه سبيلي التي أنا أدعوكم إليها؛ إنما أدعوكم على بصيرة؛ أي على علم وبيان وحجة قاطعة؛ وبرهان نير؛ ليس كسائر الأديان التي يدعى إليها على الهوى والشهوة بغير حجة ولا برهان (4).
وقال تعالى: {أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ} [محمد: 14]، أي: لا يستوي من هو على بصيرة من أمر دينه، علمًا وعملًا قد علم الحق واتبعه، ورجا ما وعده الله لأهل الحق، كمن هو أعمى القلب، قد رفض الحق وأضله، واتبع هواه بغير هدى من الله، ومع ذلك، يرى أن ما هو عليه من الحق، فما أبعد الفرق بين الفريقين، وما أعظم التفاوت بين الطائفتين، أهل الحق وأهل الغي (5).
تصدر من لا يعلم:
هنالك كثيرًا من الممارسات الخاطئة التي يقع فيها بعض الوعاظ، وقد لا يشعرون وقد يشعرون، ومنها؛ تصدر الجهال في وعظ الناس وقلة الأخذ على أيديهم، وهو ما يجعلهم يقولون ويتصرفون بأشياء لا تليق بمهنة الوعظ الشريفة، مع الإكثار من الكلام المرسل الإنشائي، وتكرار الألفاظ بدون المعاني الجوهرية، وقل أن يؤخذ على يد هؤلاء ولو من تعزير العلماء الربانيين، لهذا يقول أحد أكابر الفقهاء العلامة الشربيني: ولا يأمر ولا ينهى في دقائق الأمور إلا عالم، فليس للعوام ذلك، ويُنكر على من تصدى للتدريس والفتوى والوعظ وليس هو من أهله (6).
ولهذا كتب العلامة الغزالي لبعضهم: أما الوعظ فلست أرى نفسي أهلًا له، لأن الوعظ زكاة نصابه الاتعاظ، فمن لا نصاب له كيف يخرج الزكاة؟ (7).
قال الراغب: حق الواعظ أن يتعظ ثم يعظ ويبصر، ثم يبصِّر ويهتدي ثم يهدي، ولا يكون كدفتر يفيد ولا يستفيد، وألا يجرح مقاله بفعاله، وألا يكذب لسانه بحاله، وقال بعض السلف: إن العالم إذا لم يرد بموعظته وجه الله زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا، وإلا فلا يزداد الناس به إلا تماديًا في الضلال (8).
وقد يغفل بعض الدعاة إبان دعوتهم في أجواء التكسُّب المادي، عن سريان الضعف في عرض مبادئ الدين وعقيدته، فيضعفون عن مواقف الثبات والصلابة في الدعاية إلى الدين، والتركيز على عرض الدين كقِيَم ومُثُل وأفكار، يمكن أن يأخذ المستمع منها ما يريد بحسب بغيته ليطبق ما هو مقتنع به لا بما يجب عليه أن ينضبط به ويستسلم له، مع الترويج الدائم بين كل فقرة وأخرى بعبارات الوسطية، والتسامح، والتيسير، والحرية، والإفادة من الحالة الفردانية في عمليّة نصرة الدين، فإذا أردنا النصر فلنصلي الفجر، وإذا أردنا مقاومة المحتل فلنصم، وإذا أردنا أن نتعامل مع مآسي المسلمين فليس إلا الدعاء.
وليس المراد من ذلك التقليل من الاهتمام بالصلاة والصيام والدعاء، لكن عرض منظومة الإسلام، كحالة شعائرية مظهرية تعبدية، بعيدًا عن الحديث الجاد للنهوض بالأمة بسائر أنواع النهوض الجماعي والتغيير التربوي والإصلاح السياسي والمقاومة الجهادية، كل ذلك سيحدث حالة من التدين الخاص مما سيتيح المجال لتمدد الأفكار العلمانية.
قال ابن القيم رحمه الله: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها، فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه في خبره، وإلزامه، لأن أحكام الرب سبحانه كثيرًا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، ولا سيما أهل الرياسة، والذين يتبعون الشبهات، فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق، ودفعه كثيرًا، فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين للشهوات؛ لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق، ولا سيما إذا قامت له شبهة، فتتفق الشبهة والشهوة، ويثور الهوى، فيخفى الصواب، وينطمس وجه الحق، وان كان الحق ظاهرًا لا خفاء به، وقال لي مخرج بالتوبة وفي هؤلاء وأشباههم قال: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ} [مريم: 59] (9).
من الضرورات الدعوية أن يشارك العالم والداعية هموم المسلمين، ويتحدث عن قضاياهم الاجتماعية والسياسية، وإن كان لديه عمق في التحليل السياسي، والبعد الاستشرافي لمستقبل الأمَّة؛ فعليه ألا يبخل بذلك.
لكن مجال أهل العلم والدعوة ليس بخوض المعترك السياسي بأنفسهم، والقبول بالمناصب السياسية، خصوصًا مع قلة العلماء والدعاة في كثير من الدول العربية والإسلامية، فبلادهم بحاجة إلى علمهم ودعوتهم، وقد تتأثر الدعوة بوجودهم في تلك المناصب السياسية، ويتقزم أثر الدعوة، ويقل نشر العلم.
فليخض العمل السياسي بعض طلابهم النجباء ممن لديهم خلفية دينية ومعرفة سياسية، وليستفيدوا من رأي العلماء الذين جمعوا بين المطالعة الشرعية والفكر السياسي.
لكن تفرُّغ العلماء والدعاة للدعوة والتعليم والتوجيه وإفتاء الناس، ومعايشة هموم الناس بكل تجلياتها أفضل من دخولهم لمستنقع السياسة الذي لا يبقي ولا يذر من وقتهم شيئًا للدعوة والتعليم، وحديث كثير منهم عن الواقع السياسي وترك الكثير من المواقع التي تحتاج لكلمة ومعالجة فيه تجنٍ على مستقبل الأمة، والسياسة من الدين لكنها ليست كل الدين، فهنالك أشياء كثيرة تحتاجها الأمة المسلمة علمًا وتعليمًا وتربية ورباطًا وجهادًا في سبيل الله، ومعها التوعية السياسية، يحصل بذلك التوازن والتكامل والشمولية.
والعمل الدعوي الذي يراد منه التوسع والانتشار في مجتمعاتنا، مع المثابرة والحرص والمراقبة والمحاسبة والمتابعة الإدارية، لا بد أن يقوم به أناس من أهل الفضل والاستقامة، لديهم قدرة إدارية، لا أن يقوم بذلك المشايخ والدعاة أنفسهم، وهو ما يشغلهم عن حمل الهم الدعوي، ويفرق التفكير، وقد تحصل أخطاء إدارية لقلة الخبرة، وضعف الكفاءة، والأصل أن من يقوم بذلك يكون له صلة مع أهل العلم والدعوة، لاستشارتهم ومعرفة خُططهم الدعوية.
وهنالك مجالات مفيدة، لو أقبل عليها كثير من العاملين دعويًا لأعانوا الدعاة من أهل العلم على تحقيق الكثير من مشروعاتهم، بعمل أقل، وعطاء أكثر، من قبيل (إدارة المؤسسات) أو (تخطيط وتنمية)، ويمكن بعد ذلك الإفادة من الإدارة الدعوية في مقاومة حملات الغزاة والطغاة والغواة الذين يفسدون واقع المسلمين، فبحسن الإدارة الدعوية يعظم دور الإرادة النفسية، وحين ضعفت الأمة وتغول الباطنية قام الوزير نظام الملك، بتأسيس مدارس شافعية للتعليم الشرعي، حتى قال الذهبي: هو أول من بنى المدارس في الإسلام، وكان لهذه المدارس أثر بارز في التصدي للأعداء، والتعاون على نشر الفضيلة، بعمل مؤسسي إداري كتبت عنه كتب السّير والتراجم شيئًا مُفيدًا (10).
وختامًا:
عوامل نجاح الداعية الصادق أن يقوم بجردٍ لما قام به من أعمال دعوية، وإحصاء للمهمات التي قام بها، ودراسة جوانب النجاح ونقاط الإخفاق، وسؤال الصادقين ممن هم حوله، واستشارة من هو أعلم منه وأسبق بالعمل الدعوي، وكتابة خطط المستقبل لأداء دعوي أفضل.
وعلى الداعية بعد مراجعته لعمله، وتقويمه لأدائه، أن يتفطن لشيء هو من تمام علمه بالخلق دعويًا إن قدر لأكثرهم الضلال، فلا يعجب من عدم هدايتهم، ولا يحزن كثيرًا، ولتدبر قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ} [الأنعام: 35]، فليحاول أن يجعل حرصه على دعوتهم موزونًا بميزان الاعتدال حتى لا يتجاوز حرصه عليهم، ليصل حد الإكراه لهم على قبول الهداية، فإن الله هادي القلوب ومُوفقها ودليل حيرتها، وقد جاء في كتاب الله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} [يونس: 99].
إن المشروع الدعوي مشروع أمة، لا مشروع دولة، ولا جماعة، ولا أفراد، وكل من قام بالمساهمة فيه ولو بقدر يسير بنيّة خالصة وعمل صالح، فلن يخيب الله ظنه بحسنات في آخرته، وبركاته في دنياه، فليكثر من الدعاء بالقبول من الله تعالى.
والمُرتجى أن يزرع الدعاة إلى الله في قلوب الناس الود والحب، فحين يقع في مساقط قلوب الناس حبهم، تراهم يقتنعون بهم ويحترمون أقوالهم، فضلًا عن نصرتهم، والدفاع عنهم، وتقديم النصح لا الفضح، ويتعاونون وإياهم على نشر الخير، ودفع الضر، فيكونون من البقية الذين امتدحهم الله تعالى في سورة هود؛ إذ يقول سبحانه: {فَلَوْلَا كَانَ مِنَ القُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ} [هود: 116] (11).
----------
(1) ضعف التأصيل وتأصيل الضعف/ ناصحون.
(2) مفتاح دار السعادة (1/ 15).
(3) تفسير ابن باديس (ص: 314).
(4) تفسير الماتريدي (6/ 297).
(5) تفسير السعدي (ص: 786).
(6) مغني المحتاج (4/ 212).
(7) طبقات السبكي (6/ 217).
(8) الفتاوى الكبرى للهيتمي (١/ ٢٠٤).
(9) الفوائد لابن القيم (ص: 100).
(10) انظر: تاريخ الإسلام (10/ 543).
(11) إشكاليات في واقع الدعاة/ صيد الفوائد، باختصار شديد.
