كلما عاهدوا عهدًا نبذه فريق منهم
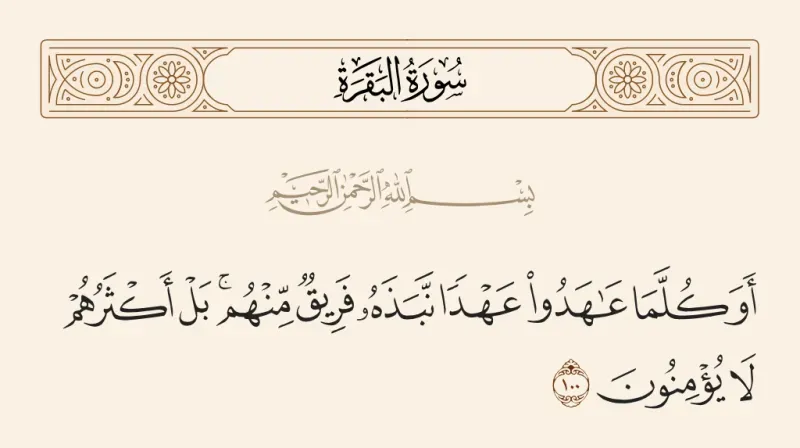
راعى القرآن العهود وأعظم شأنها حتى أوجب الدية في قتل غير المسلم من قوم معاهدين، ولم يوجبها في قتل المسلم من قوم غير معاهدين، قال تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92].
تلكم شرعة الإسلام في رعاية العهود، وهي التي سار عليها المسلمون في سلمهم وحربهم فكانوا أوفى ذمة وأثبت عهدًا، تنطق بذلك سيرهم منذ جاءهم الإسلام حتى اليوم، كان للعهد عندهم حرمة لا تمتهن، في السراء والضراء، والشدة والرخاء، كان العهد الذي يعطيه أقل رجل من المسلمين ولو عبدًا؛ نافذًا على المسلمين جميعًا، لا يقبل تأويلًا ولا تبديلًا، فهذه أم هانئ بنت أبي طالب، تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه، فقال: «من هذه» فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: «مرحبًا بأم هانئ» فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات، ملتحفًا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلًا قد أجرته، فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ»، قالت أم هانئ: وذاك ضحى (1).
إن حفظ العهود ليلقى الأمن والطمأنينة في نفوس الأفراد والأمم، ويقيم أمور الناس على شريعة من المودة والإنصاف والتعاون، وإن العالم ليزلزل اليوم بما استخف بالعهود واتخذها وسيلة إلى المطامع؛ فلم يركن الناس إلى معاهدة، ولم يأمنوا الغدر والمفاجأة، فصاروا في ريبة وحيرة، وزال ما كان يثبت الأمم من مواثيق تؤمن بها وتركن إليها وتسير في تدبيرها عليها، صار الوعد لا يدل على الوفاء، والعهد لا يؤمن من الغدر، فاضطرب الناس فهم في أمر مريج.
إنَّ غدر اليهود وتلاعبهم في الاتفاقات المختلفة حقيقة حدثنا عنها التاريخ الماضي، وها نحن نشهد في تاريخنا المعاصر طرفًا من ألاعيبهم الباردة، وخياناتهم الجلية الواضحة حتى مع من حالفوهم ووضعوا أيديهم معهم، وقد دلنا على ذلك كتاب ربنا في قوله تعالى: {أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ} [البقرة: 100].
والصراع مع اليهود عقيدة قائمة مهما وُقِّع من عهود ومواثيق، ولن ينتهي هذا الصراع إلا حينما: «يقول الحجر أو الشجر: يا مسلم! يا عبد الله! هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله» (2)، وما هذا الارتماء المهين على أعتاب اليهود إلا علامة من علامات الخزي والخذلان، وها هو ذا طريق النصر واضح بيِّن في كتاب الله تعالى لا يغفل عنه إلا من أعمى الله بصيرته، وطمس على قلبه: {أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ (20) أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ (21) أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (22)} [الملك: 20- 22].
وما ضاعت القدس إلا حينما ضيعنا الدين، وهجرنا القرآن العظيم، وسقطنا في مستنقعات الفساد.
وصدق الرافعي إذ يقول: إذا أسندت الأمة مناصبها الكبيرة إلى صغار النفوس كبرت بها رذائلهم لا نفوسهم (3).
لقد كشف القرآن هنا عن علة كفر بني إسرائيل بتلك الآيات البينات التي أنزلها الله.. إنه الفسوق وانحراف الفطرة، فالطبيعة المستقيمة لا يسعها إلا الإيمان بتلك الآيات، وهي تفرض نفسها فرضًا على القلب المستقيم.
فإذا كفر بها اليهود- أو غيرهم- فليس هذا لأنه لا مقنع فيها ولا حجة، ولكن لأنهم هم فاسدو الفطرة فاسقون.
واليهود لا يستمسكون بوحدة، ولا يحفظ بعضهم عهد بعض، وما من عهد يقطعونه على أنفسهم حتى تند منهم فرقة فتنقض ما أبرموا، وتخرج على ما أجمعوا: {أَوَكُلَّما عاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ}.
وقد أخلفوا ميثاقهم مع الله تحت الجبل، ونبذوا عهودهم مع أنبيائهم من بعد، وأخيرًا نبذ فريق منهم عهدهم الذي أبرموه مع النبي صلى الله عليه وسلم أول مقدمه إلى المدينة وهو العهد الذي وادعهم فيه بشروط معينة، بينما كانوا هم أول من أعان عليه أعداءه وأول من عاب دينه، وحاول بث الفرقة والفتنة في الصف المسلم، مخالفين ما عاهدوا المسلمين عليه..
من أبرز مظاهر خيانة بني إسرائيل للعهد مع الله أنهم كانوا يقتلون الأنبياء الذين يبعثهم الله لهدايتهم، يقول الله تعالى: {فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ} [النساء: 155].
عبادة العجل بعد إنقاذهم من فرعون، خانوا العهد مع الله وعبدوا العجل بدلًا من عبادة الله الواحد، يقول الله: {وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ} [البقرة: 51].
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك عدة قبائل يهودية في المدينة، مثل بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وقد خانوا العهد مع المسلمين بطرق مختلفة؛ فبنو قينقاع: أخلّوا بالعهد مع المسلمين وأساءوا إليهم، مما أدى إلى إجلائهم، بنو النضير: تآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فتم طردهم من المدينة، بنو قريظة: خانوا المسلمين في غزوة الأحزاب وتحالفوا مع المشركين، رغم العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين.
وبئس هي من خلة في اليهود! تقابلها في المسلمين خلة أخرى على النقيض، يعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم» (4)، يسعى بذمتهم أدناهم، فلا يخيس أحد بعهده إذا عاهد، ولا ينقض أحد عقده إذا أبرم، ولقد كتب أبو عبيدة رضي الله عنه وهو قائد لجيش عمر رضي الله عنه وهو الخليفة يقول: إن عبدًا أمن أهل بلد بالعراق، وسأله رأيه، فكتب إليه عمر: إن الله عظم الوفاء، فلا تكونون أوفياء حتى تفوا، فوفوا لهم وانصرفوا عنهم (5).
وهذه سمة الجماعة الكريمة المتماسكة المستقيمة، وذلك فرق ما بين أخلاق اليهود الفاسقين وأخلاق المسلمين الصادقين (6).
ولقد أضمروا العداء للإسلام والمسلمين منذ اليوم الأول الذي جمع الله فيه الأوس والخزرج على الإسلام، فلم يعد لليهود في صفوفهم مدخل ولا مخرج، ومنذ اليوم الذي تحددت فيه قيادة الأمة المسلمة وأمسك بزمامها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تعد لليهود فرصة للتسلط! ولقد استخدموا كل الأسلحة والوسائل التي تفتقت عنها عبقرية المكر اليهودية، وأفادتها من قرون السبي في بابل، والعبودية في مصر، والذل في الدولة الرومانية، ومع أن الإسلام قد وسعهم بعد ما ضاقت بهم الملل والنحل على مدار التاريخ، فإنهم ردوا للإسلام جميله عليهم أقبح الكيد وألأم المكر منذ اليوم الأول.
ولقد ألبوا على الإسلام والمسلمين كل قوى الجزيرة العربية المشركة وراحوا يجمعون القبائل المتفرقة لحرب الجماعة المسلمة: {وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا} [النساء: 51]، ولما غلبهم الإسلام بقوة الحق- يوم أن كان الناس مسلمين- استداروا يكيدون له بدس المفتريات في كتبه- لم يسلم من هذا الدس إلا كتاب الله الذي تكفل بحفظه سبحانه- ويكيدون له بالدس بين صفوف المسلمين، وإثارة الفتن عن طريق استخدام حديثي العهد بالإسلام ومن ليس لهم فيه فقه من مسلمة الأقطار.
ويكيدون له بتأليب خصومه عليه في أنحاء الأرض، حتى انتهى بهم المطاف أن يكونوا في العصر الأخير هم الذين يقودون المعركة مع الإسلام في كل شبر على وجه الأرض، وهم الذين يستخدمون الصليبية والوثنية في هذه الحرب الشاملة، وهم الذين يقيمون الأوضاع ويصنعون الأبطال الذين يتسمون بأسماء المسلمين، ويشنونها حربًا صليبية صهيونية على كل جذر من جذور هذا الدين! وصدق الله العظيم: {لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا} [المائدة: 82].
إن الذي ألب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة في المدينة وجمع بين اليهود من بني قريظة وغيرهم وبين قريش في مكة، وبين القبائل الأخرى في الجزيرة؛ يهودي..
والذي ألب العوام، وجمع الشراذم، وأطلق الشائعات، في فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه- وما تلاها من النكبات؛ يهودي..
والذي قاد حملة الوضع والكذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الروايات والسير؛ يهودي..
ثم إن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية في دولة الخلافة الأخيرة ووراء الانقلابات التي ابتدأت بعزل الشريعة عن الحكم واستبدال «الدستور» بها في عهد السلطان عبد الحميد، ثم انتهت بإلغاء الخلافة جملة على يدي «البطل» أتاتورك؛ يهودي..
وسائر ما تلا ذلك من الحرب المعلنة على طلائع البعث الإسلامي في كل مكان على وجه الأرض وراءه يهود! ثم لقد كان وراء النزعة المادية الإلحادية؛ يهودي، ووراء النزعة الحيوانية الجنسية يهودي، ووراء معظم النظريات الهدامة لكل المقدسات والضوابط يهود! ولقد كانت الحرب التي شنها اليهود على الإسلام أطول أمدًا، وأعرض مجالًا، من تلك التي شنها عليه المشركون والوثنيون- على ضراوتها- قديمًا وحديثًا..
إن المعركة مع مشركي العرب لم تمتد إلى أكثر من عشرين عامًا في جملتها، وكذلك كانت المعركة مع فارس في العهد الأول، أما في العصر الحديث فإن ضراوة المعركة بين الوثنية الهندية والإسلام ضراوة ظاهرة ولكنها لا تبلغ ضراوة الصهيونية العالمية (التي تعد الماركسية مجرد فرع لها) وليس هناك ما يماثل معركة اليهود مع الإسلام في طول الأمد وعرض المجال إلا معركة الصليبية (7).
عن الحسن قوله: {أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} [البقرة: 100]، قال: نعم، ليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه يعاهدون اليوم وينقضون غدًا (8).
قال ابن الخطيب: المقصود من هذه الاستفهام، الإنكار، وإعظام ما يقدمون عليه، ودلّ قوله: {أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا} على عهد بعد عهد نقضوه، ونبذوه، ويدل على أن ذلك كالعادة فيهم، فكأنه تعالى أراد تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام عن كفرهم بما أنزل عليه من الآيات بأن ذلك ليس ببدع منهم، بل هو سجيّتهم وعادتهم، وعادة سَلَفهم على ما بيّنه فيما تقدم من نَقْضهم العهود والمواثيق حالًا بعد حال؛ لأن من يعتاد منه هذه الطريقة، فلا يصعب على النفس مُخَالفته كصعوفة مَنْ لم تَجْرِ عادته بذلك (9).
وفي العهد وجوه:
أحدها: أن الله تعالى لما أظهر الدَّلائل الدَّالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحة شرعه كان ذلك كالعهد منه سبحانه وتعالى، وقبولهم لتلك الدلائل كالمعاهدة منهم لله سبحانه وتعالى.
وثانيها: قولهم قبل مبعثه: لئن خرج النبي لنؤمنن به، ولنخرجن المشركين من ديارهم، قال ابن عباس: لما ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذ الله تعالى عليهم، وعهد إليهم في مُحَمّد أن يؤمنوا به، قال مالك بن الصيف: والله ما عهد إلينا من محمد عهد فنزلت هذه.
وثالثها: أنهم كانوا يعاهدون الله كثيرًا وينقضونه.
ورابعها: قال عطاء: إن اليهود كَانُوا قد عاهدوا على ألَّا يعينوا عليه أحدًا من الكافرين، فنقضوا ذلك، وأعانوا عليه قريشًا يوم «الخندق»، ودليله قوله تعالى: {الذين عَاهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ} [الأنفال: 56]، إنما قال: {نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ} لأن في جملة من عاهد من آمن، أو يجوز أن يؤمن، فلما لم يكن ذلك صفة جميعهم خص الفريق بالذكر، ثم لما كان يجوز أن يظن أن ذلك الفريق هم الأقلّون بين أنهم الأكثر فقال: {بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ} (10).
إن من القواعد الإسلامية أن الإسلام يعلو ولا يعلى، ومن شرط إقامة أهل الكتاب مع المسلمين في بلد المسلمين أن يلتزم اليهود أو النصارى بشروط أهل الذمة مقابل الأمان والحماية التي يمنحها لهم المسلمون، ومن أهم شروط أهل الذمة ألا يفشي الكتابيون شركهم وكفرهم في بلد المسلمين لا بالقول ولا بالفعل.
وحيث أن المسلمين واليهود كيانان متنافران ومتعاديان دينيًا وعقديًا فإنه لا يمكن اجتماعهما معًا إلا أن يرضخ أحدهما للآخر بالقوة؛ بل إن اليهود الآن لا يسمحون للمسلمين بالبقاء، ولو لم يقم المسلمون بأي عمل استفزازي، ولذلك ينزعون ملكية أراضي المسلمين بالقوة ويبنون مستوطناتهم عليها، ويريدون طرد المسلمين بأي طريقة، وقد شردوا الملايين منهم إلى الدول المجاورة التي أقيم بها ما يعرف بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين.
فإن كون المسلمين الآن في مرحلة استضعاف وذل- بسبب تخلفهم عن دينهم- وكونهم لا يستطيعون قتال اليهود واسترجاع الأراضي المغتصبة وفرض أحكام الشريعة الإسلامية على أرض فلسطين؛ فإن ذلك لا يعني أن الأمر سيستمر هكذا إلى نهاية الدنيا؛ بل لا بد أن يتغير الحال، ومن أدلة ذلك الخبر المستقبلي الذي أخبرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي من ربه فلا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال عليه الصلاة والسلام: «تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله» (11).
وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود» (12) (13).
فإن ما يجري اليوم في القدس والمسجد الأقصى القبلة الأولى للمسلمين، ومعراج النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء -خاصة بعد العدوان على غزة-، من إصرار صهيوني على الاستيلاء على المدينة وطمس معالمها الإسلامية، وحفر الأنفاق الكثيرة تحت المسجد الأقصى، وهدم بيوت المسلمين فيها، والعمل الدؤوب على تهجير أهلها وطردهم منها، والإعلان المتكرر بادِّعاء القدس العاصمة الموحدة والأبدية للكيان الصهيوني ليدلل على تمسك أولئك المعتدين الغاصبين بمخططاتهم التي أرادت أن تؤسس لدولة يهودية في فلسطين، حسب ما قال بن غوريون: لا معنى لإسرائيل بدون القدس ولا معنى للقدس بدون الهيكل.
إن الذي أغرى اليهود في عدوانهم على القدس هو هذا الصمت الرهيب من الأمة بكل فئاتها، مما أدى لتسلط الإدارة الصهيونية وتفرغها لتهويد القدس عن طريق هدم المسجد الأقصى وإنشاء الهيكل المزعوم مكانه.
إن ما يجري اليوم يُحمِّل جميع المسلمين وفي مقدمتهم علماء الأمة مسؤولية شرعية وتاريخية تستوجب الصدع بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونبذ جميع أشكال العلاقات أو التطبيع مع ذلك العدو المجرم، لقول الله تعالى: {أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ}، وبيان الحكم الشرعي القاطع بتحريم كل أنواع العلاقات الآثمة مع عدوٍ مجرم استمرأ القتل والعدوان في غزة والضفة، ودرة المدن الفلسطينية مدينة القدس.
-------------
(1) أخرجه البخاري (6158).
(2) أخرجه مسلم (2922).
(3) مجلة الرسالة، العدد (84).
(4) أخرجه النسائي (4735).
(5) تاريخ الطبري (4/ 94).
(6) في ظلال القرآن (1/ 94).
(7) في ظلال القرآن (2/ 961).
(8) تفسير ابن أبي حاتم (1/ 184).
(9) اللباب في علوم الكتاب (2/ 320).
(10) نفس المصدر.
(11) أخرجه مسلم (2921).
(12) أخرجه مسلم (2922).
(13) موقع الإسلام سؤال وجواب (1/ 1232)، بترقيم الشاملة آليًا.
