ضرورة تلقي العلم من منابعه الأصيلة
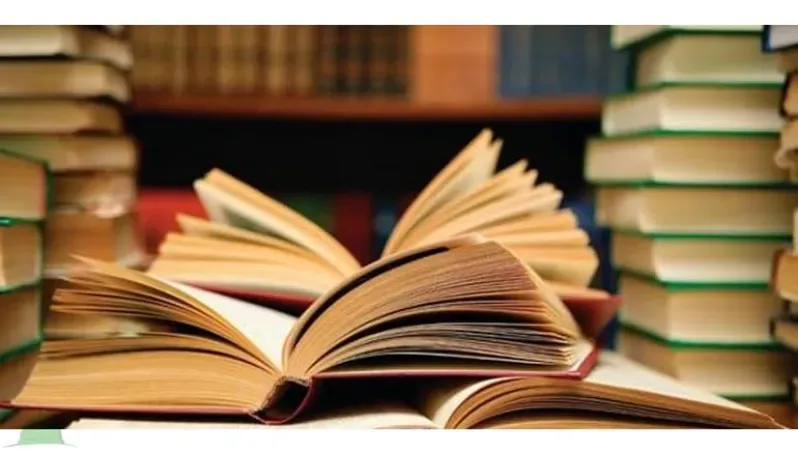
طلب العلم فريضة واجبة على كل مسلم، كلٌ على قدر استطاعته وضرورته؛ لأَنَّ الله تعالى افترض علينا في شريعة الإسلام أركانًا وواجبات، وسننًا ومُستحبات، ولا تتم هذه الفرائض والواجبات إلا بالتعبُّد الصحيح بها، والقيام بحقها، ولا يكون ذلك إلا بطلب العلم بها، ومعرفة شروطها وأركانها، وتمييز الواجبات والشرائع عن بعضها.
كما أن الإسلامَ جاء بعمارة الدنيا لإقامة الدين؛ قال تعالى: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} [هود: 61]، فأي أمة لا تعمر الأرض إلا إذا ملكت وسائل التعمير، ولا يكون ذلك أيضًا إلا بالعلم وطلبه.
ونحن إذا تأملنا آيات القرآن، وجدنا أن الله تعالى في أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بطلب العلم النافع بمعناه الواسع الشامل للعلم الشرعي وغيره ما كان نافعًا؛ فقال تعالى: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)} [العلق: 1 - 5]، وقال تعالى لنبيه ورسوله: {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [طه: 114].
من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة، والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة بالبنان، ذهني ولفظي ورسمي (1).
كما أن الله تعالى فرَّق بين العالم وغيره، وجعل لكل واحد مكانة تليق به، وفضل العالم على غيره؛ فقال تعالى: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ} [الزمر: 9].
فالعلم الحق هو المعرفة، هو إدراك الحق، هو تفتح البصيرة، هو الاتصال بالحقائق الثابتة في هذا الوجود، وليس العلم هو المعلومات المفردة المنقطعة التي تزحم الذهن، ولا تؤدي إلى حقائق الكون الكبرى، ولا تمتد وراء الظاهر المحسوس.
وهذا هو الطريق إلى العلم الحقيقي والمعرفة المستنيرة.. هذا هو.. القنوت لله، وحساسية القلب، واستشعار الحذر من الآخرة، والتطلع إلى رحمة الله وفضله ومراقبة الله هذه المراقبة الواجفة الخاشعة.. هذا هو الطريق، ومن ثم يدرك اللب ويعرف، وينتفع بما يرى وما يسمع وما يجرب وينتهي إلى الحقائق الكبرى الثابتة من وراء المشاهدات والتجارب الصغيرة، فأما الذين يقفون عند حدود التجارب المفردة، والمشاهدات الظاهرة، فهم جامعو معلومات وليسوا بالعلماء (2).
كما أن الله تعالى جعل لطلبة العلم وأهله درجاتٍ عاليات عنده سبحانه فقال: {يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [المجادلة: 11]، ليس من شك في أن الإنسان المسلم إذا لم يتلقَّ العلم من منابعه الأصيلة، وروافده الصحيحة، أخذًا من الكتاب والسنة على هدي السلف الصالح، فإنه سيخبط خبط عشواء، ويتلقى العلم من جهات لا يعلم توجهاتها العقدية، ولا أصولها الشرعية، ويقع في عدة مزالق يتباين حجم خطئها وضلالها، ولهذا كان علماؤنا السابقون يوصون بتلقي العلم ممن صدقوا الله في تعلمهم وتعليمهم، ولاحت قوة حججهم أمام خصومهم، وفي المقابل يحذرون طلابهم من أهل الزيغ والهوى، لئلا يقعوا فيما وقع فيه أولئك المبتدعة، فكان الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي اللَّه عنه يقول: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن علمائهم وأمنائهم، فإذا أخذوه من أصاغرهم وشرارهم هلكوا (3).
قال مالك: لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ عمن سواهم، لا يؤخذ عن معلن بالسفه، ولا عمن جرب عليه الكذب، ولا عن صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا عن شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به.
وقال مالك أيضًا: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، لقد أدركنا في هذا المسجد سبعين ممن يقول قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان أمينًا عليه فما أخذت منهم شيئًا، لم يكونوا من أهل هذا الشأن، ويقدم علينا محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وهو شاب فنزدحم على بابه (4).
وممن نبَّه على ذلك الغزالي رحمه الله حيث ألمح للمسلم الذي يريد أن يكون ذا عقلية واعية بأنَّه لا بد أن يعمل على حصانة عقليته من الانحرافات الفكرية، وخصوصًا إن كان في منطقة يكثر بها أهل البدع والهوى، فقال: فإن كان في بلد شاع فيه الكلام، وتناطق الناس بالبدع؛ فينبغي أن يصان في أول بلوغه عنها بتلقين الحق؛ فإنه لو ألقي إليه الباطل لوجبت إزالته عن قلبه وربما عسر ذلك، كما أنه لو كان هذا المسلم تاجرًا وقد شاع في البلد معاملة الربا وجب عليه تعلم الحذر من الربا (5).
وحين يفتش المراقب ضلال من ضل وحاد عن طريق الهدى وعلائم الحق، فسيجد أن من أسباب ذلك ضعف الحصانة الشرعية، مما يؤدي لولوج المشتبهات في فكره وعقله، وقد نبه على ذلك الإمام ابن بطة العكبري فقال: اعلموا إخواني أني فكرت في السبب الذي أخرج أقوامًا من السنة والجماعة واضطرهم إلى البدعة والشناعة، وفتح باب البلية على أفئدتهم وحجب نور الحق عن بصيرتهم فوجدت ذلك من وجهين:
أحدهما: البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا ينبغي، ولا يضر العاقل جهله، ولا ينفع المؤمن فهمه.
والآخر: مجالسة من لا تؤمن فتنته، وتفسد القلوب صحبته (6).
وقد يتساءل بعض المستشكلين عن علة الاهتمام والتشبث تجاه مصادر التلقي؛ والسبب في ذلك، لئلا تختلط المناهج في الذهن، وتتضارب التصورات، فتكون النتيجة المنطبعة بعد ذلك في العقل الإسلامي منهجًا غوغائيًا لا تلزمه ضوابط، ولا تحكمه قيود.
فالمطلوب لمن أراد الهداية والتثبيت على سلم الشريعة؛ ليدفع بها الأهواء، ومكائد أهل الضلال، أن يكون معتنيًا بحماية عقله، بسياج الشريعة الإسلامية وأصولها، والتي تكون له ثوابت عقدية تحميه من سريان الأفكار المضللة إلى منهجه، من أهل الأهواء والعصرنة والعلمنة.
الحذر من مخالفة منهج أهل السنة والجماعة:
من يتابع مسيرة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يجدهم يتحاشون الاستماع لأهل البدع والهوى، أو محادثتهم، أو مجالستهم، وفي هذا يقول سفيان الثوري: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة، وهو يعلم، خرج من عصمة الله، ووكل إلى نفسه، وقال كذلك: من سمع بدعة فلا يحكها لجلسائه، لا يلقها في قلوبهم.
علق الإمام الذهبي على مقولة الإمام سفيان الثوري بقوله: أكثر الأئمة على هذا التحذير يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة (7).
يُقال ذلك لحفظ عقول المسلمين، والاحتياط لدينهم من سماع كلام أهل الضلال، استدلالًا بقوله تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [الأنعام: 68]، وقوله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} [النساء: 140].
ومن الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «وإنَّه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا فعليكم بسنَّتي وسنَّة الخلفاء الراشدين المهديِّين، تمسَّكوا بها وعضُّوا عليها بالنواجذ وإيَّاكم ومحدثات الأمور، فإنَّ كلَّ محدثة بدعة وكلُّ بدعة ضلالة» (8)، فإنه صلى الله عليه وسلم حذرنا من محدثات الأمور، ودعانا إلى اجتنابها.
وأمر صلى الله عليه وسلم بالثبات على سنة الخلفاء الراشدين لأمرين: أحدهما: التقليد لمن عجز عن النظر.
والثاني: الترجيح لما ذهبوا إليه عند اختلاف الصحابة (9).
وأما ما يدعيه بعضهم من أولي التوجهات الحديثة العصرية: بأن ذلك التحفظ من باب الحجر على الأفكار، والاسترقاق الفكري، والإرهاب الثقافي تجاه الناس، وأنه لا بأس بأن يستمع من شاء إلى من يشاء، سواء أكان سني المنهج أو نقيضه، بلا توجيه أو رعاية أو تربية وعناية؛ بزعم أن الحق أبلج ناصع، ومن خلال نصاعة الحق سيتبين للناس أنه حق ويأخذون به، لأن الله يقول: {فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ} [الرعد: 17]، ويقولون: إنه ليس من إشكال أن يقلب المرء بصره في كلام الناس، ويستمع لجدال المجادلين، ثم يرى من كان كلامه حقًا فيأخذ به.
فالجواب عن ذلك: بأن هذا الطرح متولد من العقلية الغالية في تحكيم النصوص، والتي تزايد في إعطاء العقل ما لا يقدر عليه، ولم يُبْنَ على الأصول الشرعية، وإلا فإن هدي رسول الهدى صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ممن بعده يقوم على تحصين الأفكار، وصيانة العقول من الاستماع لكل من هب ودب، وعلى هذا قام منهج أهل السنة والجماعة، ورحم الله عمر بن عبد العزيز، حين قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننًا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعته، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في رأي من خالفها، فمن اقتدى بما سنوا فقد اهتدى، ومن استبصر بها بصر، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا (10).
وحين جاء رجل للإمام الأوزاعي رحمه الله فقال: أنا أجالس أهل السنة، وأجالس أهل البدع، قال الأوزاعي: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل (11).
والحقيقة أننا إذا نظرنا فيمن يعظم الذي يظن أنه عقلاني، فسنجدهم قد صاروا إلى أقوال متباينة، وأفكار غريبة، وقل أن نراهم يوافقون الحق والصواب المدعى من قِبَلِهم؛ لأن المعيار بلا معيار لا يكون، والعقول تختلف، والآراء تتباين، والأفكار تتضارب، فتتكون لديهم رؤية مبعثرة غير متزنة، تسفها الرياح العاتية، وتتلاعب بها الأعاصير الجارفة، وقد قيل: (للناس بعدد رؤوسهم آراء) ولهذا فلم نرَ من كبارهم إلا الندم والحسرة على تلك الأيام التي خلت حين كانوا يضربون الأخماس في الأسداس في ماهية المنهج الصائب، حتَّى انتهوا بلا نهاية.
وأما ما ادعاه بعضهم من صحة الفكرة القائلة: بأن يقلِّب المرء ناظريه بين الأقوال المتضاربة، ويرى الحق الذي يبدو له في بعضها فيختاره، ثم يرى أن هناك شخصًا تَعَقَّبَ ذلك الحق الذي اتبعه فجعله باطلًا، ثمَّ أبدى ما لديه من حق، فيأتي المرء ليختار الحق الذي اختاره ذلك الشخص المتعقب لكلام من قبله، ثم يأتي شخص ثالث فيبطل القولين ويصوب القول الذي اختاره بعناية وتحقيق، فيأتي هذا المرء المسافر بين عقول هؤلاء ليختار قول هذا الرجل، لأنه قوي في المناظرة، رابط الجأش في المجادلة، وهكذا....فإن هذا الرأي المطروح ليس صوابًا؛ لأن دين الله لم يأت ليحاكمه العقل البشري، بل ليسمع له ويطيعه، ولهذا فإن المنهج العقلي وإنْ صوِّر لأصحابه في البداية بأنه منهج المنطقية والعقلانية، إلا أنه في الحقيقة منهج الحيرة والضلالة، لأن هذا المنهج وإن كانت له قيود، فقيوده متفلتة، وقواعده متسيِّبة، فينتج من ذلك ثلاثة أمور:
1- إما أن يصاب أصحابه بتبلد الإحساس فيختاروا قولًا، يبقون عليه إلى أن يُقْبَضُوا مع تعصب مقيت، وهوى متَّبع.
2- وإما أن يصطدموا بما لا طاقة لعقولهم به فيردوا الشريعة جملة وتفصيلًا.
3- وإما أن يصاب أصحابه بالارتحال الفكري، والتجوال بين عقول البشر، ومناهج الفلاسفة أو المفكرين العصريين، فيعانوا من الدُّوار مع القلق الفكري، وتغلب عليهم الحيرة والاضطراب المنهجي ـ
حين جاء رجل للإمام مالك يقال له أبو الجويرية -متهم بالإرجاء- فقال له: اسمع مني، فقال مالك: احذر أن أشهد عليك، فقال هذا الرجل: والله ما أريد إلا الحق، فإن كان صوابًا، فقل به، أو فتكلم، فقال مالك: فإن غلبتني، فقال الرجل: اتبعني، فقال مالك: فإن غلبتك، قال: اتبعتك، فقال مالك: فإن جاء رجل فكلمنا، فغلبنا؟ قال: اتبعناه، فقال مالك: يا هذا، إن الله بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تتنقل (12).
ولا يعني ذلك بحال ألا يتطلب المسلم الحق ويبحث عنه، فإن هذا الأمر غير ذاك، والفارق بينهما أن من يريد تتبع الحق في أصول الإسلام وقضاياه الكلية يرجع إلى كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيستقي منهما الحق والصواب، على طريقة علماء أهل السنَّة والجماعة، ومنهجيَّتهم في الاستدلال.
حتى لا نقع في الانحرافات:
صفة متبع الحق أنه يدور مع الأدلة الشرعية حيث تدور، فهمُّه التسليم لكلام الله ورسوله؛ لأنه عابد لله، ولا يكون العبد مسلمًا لله إلا إذا ابتعد عن هواه وسلم عقله ونفسه لحكم الله وأمره، أما من يريد تتبع الحق لأقوال من عرفوا بالزيغ والهوى، فإنه قل أن يصل للمنهج الإسلامي الصحيح، ومن دلائل معرفة هؤلاء أنهم يبعدون النجعة كثيرًا عن الأدلة الشرعية، ولا يتحاكمون إلا إلى عقولهم ومن ثمَّ يختارون من الشريعة ما يوافق هواهم، بل لو قيل لبعضهم: إن هذا القول خطأ والدليل عليه من كتاب الله كذا وكذا، لضجُّوا وأكثروا وقالوا أنت رجل مماحك؛ فما أشبههم بقوله تعالى: {وَإِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ} [الزمر: 45].
ومن هنا يلزم كل متبع لمنهج أهل السنة أن يكون فكره مبنيًا على كتاب الله وسنة رسول الله بالفهم المنضبط على منهج أهل السنة والجماعة، خشية الوقوع في الشبهات ووصولها إلى ذهنه، ومن ثمَّ صعوبة الانفكاك عنها، حيث ترسَّخت في العقل.
استدراك لا بد منه:
لا يعني التحذير من القراءة لكتب أهل الزيغ والهوى، أو متابعة آرائهم وأفكارهم بأي حال؛ ألا يُنتَدَب أناس منَّ الله عليهم بالعمق العلمي في معرفة منهج أهل السنة، ورصانة الدفاع عنه، مع ما آتاهم الله من قوة وحجَّة في الكلام، وجزالة في المعاني والتبيان، بالتصدي لأهل البدع والضلالات، وكشف زيف شبههم؛ فإن أهل السنة محتاجون أشد الحاجة لأولي العلم الربانيين المتمكنين، وخاصة في هذا الزمان، الذي كثرت فيه الشبهات وتسلط فيه الجهال على منابر الإعلام، وانتشر فيه الرويبضات الذين ينطقون في أمر العامة، فإننَّا بحاجة ماسة لمن منَّ الله عليهم بذلك وتكونت لديهم الحصانة العقدية، لأن يُنتدَبوا لجدال الزائغين، ومناقشة المغرضين، وقد كان في السابق من أهل العلم من ينتدب لذلك إذا رأى الشبهات قد كثرت، بل قد يناظر ويجادل أمام العامة، إذا خشي أن تتسرب الفكرة الضالة إلى عقولهم من أهل الضلال، حماية لهم منهم، وردًا لكيد الضُّلاَّل في نحورهم ، كما ناقش الإمام أحمدُ ابنَ أبي دؤاد، وكما جادل الكنانيُّ بِشْرَ المريسي، وابنُ تيميةَ علماءَ الأشاعرة، وغيرهم كثير.
وكانت هذه الحالة عند العلماء استثنائية، من أصل عدم مناظرة هؤلاء، أو الاستماع إليهم، إلا إن اضطروا إلى ذلك، وخشوا أن تستفحل الفتنة أكثر فأكثر؛ فإنَّ أهل السنَّة استحبُّوا أن ينتهض الربَّانيون لمجادلة الضلاَّل.
وممَّن نبه على ذلك من علماء الإسلام: الآجرِّي رحمه الله بقوله عن أهل الضلالة والبدع: فإن قال قائل: فإن اضطر في الأمر وقتًا من الأوقات إلى مناظرتهم، وإثبات الحجة عليهم ألا يناظرهم؟ قيل: الاضطرار إنَّما يكون مع إمام له مذهب سوء، فيمتحن الناس، ويدعوهم إلى مذهبه، كفعل من مضى، في وقت الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس، ودعوهم إلى مذهبهم السوء، فلم يجد العلماء بدَّاُ من الذبِّ عن الدين، وأرادوا بذلك معرفة الحق من الباطل، فناظروهم ضرورة لا اختيارًا، فأثبت الله عز وجل الحق مع الإمام أحمد بن حنبل، ومن كان على طريقته، وأذلَّ الله العظيم المعتزلة وفضحهم، وعرفت العامة أنَّ الحقَّ ما كان عليه أحمد بن حنبل ومن تابعه إلى يوم القيامة (13).
ولهذا فلا يُذْكَر أن أُفحم أهل السنة في مناقشاتهم لأهل البدع، أو مناظراتهم لهم ولله الحمد والمنة لأن الله هاديهم، ومنور طريقهم.
أمَّا من أرادوا جر أهل البدع والهوى لمناقشات لا يحسنون الجدل معهم فيها، بل يلقون في أذهانهم شبهًا تلجلج في عقولهم أيَّامًا حتى يفرجها الله بإزالة تلك الإشكالات من أهل العلم الربانيين، بعد أن يطوف عليهم هؤلاء المغمورون... إن هؤلاء القوم لا يقال لهم إلا: لا تعرضوا أنفسكم للفتنة، فتكونوا للناس فتنة، حين لا يجدوا لديكم قوَّة في الحجَّة، وعمقاً في المناظرة، وكم أُتي أهل السنة والجماعة من أمثال هؤلاء.
وقد قيل: كثيرًا ما يكون الباطل أهلًا للهزيمة، ولكنه لا يجد من هو أهل للانتصار عليه.
وحين كان يتحدث الإمام ابن تيمية عن مناظرة أهل السنة لأهل البدع والهوى، بين رحمه الله أن أهل السنة والجماعة لا يؤيدون أن يتصدى لمناظرة أهل البدع من كان قليل العلم، فقال: وقد ينهون عن المجادلة والمناظرة إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهة، فيخاف عليه أن يفسده ذلك المضل، كما ينهى الضعيف في المقاتلة أن يقاتل علجًا قويًّا من علوج الكفار، فإن ذلك يضره ويضر المسلمين بلا منفعة (14).
وعلة ذلك أنه حين النقاش يظهر السني أمام أهل الضلال والهوى بمظهر ضعف، وعدم قوة في الاحتجاج والطرح، فيسبب ذلك له ولبعض أهل السنة حيرة وفتنة في دينهم، وقد تحدث ابن تيمية في موضع آخر حول هذه القضية قائلًا: وكثيرًا ما يعارضهم من أهل الإسلام من لا يحسن التمييز بين الحق والباطل، ولا يقيم الحجة التي تدحض باطلهم، ولا يبين حجة الله التي أقامها برسله، فيحصل بسبب ذلك فتنة (15).
إن فرضيات الواقع والتي يغلب عليها اللغة الانهزامية، والأفكار المضللة، تقتضي أن نكون أشد إصرارًا في مفاصلاتنا العقدية، وأصلب عودًا في التلمس الجاد لوجود أهل السنة المعينين لنا بالإبقاء على استنبات الفطرة التي ولدنا عليها، وأهمية معرفة مصادر التلقي لنتصورها ونعتقدها مستمسكين بها، ولدينا أهل العلم وحملته الربانيُّون، فلنسألهم ولنستوضح منهم ما أشكل من أصول ديننا.
الحصانة الشرعية للعقلية الإسلامية:
ولسائل أن يقول: وكيف نحصن أنفسنا وفكرنا من الداخل، خشية أن يضلنا ما هو زائغ عن المنهج القويم، وما الأسس والأصول التي تكون لدينا حصانة شرعية، نستطيع بإذن الله بعدها أن نرد الغلط إذا أوردت الشبهات، وخصوصًا في ظل ما يمارس الآن من الحرب الإعلامية الغازية للأفكار والعقول المسلمة؟
لعل الجواب يكمن في عدة نقاط أرى أنها بإذنه تعالى تساهم في بناء الحصانة الشرعية للعقليَّة الإسلامية، وهي كالتالي:
1- التعلق بالله عز وجل والاستعانة والاستعاذة به، وسؤاله الهداية والثبات والممات على دين الإسلام من غير تبديل ولا تغيير، ولنا في رسول الله أسوة وقدوة، فقد كان يسأل ربه الهداية، وكان كثيرًا ما يسأله الثبات على هذا الدين، وعدم تقلب قلبه عن منهج الإسلام، ويستعيذ به من أن يضل أو يضل، كما كان عليه السلام يستعيذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فالدعاء الملازم لذلك والانطراح على عتبة العبودية، وملازمة القرع لأبواب السماء بـ: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} [آل عمران: 8]، إذا اجتمعت هذه كلها، فلا شك أن رحمته سبحانه سابقة لغضبه وعقابه، ومحال أن يتعلق العبد بربه حق التعلق، ويعرض عنه الله سبحانه وبحمده وهو الكريم الوهاب.
2- الثقة بمنهج الله ووعده وحكمه وأوامره، واليقين به ومراقبته، والشعور بالمسؤوليَّة عن حفظ الدين من شبهات المغرضين، وعدم خلطه بالباطل، أو لبسه إياه، ومن ثم الصبر على مكائد المنفذين والمسوغين للشبهات، فإنه سبحانه وتعالى يقول: {وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا} [آل عمران: 120]، وقد قيل: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ومما يشهد لذلك قوله تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا} [السجدة: 24].
3- تلقي العلم عن العلماء الربانيين، وإرجاع المسائل المشكلة إليهم ليحلوها ويوضحوا ما أبهم على صاحبها، فلا يستعجل في قبول فكرةٍ أطلقها من لا يؤمن فكره، ولا يبقي تلك الشبهة في صدره حتى تعظم، بل ينبغي عليه أن يضبط نفسه بالرجوع للراسخين من أهل العلم؛ فإن الله تعالى يقول: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]، وذلك لأنَّ هذا العلم دين يدين به العبد لربه ويلقاه به إذا مات عليه، ولهذا قال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين؛ فانظروا عمن تأخذون دينكم (16).
4- البناء الذاتي بمعرفة مصادر التَّلقي، ومناهج الاستدلال الصحيحة، وملء القلب بنور الوحي من الكتاب والسنة، مع ملازمة إجماع أهل السنة والجماعة، فإن هذه المصادر عاصمة من قاصمة الوقوع في الخطأ والانحراف والزلل، وسبب أكيد لسد باب الشبهات المظلمات، وذلك بعونه تعالى مساعد لحماية العقل المسلم من مضلات الفتن.
قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولًا وفعلًا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولًا وفعلًا نطق بالبدعة لأن الله تعالى يقول: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا} [النور: 54] (17).
ومن ذلك إرجاع المجمل إلى المبيَّن، والمطلق إلى المقيَّد، والمؤوَّل إلى الظاهر، والجمع بين الأدلَّة التي ظاهرها التعارض، بالرجوع لكتب أهل العلم، واستقاء معاني الألفاظ من العلماء الربَّانيين، وكذا برد المتشابه إلى المحكم، وقد روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} [آل عمران: 7]، ثم قال صلى الله عليه وسلم: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه ، فأولئك الذين سمَّى الله؛ فاحذروهم» (18).
5- التعلُّق بكتاب الله قراءة وفقهًا وتدبُّرًا وعملًا، ولو أقبل الخلق على كتاب الله والانتهاج بنهجه، لأجارهم سبحانه من الفتن، فالقرآن شفاء لما في الصدور، ومن يعرض عنه فسيصيبه من العذاب بقدر ابتعاده عنه {وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا (16) لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا (17)} [الجن: 16 - 18]، ورضي الله عن ابن عبَّاس إذ قال: من قرأ القرآن فاتَّبع ما فيه هداه الله من الضَّلالة في الدنيا، ووقاه يوم القيامة الحساب (19).
وصدق الله: {فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا} [طه: 123- 124]، ويكفي أنَّ آثارًا كثيرة وردت عن السلف بأنَّه من ابتغى الهدى من غير كتاب الله، فإنَّ الله سيضلُّه.
6- إصلاح القلب ومجاهدته، ومن حاول ذلك وجد واجتهد في تحصيله، فليبشر بالهداية واليقين، فاللَّه تعالى يقول: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} [العنكبوت: 69].
7- معرفة مقاصد الشريعة، ومرامي الدين الإسلامي؛ لأنها تمنح المسلم قوة منهجية كبيرة، ولقاحًا ضد الانحرافات.
8- تكثيف البرامج التوجيهية، وأخص بالذكر وسائل الإعلام بشتى أصنافها، ومحاولة زرع الثقة في قلوب المسلمين بالاعتزاز بدينهم وعقيدتهم، وتمكين قواعد الإسلام في قلوبهم، والرد على ما يضادها، وحتمًا سيولد ذلك قناعة بأولوية الأصول الإسلامية في قلوب المسلمين، وبناء الرسوخ العقدي في قلوبهم، وذاك التحصين الذي نريد.
9- رصد الانحرافات الفكرية، والتعقيب عليها بتفنيد الشبه، والجواب عن الشكوك والشبهات التي يثيرها بعض المارقين من قيم الإسلام ومبادئه، والجهاد الفكري ضدها، من منطلق قوله تعالى: {وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا} [الفرقان: 52]، وتفعيل هذه المراكز بقوة البحوث، وضخ المال الداعم لها، وتوظيف الباحثين المتمكنين فيها، وإعطاءها قدرًا من الشهرة والانفتاح على الوسائل الإعلامية.
10- التربية للنشء بما يرضي الله، والتحاور معه بتبيين فساد شبهات أهل الزيغ والهوى، مع قوَّة الإقناع، وأدب الحوار، فالتنشئة الصحيحة على التحصين العقدي هي أول عمليَّة في التربية؛ بتربيتهم على العقيدة الصحيحة، وحماية ذواتهم من العبث الفكري، وبناء الشخصية الإسلامية التي لا تؤثر فيها تيارات التشكيك، وإرسالهم إلى المربين الثقات لتربيتهم على أصول ديننا، وقد قال أيوب السختياني: إن من سعادة الحدث والأعجمي، أن يوفِّقهما الله لعالم من أهل السنة (20)، ليكون أهل التربية معينين لهم على تقوية عقيدتهم، ودرء عبث غزاة الأفكار والعقول عنها، مع التحذير الملازم لهم بخطر الأخذ عن غير أهل السنة، وإن استطعنا منعهم من ذلك فهو الأحسن، إلا أن المنع لا بد أن يكون بإقناع لهم، وقد يكون منعهم متعذراً في هذا الزَّمن؛ لأنَّهم قد يمنعوا فتأتيهم ردة فعل تجعلهم يصرون على ما سيطالعونه أو يسمعونه، ولكن الأسلوب التربوي يرجح أن يناقش الأب أو المربي ذلك الشاب ويبين له أوجه الخطأ التي وقع بها أهل الضلال، فلا منع مطلق، ولا إباحة مطلقة، بل إباحة وفق ضوابط وتحذير ودعم تربوي (21).
ومن جميل الكلام حول طريقة ترسيخ الوجود العقدي في النشء؛ ما قاله الإمام الغزالي: وليس الطريق في تقويته وإثباته أن يعلم صنعة الجدل والكلام، بل يشتغل بتلاوة القرآن وتفسيره، وقراءة الحديث ومعانيه، ويشتغل بوظائف العبادات، فلا يزال اعتقاده يزداد رسوخًا بما يقرع سمعه من أدلَّة القرآن وحججه، وبما يَرِدُ عليه من شواهد الأحاديث وفوائدها، وبما يسطع عليه من أنوار العبادات ووظائفها (22).
وختامًا: مما يحسن التنبيه إليه: أن المستمسك بهذا المنهج يجب أن يكون قويًا في طرحه لدى الناس بتعامل لطيف، مبينًا له بلا عنف، عارفًا للحق، راحمًا للخلق، يريد لهم الهداية، بلا جباية أو وصاية، فالحق أبلج، والباطل لجج، وماذا بعد الحق إلا الضلال (23).
***
----------------
(1) تفسير ابن كثير (8/ 437).
(2) في ظلال القرآن (5/ 3042).
(3) الآداب الشرعية والمنح المرعية (2/ 148).
(4) المصدر السابق (2/ 147).
(5) إحياء علوم الدين (1/ 15).
(6) الإبانة في أصول الديانة (1/ 390).
(7) السير للذهبي (7/ 261).
(8) أخرجه أبو داود (4607).
(9) شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد (ص: 98).
(10) أخرجه الآجري في الشريعة (ص: 48).
(11) الإبانة الكبرى لابن بطة (2/ 456).
(12) سير أعلام النبلاء (8/ 99- 106).
(13) الشريعة للآجري (ص: 66).
(14) درء تعارض العقل والنقل (7/ 173).
(15) مجموع الفتاوى (35/ 190).
(16) أخرجه مسلم في مقدِّمة صحيحه (1/14).
(17) مجموع الفتاوى (14/241).
(18) أخرجه البخاري (7454).
(19) أخرجه عبد الرزاق (6033).
(20) شرح أصول اعتقاد أهل السنَّة والجماعة للالكائي (1/60).
(21) حلول وأصول في حماية العقل المسلم/ صيد الفوائد.
(22) إحياء علوم الدين (1/ 94- 95).
(23) الحصانة الشرعية ودورها في تشكيل الشخصية الإسلامية، طريق الإسلام.
